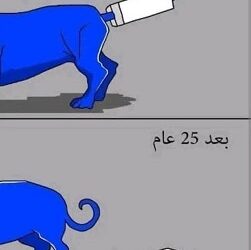لا تُقاس الزيارات البابوية إلى الشعوب المنهكة بعدد الكلمات التي تُلقى في الساحات، ولا بعدد الصُور الموزّعة في الإعلام، بل بمدى قدرتها على ملامسة جراح الناس الحقيقية، ووضع الإصبع على مكامن الألم، وإعطاء صوت لمن صمتوا تحت وطأة القهر. من هذه الزاوية تحديدًا نظر الشعب اللبناني إلى زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر، آملًا أن تكون زيارة راعٍ للمتعبين، لا زيارة ضيفٍ محاطٍ بأصحاب النفوذ وكهنة السلطة. اللبناني الذي حمل على ظهره عقودًا من المهانة والسرقة والنهب المنظّم، كان ينتظر من الحبر الأعظم أن يأتي إليه كمن يأتي إلى “جميع المتعبين والثقيلي الأحمال”، لا كمن يأتي إلى بلاطٍ مُهيّأ لاستقباله بخيوط من ذهبٍ مسروق من أفواه الفقراء.
لقد دخل قداسة البابا لبنان على وقع ترحيبٍ ضخم، وخرج على وقع صدمةٍ كبرى: صدمة شعبٍ رأى معظم من نهبوه وسرقوا خبز اليتامى وأموال الأرامل وعرق العمال جالسين في الصفوف الأولى. لم يُخفِ اللبنانيون ألمهم حين شاهدوا الطرقات تُزفت فجأة، والكهرباء تعود فجأة، والخدمات تُفتح فجأة، فقط لأن الزعماء الفاسدين أرادوا أن يُظهروا للبابا وجهًا كاذبًا لوطنٍ جائعٍ مقهورٍ مسحوقٍ تحت إدارة شذاذ آفاق. مشهدٌ مؤلم جعل الناس تتساءل: كيف يُمكن لقداسةٍ تأتي من مدرسة المسيح، المسيح الذي قلب موائد الصيارفة، أن تجالس صيارفة العصر وربوبيّي المصارف الذين نهبوا أموال الشعب ثم خرجوا باسمه يتباهون باستضافة الحبر الأعظم؟
لم يكن الألم في أن قداسة البابا جاء، بل في من جلسوا حوله؛ لم يكن في كلماته، بل في بعض الأصوات التي صفّقت له وهي تمضغ بين أسنانها دماء الناس وتخبّئ في جيوبها الدولارات التي سُلبت من المودعين. شعبٌ منكوبٌ رأى في زيارة قداسة البابا فرصة أخيرة ليُسمِع العالم صراخه، فإذا بالصوت يُخنق داخل جدران الاحتفالات التي صنعها حكّام الطوائف وأمراء المليشيات وشركاء المصارف ومهندسو الإذلال الاقتصادي.
من هنا، يأتي هذا المقال ليقرأ الزيارة لا كحدث بروتوكولي، بل كمرآة عاكسة لوجع الشعب، وليطرح سؤالًا كبيرًا: ماذا يعني أن يأتي قداسة البابا شاهداً على الآلام ثم يجالس مسبّبيها؟ وكيف يمكن للّبناني البائس، الذي لا يزال يحبّ المسيح ويكره الظلم، أن يفهم زيارة روحية تحوّلت إلى عرضٍ مسرحي موّلت خزائنه من الجيوب الفارغة للشعب؟ في هذه الأرض التي تُشبه صليبًا معلّقًا بين سماء الرجاء وجحيم الواقع، يبقى السؤال الأعمق: هل كان يمكن للزيارة أن تكون حدثًا شافيًا لو اختار قداسة البابا أن يمشي مع الفقراء بدلًا من أن يبتسم مع شذاذ الآفاق؟
هذه المقدّمة ليست سوى عتبة لبحثٍ يتوغّل أكثر في المفارقة المؤلمة بين رسالة المسيح ورمزية الحبر الأعظم من جهة، وبين واقع دويلات علي بابا والأربعين أو الأربعة آلاف “آدامي” من جهة أخرى؛ واقع يستغيث بالسماء بعدما خذله أهل الأرض.

1. قداسة البابا بين رمزية الحبر الأعظم وواقع دولة اللادولة في لبنان
في اللحظة التي وطئت فيها قدما الحبر الأعظم أرض لبنان، بدا وكأن الأمل انتفض من بين أنقاض هذا البلد الجريح، لكن سرعان ما ظهر التناقض الحاد بين رسالة الكنيسة وبين المشهد السياسي–الاجتماعي الذي أحاط بالزيارة. فلبنان ليس بلدًا عاديًا يستقبل قائدًا روحيًا، بل وطن يعيش منذ عقود تحت قبضة طبقة حاكمة يتقاسمها الفساد والطائفية والربا والهيمنة الميليشياوية. لذلك كانت الزيارة محمّلة بانتظارات أكبر بكثير من الحضور البروتوكولي. كان الشعب يتطلع إلى راعٍ يزور المرضى والأيتام والمساكين، يقترب من جراح الفقراء، ويجلس عند أقدام المُتعبين كما فعل المسيح، لا أن يجد نفسه – شاء أم أبى – في قلب منصات السلطة التي سامت الناس إذلالًا ونهبًا وفواجع. هنا، بدأ الشرخ بين الرسالة والواقع: بين قداسة البابا، كرمز عالمي للسلام والعدالة والرحمة، وبين النظام اللبناني الذي يستثمر كل ضيف، وكل حدث، وكل مأساة، وكل زيارة، لأجل تعزيز سلطته المترنّحة.
لقد شعر الشعب، في عمقه اللاواعي، أنّ هؤلاء الذين اصطفّوا في الصفوف الأولى ليسوا ممثلين له ولا لصوته ولا لجراحه. كانوا هم أنفسهم الذين صنعوا منظومة القهر التي دفعت اللبنانيين إلى الانتحار، والهجرة، والذل في المصارف، وإلى الوقوف ساعات أمام أبواب المستشفيات، وإلى انتظار 400 أو أكثر دولار تُفرج عنها البنوك كمنّة من جلاد على ضحيته. هؤلاء هم الذين زُفِّت لهم الطرقات في ليلة واحدة لاستقبال قداسة البابا، بينما عاش الشعب سنوات بلا كهرباء، بلا ماء، بلا دواء، بلا عدالة. فمن الطبيعي، بل من البديهي، أن يسأل الناس: كيف يجتمع الراعي مع الذئاب؟ كيف يواسي النعاج وهو يجالس الجزارين؟ كيف تلتقي المسيحية المتجسدة بالمتسلطين الذين لا يعرفون معنى التوبة ولا معنى الرحمة؟
لم يكن الإشكال في الزيارة بحد ذاتها، ولا في قيمتها الروحية، ولا في القصد الأصلي للحبر الأعظم، فقداسة البابا ليس سياسيًا، ولا يمكن أن يُحمّل أوزار بلد بأكمله. بل كان الإشكال في المسرح الذي بُني له. مسرح صنعه الإعلام الخاضع للسلطات، والإدارات التي لم تجد يومًا كهرباء لتشغيل مدارس الفقراء لكنها وجدت ما يكفي لإضاءة الاستقبال. مسرح ملؤه الوجوه التي خبرها الشعب وخبر حيلها، وجوه تعرف كيف تبتسم على المنصات وكيف تقبّح حياة الناس خارجها. هؤلاء الذين يذرفون دموع التماسيح في حضور قداسة البابا، ثم يعودون إلى مكاتبهم ليوقعوا قرارًا يقطع عن الناس دواءً أو معاشًا أو حقًا من حقوقهم الأساسية.
كان الشعب ينتظر كلمة حاسمة، ليست سياسية بالمعنى الحزبي، ولكن أخلاقية بالمعنى المسيحي العميق: كلمة تقول إن من يَسخَر من شعبه، ويسرق جنى عمره، ويحتقر كرامته، لا يمكن أن يكون ممثلًا له في حضرة راعٍ أعظم. لكنّ البروتوكول السياسي – كما دائمًا في لبنان – ابتلع الرسالة الروحية، واحتجز البُعد الإنجيلي، وفرض منطقه القائم على الوجاهة والوجوه والتراتبية. وهكذا صارت الزيارة فرصة جديدة للنظام لكي يلمّع نفسه، ويُظهر للعالم أنه يحافظ على “وحدة وطنية” زائفة، وأنه قادر على تنظيم احتفال ضخم طالما عجز عن تنظيم دولة.
وليس غريبًا أن يشعر الناس بأن القداسة لم تتمكّن من اختراق جدار الفساد، وأنّ الأنوار التي غمرت شوارع الاستقبال لم تضيء عتمة القلوب المتحجرة في السلطة. بل إن كثيرين شعروا بأن الزيارة، رغم جمالها الروحي، خُطفت مثلما خُطف البلد كله، وصارت حدثًا يضاف إلى سجلّ المظاهر التي لا تغيّر شيئًا في العمق. لذلك، ارتفعت الأسئلة: هل وصلت إلى قداسة البابا حقيقةُ لبنان؟ هل علم أن الإعلام الذي مدحه يخنق أصوات الفقراء؟ هل عرف أنّ الابتسامات التي رافقت جولاته هي ابتسامات من سرقوا ودائع الناس وضحكوا على دماء الشهداء ونفَس المظلومين؟ هل علم أنّ “الاستقبال الرسمي” هو في جوهره استقبال عصابات سياسية تتقاسم دولة وتتحكم برقاب شعب منكوب؟
ومع ذلك، بقيت العلاقة بين الشعب وقداسة البابا مبنية على المحبة والرجاء، لا على العتب فقط. فالشعب الذي خاطب المسيح في إنجيله قائلاً: “ارحمنا”، هو نفسه الذي رأى في قداسة البابا رجلًا صالحًا، لكن محاطًا بجوقة غير صالحة. رأى فيه ضيفًا كريمًا، لكن مستضافًا من قبل غير كرام. لذلك قال اللبنانيون: نحن متعبون يا قداسة البابا، نحن المثقلون بالأحمال، نحن الذين وعدنا المسيح بأن يحمل عنا أثقالنا. لكنك، من حيث لا تدري، جلست مع الذين يضعون تلك الأحمال على أكتافنا. ومع ذلك، نحبك، وندعو لك، ونرجو لك نورًا يبدّد ما حجبه الإعلام الفاسد عنك، وما أخفاه عنك أصحاب الكراسي، وما لم يتركوه لتراه في وجوه البائسين الذين لم يصل صوتهم إليك.

2. الشعب اللبناني بين الرجاء المسيحي وخيبة الزيارة في ظل المنظومة المختطفة
يعيش الشعب اللبناني منذ سنوات طويلة حالة من الاغتراب داخل وطنه. فهو شعبٌ يؤمن بالمسيح المحب والراعي الصالح، ويؤمن بأن الكنيسة هي أم الفقراء، وصوت المظلومين، وحاضنة الجياع والمستضعفين. لذلك شعر كثيرون بأن زيارة قداسة البابا يجب أن تكون لحظة تلاقٍ بين الراعي الحقيقي والقطيع المتألم. أرادوا أن يتذوّق هو أيضًا الغُصّة التي يعيشونها، لا من أجل الشفقة، بل من أجل الحقيقة: حقيقة ما فعلته الطبقة الحاكمة بهذا الشعب.
لكنّ المشهد كان مختلفًا: فالبروتوكول الرسمي حجز قداسة البابا خلف دروع من السياسيين ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ، الذين يعرف الشعب تمام المعرفة أنّهم لم يتركوا له حقًا إلا وسلبوه. الناس الذين لم يجدوا كهرباء منذ سنوات، رأوا فجأة الطرقات مُزفّتة، والإنارة لامعة، والموظفين نشيطين، والبلديات مستنفرة. بدا وكأن السلطة تقول لشعبها: نحن قادرون، لكننا لا نريد؛ نحن نعرف كيف نصلح، لكننا لا نصلح؛ نحن نستطيع أن نجعل البلد يضيء، لكننا لا نضيئه إلا عندما نريد أن نُظهر صورة جميلة أمام الغرب، أو أمام زائر كبير.
في هذه المفارقة ولد الألم. فالشعب لم يكن ينتظر من قداسة البابا معجزة كهربائية، بل معجزة أخلاقية: أن يقول للظالم إنه ظالم، وأن يرفع صوته في وجه من نهب مال الشعب، وأن يسأل بصوت عالٍ: من سرق الودائع؟ من فجّر المرفأ؟ من قتل أحلام الشباب؟ من خطف القضاء؟ من حوّل لبنان إلى “دويلات علي بابا والأربع مئة” كما سمّاها روّاد مواقع التواصل؟ من جعل كل طائفة وكأنها مزرعة، وكل زعيم وكأنه مالك عبيد؟
الشعب الذي كان يأتي إلى القداس حافيًا في بعض الأحيان، والذي يعيش في الظلام، والذي يذوق مرارة الإهانة اليومية في المصارف، كان ينتظر من يسمّي الأشياء بأسمائها. كان يريد أن يسمع صوت الكنيسة العالمي يقول للظلمة: “كفى“. أراد أن يسمع لغة الحق التي لا مجاملة فيها. فالمسيح لم يمدح الكتبة والفريسيين، بل قلب موائد الصيارفة وطرد باعة الهيكل. والمسيح لم يجالس الجبابرة على حساب المستضعفين، بل وقف إلى جانب الفقراء ووبّخ الطغاة. لذلك تساءل كثيرون: كيف يجلس البابا مع الذين يسرقون خبز أولادنا؟ كيف يجالس الذين يضحكون فوق دمائنا؟ كيف يخاطب الذين لا يمثلون أحدًا إلا مصالحهم الخاصة؟
ومع ذلك، لم تتحول خيبة الناس إلى كراهية، بل بقيت مشبعة بمحبة جريحة، محبة لا تزال تبحث عن نورٍ وسط هذا البحر من الظلام. فاللبنانيون بطبعهم مسالمون، أبناء إبراهيم الذي دعا إلى الرحمة، لكنّهم يشعرون في العمق بأنهم يُعامَلون كأبناء الجارية، كما يستصغرهم بعض سياسيي الداخل والخارج. يشعرون بأنهم مختطفون من قبل طبقة سياسية فاسدة تستعبدهم باسم الطوائف، وتنهبهم باسم الديمقراطية، وتحقّرهم باسم الوطنية، وتخدعهم باسم الحوار والوحدة الوطنية. لذلك، عندما رأوا القهقهات، والقبلات، والمصافحات بين الزعماء، شعروا أن المسرحية تُعاد من جديد، وأن الزيارة – رغم جمالها – لم تلمس وجعهم.
ومع ذلك، ظلّ الشعب متمسكًا بالإيمان، لأن المسيح لم يَعِد أتباعه بأن الرعاة الأرضيين سيكونون بلا خطأ، ولا بأن السلطة ستكون عادلة، بل وعدهم بأن الله أقرب إليهم من حبل الوريد، وأن الصلاة الصادقة أقوى من كل العروش. لذلك قال اللبنانيون: نصلي لك يا قداسة البابا، لأننا نحبك، ولأنك رجل سلام، ولأنك لست مسؤولًا عما حاولت الطبقة الحاكمة أن تفرضه عليك؛ نصلي أن تُمنَح نورًا يريك لبنان الحقيقي، لبنان الفقراء، لبنان المنسيين، لبنان المصلوب منذ سنوات، لبنان الذي يبحث عن قيامة.

3. معنى القداسة في وطن فقد قداسته السياسية وبحثُ اللبنانيين عن خلاصٍ خارج سلطة الجبابرة
في بلدٍ فقدت فيه الدولة معناها، وتحولت فيه السياسة إلى شبكة عصابات، يطرح اللبنانيون سؤالًا جوهريًا: ما معنى الزيارة الروحية إذا كان النظام السياسي يختطفها؟ كيف يمكن للقداسة أن تعمل في فضاء ملوث بالمال الفاسد، والربا، والمحاصصة، والإذلال اليومي؟ كيف يمكن لرسالة المسيح أن تتجلى عندما تُستخدم الرموز الدينية لتلميع صورة منظومة غارقة في الدماء والسرقات؟
اللبناني، في جوهره، كائن روحي. يعيش بين صليب وألم، بين كنيسة ودولة، بين إيمان وانكسار. لذلك كانت هذه الزيارة بالنسبة له فرصةً لكي ينهض من الركام، ليقول إنّ لبنان لا يزال أرضًا للقداسة على الرغم من قساوة الزمن. لكنّ السلطة أرادت أن تحصر المشهد داخل إطارها، داخل مقاعدها الأمامية، داخل ابتساماتها المصطنعة. وهكذا، تحولت القداسة إلى ديكور، بدل أن تكون صرخة حق. وهذا ما أشعل في قلوب اللبنانيين شعورًا بأن زيارة قداسة البابا مرّت فوق السطح، ولم تنزل إلى الجذور حيث يقيم الألم الحقيقي.
لكنّ الحقيقة اللاهوتية العميقة تقول إنّ المسيح لا يُقاس باللقاءات الرسمية، ولا بالبروتوكولات، ولا بالمنصات. المسيح وُلد في حظيرة لا في قصر. سار بين الفقراء لا بين أصحاب النفوذ. دعا المتعبين لا المترفين. لذلك، فإن اللبنانيين الذين شعروا بخيبة، لم يكن غضبهم موجّهًا للبابا كشخص أو كقائد روحي، بل موجّهًا إلى أولئك الذين فرضوا عليه أن يرى لبنان من شرفة الطبقة الحاكمة، لا من قلب المأساة. ولو أن قداسة البابا عرف، كما يعرف الناس، حقيقة الجوع، وحقيقة الذل، وحقيقة الودائع المحتجزة، وحقيقة الأوجاع التي تقطر بين أسنان السلطة، لحمل صليبه ونزل إلى الأزقة التي ينتظر فيها المسيح الحقيقي: المسيح المتجسد في وجوه الفقراء.
ومع ذلك، تُشرق عبارة واحدة فوق كل هذا الألم: “طوبى لمن جعل الله في عينيه نورًا“. النور الإلهي لا يحتاج إلى بروتوكولات، ولا يحتاج إلى واسطة رجل دين، ولا إلى منصات سياسية. الله أقرب إلى الإنسان من كل الهياكل. هذا ما يعزي اللبنانيين اليوم: أن خلاصهم لا يأتي عبر الزعماء، ولا عبر المصارف، ولا عبر الحكومات، بل يأتي من النور الداخلي الذي يمنحهم قوة البقاء. لذلك فإن الشعب الذي استقبل قداسة البابا بمحبة، وودّعه بحرقة، لا يزال يحمل رجاءً بأن الكنيسة العالمية ستسمع صوته يومًا، وستكشف للعالم حقيقة ما يجري في هذا الوطن المختطف.
في النهاية، يبقى أن اللبنانيين، رغم الألم، ورغم الاختطاف، ورغم القهر، صلّوا للبابا. قالوا: “نحن نحبك، ونريد لك الخير، ونؤمن برسالتك، لكننا أردناك أن ترى الحقيقة كاملة“. لقد زار لبنان ورحل… لكنّ اللبنانيين بقوا وحدهم في مواجهة جلاديهم. ومع ذلك، فإن محبتهم للبابا لم تتزحزح، لأنهم يميزون بين القداسة وبين السياسة، بين الراعي الصالح وبين الذئاب، بين نور الإنجيل وبين عتمة السلطة. هكذا، يعود قداسة البابا إلى روما، ويعود لبنان إلى بؤسه، لكن اللبنانيين يبقون شعبًا يعرف كيف يحب، وكيف يصلي، وكيف ينهض من بين القبور مهما طال الليل.

4. الخاتمة
كأن زيارة قداسة البابا كانت فصلًا إضافيًا من فصول الحكاية اللبنانية: قصّة شعبٍ يحبّ، وقياداتٍ تكره؛ شعبٍ يصفّق للخير رغم الجراح، وطبقةٍ سياسية تتفنّن في تحويل كل حدث إلى مناسبة لستر عوراتها. رحل قداسة البابا وبقي لبنان، رحلت الكلمات وبقي الألم، رحلت الصلوات وبقيت العصابات التي تدير البلاد كأملاك شخصية. ومع ذلك، لم يخرج الشعب اللبناني من الزيارة ساخطًا على قداسة البابا بقدر ما خرج ساخطًا على من التفّوا حوله، وأرادوها مناسبة ليبيّضوا وجههم بالسخاء المصطنع، والمشاهد المدروسة، والضحكات التي كانت أشبه بصدى قهقهات الجلاد على مسرح الضحية.
اللبناني الذي رأى قداسة البابا يجالس “الجزارين” لم يفقد إيمانه بالمسيح، ولم يفقد احترامه للبابا، لكنه شعر بأن صوت الفقراء اختفى خلف هدير المواكب والموائد. هذا الشعب الذي فقد أمواله وحقوقه وكرامته، والذي يعيش اليوم على فتات التعويضات من المصارف التي نهبته، كان يأمل أن يسمع من الحبر الأعظم كلمة واحدة تُسمي الأشياء بأسمائها، تفضح الظلم، تُدين السرقة، تُدافع عن المظلومين. لكنه رأى، بدل ذلك، ابتساماتٍ ودّية مع رموز المنظومة التي تخنق لبنان منذ عقود.
ومع ذلك، وبرغم الخذلان، لا يزال هذا الشعب يملك قدرة عجيبة على الصفح والمحبة، كما لقّنه السيّد المسيح الذي دعا المتعبين إلى الراحة عنده. اللبناني – حتى وهو مفجوع – لا يزال يدعو للبابا، ولا يزال يحفظ في قلبه احترامًا للكرسي الرسولي، ولا يزال يفرّق بوضوح بين قداسة الرسالة وبين خطايا السياسة. إنه شعب يعرف أن الله أقرب إليه من حبل الوريد، وأن نور الله لا يحتاج إلى وسيط، ولا إلى توقيع سياسي، ولا إلى بروتوكول، بل إلى قلبٍ متواضعٍ صادقٍ يعرف أن يسجد دون أن ينحني للفساد.
هذه الخاتمة تعيد التأكيد أن زيارة قداسة البابا، مهما حملت من تناقضات، كانت فرصة ليفكّر اللبناني مجددًا في معنى الإيمان الحقيقي، وفي قيم المسيح التي تُعلّم أن المحبة لا تجلس مع الظلم، وأن السلام لا يُصنع في حضن الجزار، وأن التعزية لا تُعطى للنعجة بينما يُصافَح من قطع صوفها وسرق لبنها. لقد جاءت الزيارة ومضت، وبقيت الأسئلة مفتوحة، وبقي لبنان ينتظر من يضع يده فعليًا على جراحه، لا على أيدي من جرّوه إلى هذه الجراح.
وهكذا، يُختتم المقال بما بدأ به: دعاءٌ إلى الله وإلى الضمير الإنساني، أن يُعيد السلام إلى بلدٍ مخطوف، وأن يُعيد الصوت إلى شعبٍ أنهكه صراخ القهر، وأن يُعيد الكرامة إلى وطنٍ لم يقدّم للعالم إلا قديسين وتضحيات. وما بين الرحيل والرجاء، يبقى اللبنانيون يصلّون، لا ليعود قداسة البابا، بل ليعود العدل إلى وطنٍ طال انتظاره للخلاص.