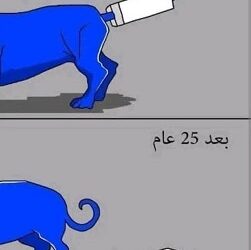المسيح هو ابن الله المتجسّد والمخلّص، أمّا عيسى فهو نبيّ كريم.
د. الياس ميشال الشويري
ليس الخلاف بين يسوع المسيح والنبي عيسى خلافًا لفظيًا أو ناتجًا عن اختلاف لغوي أو ثقافي بسيط، بل هو اختلاف جذري في الرؤية إلى الله، والإنسان، والتاريخ، ومعنى الخلاص نفسه. إن محاولة اختزال هذا الخلاف تحت شعارات التقريب أو “وحدة الأديان” غالبًا ما تؤدي إلى تشويه العقيدَتين معًا، لأنها تتجاهل أن كل ديانة قامت على أساس لاهوتي مختلف تمامًا، لا يمكن تجاوزه أو تذويبه دون فقدان المعنى.
في المسيحية، لا يمكن فهم يسوع المسيح خارج إطار التجسّد، الصليب، والقيامة. فهذه ليست أحداثًا مضافة إلى شخصه، بل هي جوهر هويته. يسوع ليس مبلّغ رسالة، بل هو الرسالة نفسها، وليس طريقًا إلى الله، بل هو – بحسب الإيمان المسيحي – الله الذي اختار أن يلتقي الإنسان في ضعفه وتاريخه وجسده. ومن هنا، فإن المسيحية ليست ديانة تعاليم بقدر ما هي ديانة حدث غيّر مسار الوجود الإنساني.
في المقابل، يقوم التصوّر الإسلامي على تنزيه مطلق لله، يرفض أي اتحاد بين الخالق والمخلوق، ويضع النبوة في إطارها الوظيفي: الهداية، التبشير، والإنذار. عيسى في الإسلام نبي كريم، ذو مكانة رفيعة، لكن قيمته نابعة من عبوديته لله لا من أي طبيعة إلهية. وهو حلقة في سلسلة، لا مركزها، ورسول جاء ليصحح مسار الإيمان لا ليعيد تعريف الله أو الإنسان.
أهمية هذا المقال لا تكمن في المفاضلة أو الإدانة، بل في التفريق الواضح والدقيق. فالفهم الحقيقي لا يولد من التمويه، بل من الوضوح. وفي مجتمعات تعددية مثل لبنان، حيث يتجاور الإيمانان في الحياة اليومية، يصبح هذا الوضوح شرطًا للحوار الصادق، لا تهديدًا له. فالحوار الذي يقوم على إنكار الاختلاف ليس حوارًا، بل مجاملة ثقافية فارغة، سرعان ما تنهار عند أول أزمة.
من هنا، يسعى هذا المقال إلى تفكيك الاختلاف بين يسوع المسيح والنبي عيسى تفكيكًا منهجيًا، لا انفعاليًا، من خلال ثلاثة محاور: الطبيعة والهوية، الحدث المؤسّس، والأثر الحضاري والإنساني، وصولًا إلى خلاصة تؤكد أن احترام الآخر يبدأ بعدم تحويله إلى نسخة مشوّهة من الذات.

1. الاختلاف الجوهري في الطبيعة والهوية والرسالة
يشكّل يسوع المسيح في الإيمان المسيحي قلب العقيدة وجوهرها المطلق، وليس مجرّد شخصية تاريخية أو نبي مرسل ضمن سلسلة أنبياء. فالمسيحية لا تبدأ بيسوع كنبي، بل تبدأ به ككلمة الله المتجسّد، أي أن الله، بحسب الإيمان المسيحي، لم يكتفِ بإرسال وحي أو شريعة، بل دخل التاريخ والجسد والزمن في شخص يسوع.
هذا المفهوم، المعروف بـ”التجسّد“، لا يعني حلول الله في إنسان فحسب، بل يعني اتحاد الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية اتحادًا كاملًا من دون اختلاط أو انفصال. يسوع ليس إنسانًا اصطفاه الله، بل هو الله الذي صار إنسانًا، وهذه النقطة وحدها تُحدث قطيعة جذرية مع أي تصور نبوي تقليدي.
المسيح، وفق هذا الفهم، لا يتلقّى الوحي من الخارج، بل هو الوحي نفسه. لا ينقل كلمة الله، بل هو الكلمة. لا يعرّف بالله فقط، بل يكشف طبيعته كأب محبّ، لا كسيّد متعالٍ فحسب. ومن هنا، فإن رسالته لا تقتصر على تعليم أخلاقي أو إصلاح سلوكي، بل على إعادة تعريف العلاقة بين الله والإنسان.
في هذا السياق، يصبح يسوع محور التاريخ لا أحد فصوله، ويصبح وجوده حدثًا كونيًا يتجاوز الزمان والمكان، ما يفسر لماذا تُقاس الأزمنة في الحضارة المسيحية بما قبل الميلاد وما بعده، ولماذا ارتبطت الفلسفة والفن والأخلاق الغربية بشخصه لا بتعاليمه فقط.
على النقيض الجذري، يأتي النبي عيسى في الإسلام ضمن بنية لاهوتية صارمة تقوم على التوحيد المطلق والتنزيه التام. فالله في الإسلام لا يتجسد، ولا يدخل التاريخ بجسد، ولا يتحد بالطبيعة البشرية، لأن ذلك يُعد مساسًا بجوهر الألوهية المطلقة.
عيسى، في هذا الإطار، هو عبدٌ اصطفاه الله، وأي محاولة لإضفاء صفة إلهية عليه تُعدّ خروجًا عن التوحيد. القرآن يحرص بشكل واضح على نزع أي لبس قد يؤدي إلى تأليهه، فيؤكد بشريته، وحاجته للطعام، وعبوديته لله، وينفي عنه صفة الابن أو الشريك.
وظيفة عيسى في الإسلام ليست الخلاص الكوني، بل إعادة الناس إلى شريعة الله، وتصحيح الانحرافات العقائدية والأخلاقية التي أصابت بني إسرائيل. وهو، كغيره من الأنبياء، حلقة في سلسلة، لا مركز الدائرة. حتى المعجزات التي أُعطيت له – كإحياء الموتى أو شفاء الأكمه – لا تُنسب إلى طبيعته، بل إلى إذن الله، ما يعزز فكرة أنه أداة تنفيذ لا مصدر قدرة.
وبهذا، فإن عيسى في الإسلام لا يغيّر بنية العلاقة بين الله والإنسان، بل يعيد تثبيتها: الله في العلو المطلق، والإنسان في موقع العبودية والطاعة، والنجاة مرهونة بالإيمان والعمل الصالح، لا بالفداء أو النعمة المتجسدة.
هنا يبلغ الاختلاف ذروته: يسوع المسيح في المسيحية جاء ليُخلّص الإنسان من حالته الوجودية الساقطة، لا ليعلّمه فقط كيف يعيش، بل ليغيّر ما هو عليه. الخطيئة، في المفهوم المسيحي، ليست مجرد فعل خاطئ، بل حالة وجودية لا يستطيع الإنسان الخروج منها بقواه الذاتية.
لذلك، يصبح الصليب ضرورة لاهوتية، لا حادثة تاريخية عابرة، وتصبح القيامة إعلانًا لانتصار الحياة على الموت، لا مجرّد معجزة. الخلاص يتم من خارج الإنسان، لكنه يُمنح له بدافع المحبة، لا الاستحقاق.
أما في الإسلام، فمفهوم الخلاص مختلف جذريًا. لا وجود لخطيئة أصلية تورَّث، ولا حاجة لفداء دموي، بل الإنسان يولد على الفطرة، وينحرف بإرادته، ويعود بإرادته. دور النبي عيسى هنا هو الهداية لا التحويل الوجودي، والإرشاد لا الفداء.
هذا الاختلاف ينعكس بعمق على نظرة كل دين إلى الإنسان:
– في المسيحية، الإنسان كائن مكسور يحتاج إلى نعمة.
– في الإسلام، الإنسان كائن قادر على الطاعة إذا التزم الشريعة.
وفي لبنان، حيث تتقاطع هذه الرؤيتان داخل المجتمع الواحد، كثيرًا ما يحصل خلط سطحي بين يسوع وعيسى باسم “التقريب“، لكن هذا الخلط، بدل أن يعزّز الحوار، يُفرغه من مضمونه. فالحوار الحقيقي لا يقوم على إنكار الاختلاف، بل على الاعتراف بأننا نتحدث عن شخصيتين لاهوتيتين مختلفتين جذريًا، تحمل كل منهما تصورًا مختلفًا عن الله، والإنسان، والتاريخ، والمصير.

2. الاختلاف في الحدث المؤسِّس – الصلب والقيامة مقابل الرفع والنجاة
يشكّل الصليب في المسيحية الحدث المفصلي الذي تُبنى عليه العقيدة كلها، ولا يمكن فهم يسوع المسيح خارج هذه الواقعة. فالصليب ليس نهاية مأساوية لنبي فشل، بل ذروة التدبير الإلهي للخلاص. وفق الإيمان المسيحي، لم يُصلب يسوع رغماً عنه، بل دخل الألم بإرادته، لأن الصليب هو الوسيلة التي بها تُكسر سلطة الخطيئة والموت.
في اللاهوت المسيحي، يُفهم الصليب بوصفه تحويلاً جذريًا لمعنى الألم: فالألم لم يعد لعنة، بل صار طريقًا إلى القيامة. والموت لم يعد نهاية، بل صار عبورًا. لذلك، فإن مشهد الصلب لا يُقرأ بوصفه هزيمة، بل انتصارًا إلهيًا في منطق مقلوب عن منطق القوة البشرية.
وتكمن خطورة هذا الحدث في أنه ينقل العلاقة بين الله والإنسان من منطق الشريعة والعقاب إلى منطق المحبة المجانية. فالله، في المسيحية، لا يطالب الإنسان بثمن الخلاص، بل يدفعه هو بنفسه. وهذا ما يجعل الصليب غير قابل للفصل عن هوية يسوع نفسه: فلو لم يُصلب، لما كان فاديًا، ولو لم يكن فاديًا، لما كان المسيح بالمعنى المسيحي.
القيامة في المسيحية ليست حدثًا ثانويًا مكمّلًا للصلب، بل هي البرهان اللاهوتي على صدقية الصليب. فالصلب بلا قيامة يعني الفشل، أما القيامة فهي الإعلان بأن الموت لم ينتصر، وأن التاريخ لم يُغلق على مأساة، بل انفتح على رجاء.
في القيامة، لا يعود يسوع مجرد معلم قُتل ظلمًا، بل يصبح رب الحياة، القادر على إعادة خلق الإنسان من الداخل. القيامة هنا ليست عودة بيولوجية إلى الحياة، بل انتقال إلى حالة وجودية جديدة، تُمنح للإنسان كرجاء أخروي.
بهذا المعنى، المسيحية لا تُبنى على تعاليم أخلاقية فقط، بل على حدث تاريخي يُغيّر معنى الزمن نفسه. فالإنسان المسيحي يعيش بين قيامة تحققت وقيامة يُنتظر اكتمالها، ويُفهم التاريخ بوصفه مسار خلاص لا مجرد تتابع حوادث.
هذا الفهم ترك أثرًا عميقًا في المجتمعات المسيحية، ومنها لبنان، حيث ارتبطت القيامة بثقافة الرجاء والصمود، حتى في أحلك لحظات الحرب والانهيار، إذ يُستدعى منطق القيامة كرفضٍ لفكرة أن الموت والهزيمة هما الكلمة الأخيرة.
في المقابل، يقف الإسلام موقفًا نافيًا وحاسمًا من حادثة الصلب. فالقرآن ينص بوضوح على أن عيسى لم يُصلب ولم يُقتل، بل رُفع إلى الله. هذا النفي ليس تفصيلاً تاريخيًا، بل موقفًا لاهوتيًا عميقًا نابعًا من مفهوم التنزيه المطلق.
ففي الإسلام، لا يجوز أن يُهان نبي الله أو يُقتل بهذه الطريقة، ولا يجوز أن يُبنى الخلاص على مشهد دموي. الله لا يحتاج إلى تضحية بشرية ليغفر، ولا يتطلب العدالة الإلهية سفك دم، لأن رحمته سابقة على غضبه.
الرفع هنا يؤكد أن الله يتدخل لينقذ نبيه، لا ليتركه فريسة للظلم. وهو يعيد تثبيت العلاقة العمودية بين الله والإنسان: الله في موقع القدرة المطلقة، والنبي في موقع العبودية المحفوظة بالعناية الإلهية.
وبذلك، فإن الإسلام ينفي أساس الصليب لا لأنه يرفض يسوع، بل لأنه يرفض منطق الفداء نفسه. فلو قُبل الصلب، لانهار منطق الشريعة والمسؤولية الفردية، ولتحوّل الخلاص من عمل أخلاقي إلى حدث غيبي لا دخل للإنسان فيه.
إن الاختلاف بين الصلب والقيامة من جهة، والرفع من جهة أخرى، ليس خلافًا حول واقعة تاريخية فحسب، بل هو اختلاف حول معنى الوجود الإنساني. فالمسيحية تبني هويتها على إله يتألم مع الإنسان، ويدخل ضعفه، ويهزمه من الداخل. بينما يبني الإسلام هويته على إله منزَّه عن الألم، متعالٍ عن الجسد، يحفظ أنبياءه من الإهانة.
هذا التباين يُنتج رؤيتين مختلفتين للمعاناة:
– في المسيحية، المعاناة قد تكون طريق خلاص.
– في الإسلام، المعاناة امتحان يجب تجاوزه بالطاعة.
وفي لبنان، حيث عانى الناس من الحروب والقتل والخذلان، يظهر هذا الاختلاف جليًا في الخطاب الديني: بين من يرى في الألم معنى ورسالة، ومن يراه ظلمًا يجب رفعه. وهنا، لا يمكن الحديث عن يسوع وعيسى كأنهما وجهان لعملة واحدة، لأن الحدث المؤسس لكل منهما مختلف جذريًا، وبالتالي الدين الذي بُني عليهما مختلف في جوهره لا في تفاصيله.

3. الاختلاف في الأثر الديني والحضاري والإنساني
لم يكن يسوع المسيح في التاريخ المسيحي مجرّد مرجعية روحية، بل كان نقطة انطلاق حضارية كاملة أعادت صياغة فهم الإنسان لذاته، ولمكانه في العالم، ولعلاقته بالسلطة، والقانون، والضمير. فالإيمان بالمسيح بوصفه إلهًا متجسدًا وفاديًا جعل الإنسان في المسيحية كائنًا ذا قيمة مطلقة، لأن الله نفسه قبل أن يشاركه ضعفه وألمه.
هذا الفهم أنتج ثورة هادئة في الوعي الإنساني: فالإنسان لم يعد مجرد تابع للشريعة أو أداة في يد السلطة، بل شخصًا له كرامة ذاتية نابعة من كونه محبوبًا ومفديًا. من هنا، تشكّلت مفاهيم مثل الضمير الفردي، حرية الاختيار، وقدسية الشخص، والتي ستصبح لاحقًا الأساس الفلسفي لحقوق الإنسان في الغرب.
كما أن التركيز على الخلاص بالنعمة لا بالاستحقاق الصارم، فتح المجال أمام فكرة الغفران، وإمكانية التوبة الدائمة، وعدم اختزال الإنسان في خطيئته. وهذا ما انعكس في الأدب، والفن، والموسيقى، حيث صُوِّر الألم لا كعار، بل كمسار نحو المعنى.
وفي لبنان، يظهر هذا الأثر بوضوح في التراث المسيحي المشرقي، حيث ارتبط الإيمان بالمسيح بثقافة الشهادة، والصمود، والرجاء، لا بثقافة الغلبة والقهر، ما جعل الوجود المسيحي فيه وجودًا ثقافيًا ورساليًا أكثر منه سلطويًا.
في المقابل، يتموضع النبي عيسى في الحضارة الإسلامية بوصفه نموذجًا أخلاقيًا رفيعًا داخل منظومة نبوية متكاملة، لا بوصفه مركزها. فالإسلام، باعتباره دين شريعة ونظام حياة، لم يبنِ حضارته على حدث فداء، بل على تنظيم العلاقة بين الإنسان والله والمجتمع من خلال التشريع.
عيسى، في هذا السياق، يمثّل قيم الزهد، الرحمة، والتواضع، ويُستحضر غالبًا كنموذج للصفاء الروحي في مواجهة الترف والانحراف. لكنه لا يشكّل مرجعية تأسيسية للسلطة أو القانون أو التاريخ، لأن هذه المرجعية تعود للقرآن وللنبي محمد.
الأثر الحضاري لعيسى في الإسلام هو أثر تعليمي وتربوي، لا بنيوي. فهو يعزز القيم، لكنه لا يعيد تشكيل مفهوم الإنسان جذريًا كما في المسيحية. الإنسان في الإسلام يبقى مكلّفًا، مسؤولًا، محاسبًا على أفعاله، والخلاص مرتبط بالطاعة والعمل الصالح، لا بعلاقة فدائية شخصية.
وهذا ما جعل الحضارة الإسلامية حضارة نظام وضبط وتشريع، أكثر منها حضارة تأمل وجودي في الألم والموت، وهو اختلاف بنيوي لا قيمي، لكنه ينعكس بوضوح على أنماط التفكير الاجتماعي والسياسي.
من أخطر نتائج الاختلاف بين يسوع وعيسى هو التباين في الموقف من السلطة والقوة. يسوع، بحسب الأناجيل، رفض السلطة السياسية، وواجهها بمنطق أخلاقي، ودفع ثمن ذلك صلبًا. هذا الموقف أسّس لفكرة الفصل بين ما لله وما لقيصر، أي بين الإيمان والدولة، ولو نظريًا.
أما في التصور الإسلامي، فالنبوة مرتبطة بإقامة العدل في المجتمع، والشريعة ليست شأنًا روحيًا فقط، بل نظامًا عامًا. وبالتالي، فإن الدين والسياسة يتداخلان بشكل أعمق، لأن الهداية تشمل الفرد والجماعة معًا.
كما يختلف الموقف من الألم:
– في المسيحية، الألم قد يكون ذا معنى خلاصي، ويُقرأ في ضوء الصليب.
– في الإسلام، الألم ابتلاء يجب رفعه أو الصبر عليه، لكنه لا يحمل قيمة فدائية بحد ذاته.
وفي لبنان، حيث السلطة كثيرًا ما تلبّست بالدين، وحيث الألم طال أمده، يظهر هذا الاختلاف في الخطاب العام: بين خطاب يضفي على المعاناة بعدًا وجوديًا، وخطاب يراها ظلمًا سببه فساد البشر. وكلاهما نابع من خلفية لاهوتية مختلفة.
إن الخلط بين يسوع المسيح والنبي عيسى تحت شعار “التقريب” غالبًا ما يكون خلطًا سطحيًا مضرًا، لأنه يتجاهل أن كل شخصية أنتجت رؤية مختلفة للإنسان، والتاريخ، والمعنى. التقارب الحقيقي لا يتحقق بطمس الاختلاف، بل بالاعتراف به بوضوح واحترام.
في مجتمع تعددي كلبنان، يصبح هذا الوعي ضرورة ثقافية لا ترفًا فكريًا. فحين يدرك المسيحي أن إيمانه قائم على الفداء والقيامة، ويدرك المسلم أن إيمانه قائم على التوحيد والهداية، يصبح الحوار أكثر صدقًا، وأقل نفاقًا.
يسوع المسيح وعيسى ليسا نسختين لشخص واحد، بل صورتان مختلفتان جذريًا لمعنى الرسالة الإلهية. ومن هنا، فإن احترام كل منهما يبدأ بعدم اختزاله في الآخر، وعدم استخدامه كأداة سياسية أو خطابية، بل كمدخل لفهم الذات قبل فهم الآخر.
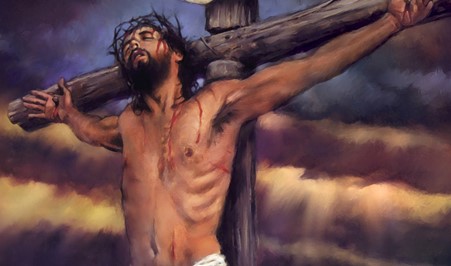
4. الخاتمة
يُظهر هذا المقال، عبر محاوره الثلاثة، أن يسوع المسيح والنبي عيسى ليسا شخصيتين متطابقتين اختلف حولهما الأتباع لاحقًا، بل هما نتاج رؤيتين لاهوتيتين مختلفتين منذ الجذور. فالاختلاف لا يبدأ من التاريخ، بل من مفهوم الله نفسه: إله يتجسّد ويفدي في المسيحية، وإله منزّه يرسل ويهدي في الإسلام. ومن هذا الاختلاف الأولي، تتفرّع كل الفوارق الأخرى: في الخلاص، في الألم، في المسؤولية، وفي معنى التاريخ.
يسوع المسيح، في الإيمان المسيحي، هو الحدث الذي أعاد تعريف الإنسان، وحرّره من منطق الاستحقاق الصارم، وربطه بعلاقة حب ونعمة مع الله. الصليب والقيامة ليسا تفصيلين إيمانيين، بل قلب الرسالة، ومن دونهما تنهار المسيحية من الداخل. أما النبي عيسى، في الإسلام، فهو شاهد على قدرة الله، وداعية إلى التوحيد، ونموذج أخلاقي رفيع، لكن من دون أي دور فدائي أو إعادة صياغة للوجود الإنساني.
إن الخلط بين الشخصيتين، مهما كانت نواياه حسنة، يؤدي إلى نتيجتين خطيرتين:
– الأولى، إفراغ المسيحية من جوهرها الفدائي وتحويلها إلى أخلاق عامة.
– والثانية، تشويه التوحيد الإسلامي عبر إدخال مفاهيم غريبة عنه.
وفي الحالتين، يكون “التقريب” قد تحوّل إلى إلغاء للهوية بدل أن يكون جسرًا للفهم.
في السياق اللبناني، حيث تتقاطع الأديان داخل المجتمع الواحد، يصبح هذا التمييز ضرورة ثقافية وأخلاقية. فلبنان لا يحتاج إلى خطاب ديني ضبابي يُرضي الجميع ظاهريًا، بل إلى وعي عميق بالاختلاف، لأن العيش المشترك الحقيقي لا يقوم على التشابه القسري، بل على الاعتراف المتبادل بالخصوصية.
إن يسوع المسيح وعيسى ليسا موضوع خلاف يجب الهروب منه، بل فرصة لفهم أعمق لمعنى الإيمان نفسه: هل هو خلاص يُمنح، أم هداية تُتّبع؟ هل الألم يحمل معنى، أم يجب فقط تجاوزه؟ هل العلاقة مع الله علاقة نعمة، أم علاقة تكليف؟ الإجابات تختلف، لكن وضوح السؤال هو بداية الاحترام.
فيما يلي جدول مقارنة تحليلي منهجي يوجز الفروق الجوهرية بين الفادي يسوع المسيح في الإيمان المسيحي والنبي عيسى في التصور الإسلامي، من حيث الهوية، الطبيعة، الدور، الحدث المؤسِّس، والمعنى العقائدي، بصيغة علمية متوازنة وواضحة:
 وبذلك، فإن هذا المقال لا يدعو إلى صدام عقائدي، ولا إلى ذوبان فكري، بل إلى صدق معرفي: صدق مع النصوص، ومع التاريخ، ومع الذات. لأن الحقيقة الدينية، أياً تكن، لا تخاف من الوضوح، بل تخاف من الخلط.
وبذلك، فإن هذا المقال لا يدعو إلى صدام عقائدي، ولا إلى ذوبان فكري، بل إلى صدق معرفي: صدق مع النصوص، ومع التاريخ، ومع الذات. لأن الحقيقة الدينية، أياً تكن، لا تخاف من الوضوح، بل تخاف من الخلط.