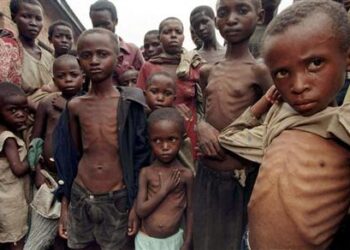شكسبير
د. الياس ميشال الشويري
تمثّل مسرحية تاجر البندقية للكاتب الإنكليزي ويليام شكسبير عملًا أدبيًا غنيًا بالدلالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي لا تزال تتردّد أصداؤها حتى اليوم. تدور المسرحية حول صراعات تتجاوز إطارها المكاني والزماني، لتصل إلى قلب المجتمعات المعاصرة بما تحمله من مواضيع تتعلّق بالدين، السلطة، القانون، المال والهوية. في هذا المقال، نحاول استنطاق هذه النصوص من خلال إسقاطها على الواقع اللبناني، وهو واقع معقّد تحكمه علاقات طائفية، أزمات اقتصادية، وتحديات عدلية. سنقوم بتحليل كل محور محوري في المسرحية، ونقارن أبعاده بما يحدث في لبنان، مستخلصين الدروس الممكنة من هذا النص العالمي.
- الاقتصاد والدين – الدين العام اللبناني وشروط شيلوك
في مسرحية شكسبير، نجد أنطونيو يُضطّر إلى قبول عقد قاسٍ من شيلوك، يقضي باقتطاع رطل من لحمه إن لم يسدّد الدين. هذا التوتّر الاقتصادي يوازي واقع لبنان، حيث ترزح الدولة تحت عبء ديون ضخمة، وُقّعت عقودها في ظروف مالية ضاغطة. المؤسسات المصرفية اللبنانية، التي لطالما تمتعت بنفوذ هائل، مارست نوعًا من الإقراض القاسي شبيهًا بأسلوب شيلوك، حيث أُغريت الدولة بفوائد مرتفعة دون تقييم فعلي لقدرة السداد، مما أدّى إلى أزمة سيولة خانقة.
يعاني المواطن اللبناني من ضغوطات اقتصادية مماثلة، إذ وقع كثير من الناس في فخ القروض الشخصية والاستهلاكية، ليكتشفوا لاحقًا أن أسعار الفوائد وآليات التسديد كانت تستهدف استغلال عجزهم المالي، لا مساعدتهم على التعافي. هذا الوضع يشبه موقف أنطونيو الذي لم يكن يملك المال لكنه اضطر للدخول في عقد قاسٍ بدافع مساعدة صديقه. وهكذا، تُسلّط المسرحية الضوء على خطورة الأنظمة الاقتصادية التي تفتقر إلى البعد الأخلاقي، تمامًا كما هي الحال في السياسات الاقتصادية اللبنانية.
كما أن شيلوك في المسرحية لا يرى في العقد سوى وسيلة للانتقام والربح، دون اعتبار لحياة أو كرامة أنطونيو، ومن هنا نجد أن كثيرًا من الدائنين والمؤسسات في لبنان تتعامل مع المقترضين كأرقام مالية، متجاهلة البعدَيْن الإنساني والاجتماعي للأزمة الاقتصادية. هذا التماثل يدفع إلى التساؤل حول ضرورة بناء نظام مالي قائم على الأخلاق، لا فقط على الربح المجرّد.

- العدالة وتسييس القضاء – من محكمة البندقية إلى المحاكم اللبنانية
في مشهد المحكمة، يُطبّق شيلوك القانون بحرفيته، لكنه يفشل في كسب التعاطف الإنساني. في المقابل، تنجح بورشيا في توظيف القانون بطريقة تخدم العدالة والرحمة معًا. في لبنان، تُثار تساؤلات مشابهة حول دور القضاء ومدى استقلاليته، إذ تعاني المؤسسات القضائية من تدخلات سياسية وطائفية تؤثّر في الأحكام، ممّا يُفقد المواطنين الثقة بقدرة القانون على تحقيق الإنصاف.
تُعدّ العدالة الانتقائية واحدة من أبرز المشكلات التي يواجهها اللبنانيون، حيث يشعر كثير من الناس أن القانون لا يُطبّق إلا على الضعفاء، فيما يفلت النافذون من العقاب. هذا الوضع يُحاكي بشدة ما جرى في مسرحية شكسبير، حيث كاد القانون أن يصبح أداة للانتقام لا للعدالة، لولا تدخل بورشيا التي أعادت التوازن. وفي لبنان، يفتقر الواقع إلى “بورشيا” مؤسساتية توقف الانحراف وتُعيد البوصلة الأخلاقية للقانون.
كما أن المسرحية تثير تساؤلًا هامًا: هل يمكن اعتبار القانون عادلًا إذا خدم الظلم؟ هذا السؤال جوهري في لبنان، حيث تكثر القوانين القديمة أو المجحفة التي لم تُحدّث لتواكب العصر. وهكذا، تقدّم تاجر البندقية درسًا للبنان: لا يكفي أن يكون القانون موجودًا، بل يجب أن يكون عادلًا، مستقلًا، ومتصلًا بالقيم الإنسانية.
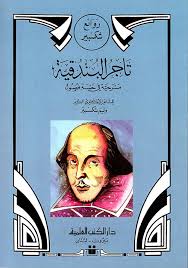
- التعايش الطائفي والديني – من شيلوك إلى واقع الطوائف اللبنانية
شيلوك ليس فقط مرابيًا يهوديًا، بل أيضًا شخصية تُعبّر عن غضب ناتج عن التهميش والتمييز الديني. في لبنان، حيث يتكوّن المجتمع من طوائف دينية متعددة، كثيرًا ما تتكرّر مشاهد الانقسام، التعصّب ورفض الآخر، ما يهدّد السلم الأهلي. تعرّض شيلوك للإهانة والاحتقار من قبل أنطونيو وأقرانه يعكس جوهر الأزمة الطائفية: صراع لا يقوم فقط على المصالح، بل على تصورات مسبقة عن الآخر المختلف دينيًا أو طائفيًا.
إن ما تعانيه بعض الفئات اللبنانية من تهميش في التمثيل أو النفوذ يتشابه مع وضع شيلوك الذي شعر بالظلم الدائم في مجتمع يرفضه رغم كفاءته. هذا التوازي يُثير النقاش حول الحاجة إلى نظام سياسي يُبنى على المواطنة لا الطائفة، وهو ما افتقرت إليه البندقية كما يفتقر إليه لبنان.
كذلك، تُظهر نهاية المسرحية تحولًا جذريًا يتمثّل في “فرض” التحوّل الديني على شيلوك، ما يعكس نوعًا من الإلغاء للهُوية. وفي لبنان، ورغم عدم وجود تحوّلات دينية قسرية، إلا أن هناك مناخًا عامًّا يجعل الفرد يشعر بأن هويته مهددة في غياب التوازن بين الطوائف. وهكذا، تدعو المسرحية إلى إعادة التفكير في معنى التعددية، لا كأداة للصراع، بل كقيمة للتكامل.
- المرأة كمحرك للتغيير – بورشيا والمرأة اللبنانية
بورشيا ليست فقط شخصية أنثوية، بل تمثل وعيًا اجتماعيًا وقانونيًا وقدرة على التأثير في مجتمع ذكوري. في لبنان، لعبت المرأة أدوارًا متقدمة في المجالات القانونية، الاجتماعية، والسياسية، خصوصًا بعد الانتفاضات الشعبية، حيث قادت الحملات، واجهت القمع، وطالبت بالحقوق. مثلما كسرت بورشيا حدودها الطبقية والجندرية، كسرت اللبنانيات صورة المرأة الهامشية.
في المسرحية، تتجاوز بورشيا دورها التقليدي لتتقمّص شخصية محامٍ، ممّا يفتح الباب أمام تساؤل كبير: ما الذي يمنع المرأة من قيادة التحولات؟ وفي لبنان، حيث ما زالت قوانين الأحوال الشخصية تمارس التمييز، تشكّل المرأة عنصرًا جوهريًا في معركة الإصلاح القانوني والاجتماعي، وتحتاج إلى مساحة تمكينية تُعادل الدور الذي لعبته بورشيا في المحكمة.
كما أن نهاية المسرحية تُظهر أن بورشيا لم تُنقذ أنطونيو فحسب، بل أنقذت صورة العدالة، وهو الدور نفسه الذي تلعبه النساء في لبنان حين يُدافعن عن القضايا الحقوقية والعدلية. من هنا، يمكن اعتبار بورشيا رمزًا لكل امرأة لبنانية تطمح إلى التغيير، لا فقط في السياسة، بل في الوعي العام.
- الصداقة والولاء – التضامن الشعبي اللبناني في ظل الأزمات
تُظهر المسرحية علاقة استثنائية بين أنطونيو وباسانيو، حيث يضحّي الأول بنفسه من أجل الثاني. في لبنان، ورغم الفقر والانقسام، غالبًا ما تظهر روح التضامن بين الأفراد، خاصة في الكوارث مثل انفجار مرفأ بيروت، أو الأزمات الاقتصادية. هذه الصداقة الإنسانية تُعتبر من روافد المقاومة المجتمعية في وجه الانهيار.
تبرز قيمة الولاء في المسرحية حين يذهب باسانيو لإنقاذ أنطونيو، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاجتماعية في وقت المحن. كذلك، في لبنان، يتكاتف الناس لدعم بعضهم البعض بوسائل غير رسمية مثل الجمعيات الأهلية، المبادرات الشبابية، أو حتى التضامن عبر وسائل التواصل، ما يُعبّر عن عمق النسيج الاجتماعي اللبناني رغم هشاشة النظام السياسي.
تُظهر المسرحية أن العلاقات البشرية تُشكّل خط الدفاع الأخير أمام أنظمة اقتصادية أو قانونية فاشلة، وهو ما ينطبق على لبنان حيث يحمي المواطن أخاه المواطن، لا الدولة، من الانهيار. وهذه العلاقة هي التي تحفظ بقاء المجتمع رغم كل ما يُهدده.
- السلطة والأخلاق – بين النص القانوني والضمير الإنساني
تُسلّط تاجر البندقية الضوء على الفجوة بين القانون والأخلاق. فالعقد الذي أبرمه شيلوك قانوني تمامًا، لكنه غير إنساني. في لبنان، تتكرّر هذه الحالة في عقود واتفاقيات وسياسات قد تكون قانونية من حيث الشكل، لكنها تُكرّس الظلم في الواقع، كالعقود مع الشركات الخاصة أو الاتفاقيات المالية التي لا تأخذ مصلحة الشعب بعين الاعتبار.
القانون، إذا لم يُربط بالقيم الإنسانية، قد يتحوّل إلى سيف يقطع العدالة من جذورها، كما كاد يحدث مع أنطونيو. في لبنان، تكثر الأمثلة على تشريعات وقرارات تفتقر إلى البعد الأخلاقي، مثل السياسات الضريبية التي تثقل كاهل الفقراء، أو قوانين تحمي المحتكرين. وهكذا، تُبرز المسرحية أهمية إدخال الأخلاق كمكوّن جوهري في صناعة القانون.
أخيرًا، تُظهر المسرحية أن الخلاص لا يأتي من نص القانون وحده، بل من شخص يمتلك الحكمة والشجاعة – في هذه الحالة، بورشيا. وفي لبنان، الحاجة ماسة إلى “بورشيا جماعية” في مؤسسات الدولة، تُعيد وصل القانون بالرحمة، والسياسة بالأخلاق، والاقتصاد بالعدالة الاجتماعية.

- التجّار السياسيون – بين شيلوك المعزول وطبقة استغلالية في السلطة اللبنانية
في تاجر البندقية، كان شيلوك يمثل تاجرًا فرديًا، معزولًا عن مراكز السلطة والنفوذ، ومع ذلك مثّل تهديدًا للمجتمع من خلال تعنّته القانوني وجشعه المالي. أما في لبنان، فإن “شيلوكات” العصر الحديث ليسوا أفرادًا معزولين، بل هم جزء من المنظومة السياسية الفاسدة نفسها، ويمثلون طبقة من السياسيين-التجار الذين يتحكمون بالسلطة والاقتصاد في آن معًا. هؤلاء لم يكتفوا بصياغة عقود مجحفة، بل أداروا البلاد بعقلية الربح الشخصي، فاستنزفوا المال العام، خصخصوا الموارد، وراكموا الثروات على حساب المواطنين.
لقد تلاعب السياسيون بمؤسسات الدولة كما يتلاعب شيلوك بشروط العقد، غير أن الفرق الجوهري أن شيلوك كان يعمل تحت رقابة القضاء، بينما استطاع السياسي اللبناني أن يحصّن نفسه بالحصانة، الطائفة، والتحالفات. تحوّلت السياسات العامة إلى مشاريع استثمارية تخدم مصالح خاصة، من ملف الكهرباء إلى الاتصالات والنفايات، حتى بدا أن كل أزمة في لبنان تُدار بعقلية تاجر لا مسؤول. هؤلاء هم النسخة الأخطر من شيلوك، لأنهم لم يستهدفوا فردًا واحدًا كما فعل شيلوك مع أنطونيو، بل استهدفوا شعبًا بأكمله.
ما يثير الدهشة هو أن هؤلاء السياسيين، الفاسدين بامتياز، لا يتعرضون للمحاسبة، بل يعاد انتخابهم مرارًا، ما يشير إلى خلل مزدوج في بنية الدولة والثقافة السياسية. على عكس شيلوك الذي خسر كل شيء في نهاية المسرحية، ما زال “تجار السياسة الحقيرون” في لبنان يملكون القرار والثروة، دون أن يُحاكموا على ما ارتكبوه من تفليس وهدر ونهب وسوء إدارة. وهنا تصبح تاجر البندقية دعوة للبنانيين لا للتعاطف مع “الضحية شيلوك“، بل لمواجهة “الشيلوكات الجُدد” الذين يحكمونهم من داخل البندقية اللبنانية.
- الخاتمة
يتّضح من خلال هذه المقاربة أن “تاجر البندقية” ليست مجرّد مسرحية تاريخية، بل مرآة تكشف عن أزمات متجددة في مجتمعاتنا المعاصرة. في الواقع اللبناني، نجد صدى لكل محور من محاور المسرحية، سواء في الاقتصاد، أو القضاء، أو الهوية، أو حتى في القيم الإنسانية. هذه الدراسة تسعى إلى تفعيل الأدب كوسيلة نقدية وتحليلية، تُعيد النظر في قضايا محورية نعيشها، وتحثّ على التفكير في حلول تتجاوز حدود النص القانوني إلى رحابة الأخلاق والمواطنة. فكما انتهت المسرحية بإعادة التوازن بين الحق والرحمة، لا يزال الأمل ممكنًا في لبنان، بشرط أن نُعيد ترتيب علاقتنا بالقانون، بالدين، وبالآخر، انطلاقًا من قيم الإنسانية الجامعة.