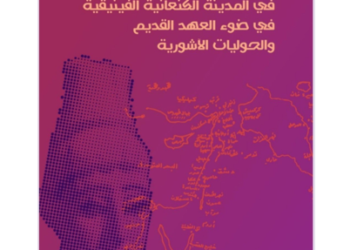عندما يختل النظام الاجتماعي تتهاوى ركائز الوطن
د. الياس ميشال الشويري.
منذ أن نطق الكاتب الروسي الساخر أركادي دافيدوفيتش بمقولته الشهيرة: “الحضارات تجيء وتذهب، ولكن الهمج باقون“، وهي تُقرأ بطرق مختلفة، بين من يراها حكمًا قاسيًا على التاريخ البشري، ومن يفسرها كتحذير دائم من هشاشة ما نعتبره تقدمًا. في سياقنا العربي، وخصوصًا اللبناني، تبدو هذه المقولة وكأنها وُلدت من قلب الواقع: لحظات ازدهار حضاري قصيرة، يتبعها انهيار يعيد المشهد إلى منطق القوة والغريزة. لبنان، الذي عرف في تاريخه القريب فترات تألق ثقافي واقتصادي، يعيش اليوم في حالة انهيار شامل، بينما المنظومة (الفاسدة بامتياز) التي أنتجت هذا الانهيار ما زالت متماسكة وقادرة على التكيف.
هذا المقال يسعى إلى تحليل المقولة من منظور تاريخي وفلسفي، ويفكّك آليات بقاء الهمجية رغم تغيّر الأزمان، ويربط ذلك بواقع لبنان المعاصر. عبر خمسة محاور، نستعرض كيف تتشكّل الحضارات، ولماذا تنهار، وكيف تعيد الهمجية إنتاج نفسها، وصولًا إلى رسم خارطة طريق لمواجهتها وحماية ما تبقّى من ملامح الحضارة.
- المفاهيم والجذور
الحضارة ليست أبراجًا شاهقة ولا شوارع معبّدة، وليست أيضًا أغلفة كتب أو أعلامًا ترفرف في المناسبات الوطنية؛ الحضارة قبل كل شيء هي اتفاق جماعي على قواعد العيش المشترك، واحترام الكرامة الإنسانية، وتنظيم السلطة بما يحمي المصلحة العامة — لا جيوب الحكام. هي مشروع طويل المدى، تراكمي، يحتاج إلى صيانة يومية مثل جدار إذا تركته بلا ترميم، يتآكل بصمت حتى ينهار. الرومان بنوا شبكة طرق وجسور وقوانين صارت نموذجًا للعالم، لكنهم سقطوا حين تحولت المؤسسات إلى مسرح للرشوة والزبائنية، وحين صار الولاء للشخصيات لا للدولة. اليابان بعد الحرب العالمية الثانية أعادت بناء حضارتها على أساس الانضباط والعمل الجماعي، فصارت قوة اقتصادية، بينما دول أخرى بقيت في قاع الهمجية لأنها لم تمتلك الإرادة ولا المؤسسات. لبنان، بعد الاستقلال، كان يملك بذور حضارة: تعليم متقدم، صحافة حرة نسبيًا، اقتصاد متنوع؛ لكنه لم يبنِ مؤسسات راسخة تحميه من الطائفية، فبقي الجدار الحضاري هشًا، تنتظر الهمجية أول زلزال لتسقطه.
الهمجية لا تحتاج إلى فلسفة أو دستور أو خطة خمسية؛ هي تحتاج فقط إلى شهوة سلطة، وغياب قانون، وجمهور مستعد للتصفيق لمن يذبحه إن كان من طائفته. هي كالفيروس الذي يهاجم الجسد حين يضعف جهاز مناعته. في التاريخ، رأينا الهمجية ترتدي كل الأزياء: في العصور الوسطى كانت ترفع سيفًا، وفي القرن العشرين رفعت شعارات وطنية أو دينية أو حتى تحررية، لكنها في الجوهر كانت سعيًا أعمى للسيطرة، ولو على جثث الشعوب. في لبنان، الهمجية ليست صفة فردية بل نظام حكم: زعيم يوزع فتات المنافع على أتباعه، ميليشيات تتحكم في الأمن، وإعلام يبرّر الجرائم باسم المقاومة، أو الدفاع عن الحقوق الطائفية. والأسوأ أن هذه الهمجية قادرة على إعادة إنتاج نفسها جيلًا بعد جيل، لأن النظام التعليمي والإعلامي يغذيها عمدًا.
التاريخ ليس خطًا مستقيمًا نحو التقدّم؛ هو ساحة ملاكمة بين الحضارة والهمجية. حين تنتصر الحضارة، نرى قوانين عادلة، مؤسسات قوية، وازدهارًا ثقافيًا واقتصاديًا. وحين تنتصر الهمجية، نرى الفوضى، النهب، والموت على الأرصفة. لكن الخطورة أن الهمجية أذكى مما نتصور؛ فهي تتعلّم كيف ترتدي قناع الحضارة. النازيون في ألمانيا صعدوا عبر انتخابات، وديكتاتوريات العالم العربي كثيرًا ما تبنت شعارات الديمقراطية وهي تمارس القمع في الخفاء. في لبنان، الحرب الأهلية كانت مواجهة مكشوفة بين الهمجية والسلم الأهلي؛ لكن بعد اتفاق الطائف دخلت الهمجية البرلمان والوزارات وارتدت بدلة رسمية مع ربطة عنق أو بدونها، وأصبحت تتحدث عن الإصلاح والإنماء والمقاومة والتحرير وهي تسرق خزائن الدولة. وهنا تكمن المأساة: حين تختفي الحدود الظاهرة بين الحضارة والهمجية، يصبح الشعب عاجزًا عن التمييز بين من يبنيه ومن يهدمه.

- آليات سقوط الحضارات وبقاء الهمجية
الحضارات لا تسقط غالبًا بهجوم خارجي مفاجئ، بل تنهار من الداخل قبل أن تأتي الضربة القاضية من الخارج. روما لم يدمرها البرابرة في ليلة وضحاها، بل أكلها الفساد الإداري، والتفاوت الطبقي، وفقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم. النظام السياسي حين يتحول إلى شبكة محسوبية، وحين يصبح الولاء أهم من الكفاءة، تبدأ الحضارة في الانكماش. في لبنان، هذه الآلية واضحة حد الفضيحة: الوزارات تتحول إلى حصص طائفية، المناقصات تُفصَّل على قياس المتعهدين المرتبطين بالزعماء، القوانين تكتب لتحمي مصالح قلة لا تتجاوز أصابع اليد. حين يصبح القانون أداة في يد الفاسدين، والمؤسسات واجهة بلا مضمون، لا يحتاج الهمج حتى إلى القوة العارية ليحكموا؛ يكفي أن يجلسوا على الطاولة وينتظروا سقوط ما تبقى من بنيان الدولة.
هناك حضارات اندثرت لأن محيطها تغير بشكل جذري. إمبراطورية الإنكا في أمريكا الجنوبية تحطمت أمام الغزو الإسباني المدعوم بالتكنولوجيا الحديثة والمرض الذي حمله الأوروبيون. الإمبراطورية العثمانية انهارت حين وجدت نفسها أمام قوى صناعية وعسكرية أوروبية متفوقة. في لبنان، الانهيار الخارجي أخذ شكلًا مختلفًا: بلد صغير يعتمد على التجارة والسياحة والتحويلات الخارجية، ينهار فورًا حين تتقلب الظروف الإقليمية أو تنهار الثقة الدولية. التدخلات الإقليمية والدولية حوّلته إلى ساحة تصفية حسابات، وبدل أن تبني النخب اللبنانية سياسة خارجية متوازنة تحمي مصالح البلد، سلّمت القرار الوطني لطرف خارجي مقابل بقاء زعامتها. هنا نجد الهمجية تتغذى على الصراع الخارجي؛ كلما احتدم التوتر الإقليمي، عززت سلطتها عبر خطاب التخويف.
الهمجية ليست كائنًا جامدًا، بل هي كالأخطبوط، تغير لونها وشكلها حسب البيئة. في العصور القديمة، ربما كانت عصابة غزو ونهب، وفي العصر الحديث قد تصبح حزبًا سياسيًا أو شركة احتكارية أو حتى منظمة غير حكومية مزيفة. في لبنان، رأينا الهمجية في كل ثوب: ميليشيات مسلحة في الحرب الأهلية، زعماء طوائف في مرحلة ما بعد الطائف، وجماعات اقتصادية احتكارية في عصر ما بعد الخصخصة. الهمجية تتقن لعبة التحالفات: قد تتحالف اليوم مع دولة أجنبية ضد أخرى، وغدًا تعكس التحالف إذا تغيّرت الموازين. هذه المرونة هي سبب بقائها؛ فهي لا تلتزم بمبادئ أو أخلاق، بل فقط بمصلحتها المباشرة. الأسوأ أن جزءًا من الجمهور يتقبل هذه التقلبات لأنه لا يرى نفسه مواطنًا بل كلبًا تابعًا لطائفة أو زعيم.
- لبنان كمرآة للصراع بين الحضارة والهمجية
لبنان بعد الاستقلال كان يمتلك مكونات واعدة لبناء حضارة حديثة: نظام مصرفي متطور نسبيًا، جامعات ومؤسسات تعليمية ذات مستوى عالٍ، صحافة حرة مقارنة بجواره العربي، ومجتمع مدني نشط. بيروت كانت تُلقب بـ«باريس الشرق»، ليس فقط لأنها مركز تجاري وسياحي، بل لأنها كانت نقطة تلاقي الثقافات والأفكار. لكن هذا الأساس لم يُستثمر ليصبح مؤسسات راسخة فوق الانقسامات الطائفية، بل بقيت البنية هشة ومخترقة. الاقتصاد ظل قائمًا على الخدمات والريوع بدل الصناعة والزراعة، ما جعله هشًا أمام أي أزمة إقليمية. المؤسسات القضائية لم تُحمَ من التدخل السياسي، فأصبحت عاجزة عن فرض القانون على الأقوياء. التعليم، بدل أن يوحد الهوية الوطنية، بقي أداة لغرس الانتماءات الطائفية. النتيجة أن الحضارة اللبنانية بقيت سطحية، أقرب إلى واجهة لامعة تغطّي على ضعف داخلي، وهو ما جعلها عاجزة عن الصمود حين هبّت رياح الحرب.
في الحرب الأهلية (1975-1990)، كانت الهمجية واضحة: ميليشيات مسلحة، خطوط تماس، قصف عشوائي، وخطف وقتل على الهوية. لكن بعد اتفاق الطائف، لم تُهزم هذه القوى، بل دخلت إلى قلب النظام السياسي بربطات عنق أو بدونها ومقاعد وزارية. بدل أن تتفكك الميليشيات، تحولت إلى أحزاب رسمية تمتلك وزارات وشركات مقاولات وبنوك. الهمجية لبست قناع الشرعية، وأصبحت تدير الدولة كغنيمة حرب. المشاريع الإنمائية صارت وسيلة لنهب المال العام، الوظائف الحكومية وزعت بالمحسوبية، والموارد الطبيعية مثل الكهرباء والاتصالات تحولت إلى حقول ابتزاز. الأدهى أن هذه الهمجية السياسية ربطت نفسها بدول إقليمية ودولية، بحيث أصبحت مصالح الخارج جزءًا من معادلة البقاء الداخلي. هذا التحالف بين الفساد المحلي والدعم الخارجي جعل النظام السياسي في لبنان قادرًا على البقاء رغم إفلاسه المالي والأخلاقي.
المواطن اللبناني غالبًا ما يصور نفسه ضحية هذا النظام، وهو كذلك إلى حد كبير: انهيار العملة، تدهور الخدمات، هجرة العقول، وغياب العدالة. لكن في جانب آخر، جزء من الشعب متواطئ مع الهمجية، إما عن قناعة طائفية أو بحثًا عن منفعة شخصية. الهمجية تعرف كيف تشتري الولاء: وظيفة هنا، معاملة ميسرة هناك، حماية في النزاعات، أو حتى شعور بالانتماء لهوية جماعية في مواجهة الآخر. هذا النمط يجعل مقاومة الهمجية صعبة، لأن المواطن لا يرى نفسه في حضارة وطنية جامعة، بل في حضارة صغيرة تخص طائفته أو حزبه. وعندما ينهار النظام ككل، يفضل الكثيرون الارتماء في حضن زعيمهم حتى لو كان سبب الانهيار بفساده، بدل أن يغامروا بمشروع وطني جامع. وهنا يتحقق جوهر المقولة: الحضارة اللبنانية بمؤسساتها ومظاهرها قد تنهار، لكن الهمجية قادرة على البقاء لأنها متجذرة في البنية الاجتماعية والسياسية.
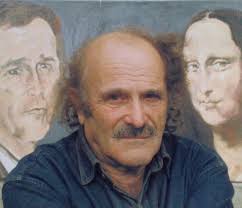
- الانعكاسات الفلسفية للمقولة على الواقع اللبناني والعالمي
المقولة «الحضارات تجيء وتذهب، ولكن الهمج باقون» تحمل في جوهرها رؤية تشاؤمية عن التاريخ الإنساني، لكنها ليست مجرد يأس، بل تحذير فلسفي: الحضارة ليست حالة دائمة، بل استثناء مؤقت وسط بحر من الفوضى. في لبنان، يمكن رؤية هذا بوضوح: لحظات الازدهار كانت قصيرة ومحصورة، بينما فترات الهمجية الطويلة تلتهم الإنجازات بسرعة. عالميًا، نجد المثال في العراق: حضارة بابل وسومر اندثرت، لكن أنماط الحكم الاستبدادي والحروب الأهلية بقيت تتكرر عبر القرون. هذا يعكس أن الهمجية ليست عرضًا طارئًا، بل هي خط أساس في السلوك البشري، والحضارة هي البناء الهش الذي نحاول فوقه أن نعيش.
الحضارات تحتاج إلى جهد مستمر للحفاظ عليها، بينما الهمجية تتجدد تلقائيًا لأنها تستمد قوتها من الغرائز: الخوف، الطمع، حب السيطرة. في لبنان، سقوط العملة وانهيار البنية التحتية لم يضعف النظام الطائفي، بل أعاده أقوى لأنه صار يلعب على وتر البقاء والنجاة في زمن الانهيار. تشارلز داروين، عالم تاريخ طبيعي وجيولوجي بريطاني، قال إن البقاء ليس للأقوى ولا للأذكى، بل للأقدر على التكيف. إذا طبقنا هذا على المقولة، نجد أن الهمجية تبقى لأنها مرنة ومتعددة الأشكال، بينما الحضارة غالبًا جامدة ومقيدة بقوانين وأعراف. في لبنان، السلطة الفاسدة قادرة على تغيير تحالفاتها، تعديل خطابها، أو حتى إعادة تشكيل هويتها حسب الحاجة، بينما المؤسسات القانونية والإدارية لا تستطيع التحرك بالسرعة نفسها. عالميًا، انهيار الاتحاد السوفييتي كان مثالًا على أن حتى الحضارات الكبرى قد تنهار بسرعة إذا لم تتكيف، بينما أنماط الفساد والسلطوية في دول ما بعد الاتحاد بقيت حية بأشكال جديدة.

- خارطة طريق لمواجهة الهمجية وحماية الحضارة
الدرس الأول من المقولة هو أن الحضارة تبقى فقط إذا كانت مؤسساتها أقوى من زعمائها. في لبنان، المطلوب إعادة هيكلة النظام السياسي بحيث يصبح القانون هو المرجع، لا الولاء الطائفي. هذا يتطلب قضاء مستقل، شفافية مطلقة في المال العام، وإلغاء الامتيازات الطائفية في الوظائف. عالميًا، التجربة السويسرية تُظهر أن توزيع السلطة أفقياً وتقوية الإدارة المحلية يحد من تغوّل الهمجية السياسية.
الحضارة ليست قوانين فقط، بل ثقافة يومية. يجب أن ينتقل اللبناني من تعريف نفسه كـ«مسيحي» أو «شيعي» أو «سني» أو «درزي» إلى تعريف نفسه كمواطن له حقوق وواجبات متساوية. هذا يتطلب إصلاح التعليم والإعلام بحيث يصبح الانتماء الوطني هو الهوية الأولى. في سنغافورة، نجح هذا التحول عبر سياسات تعليمية صارمة تفرض لغة مشتركة ورواية وطنية جامعة، مما حمى البلد من الانقسام رغم تنوعه العرقي والديني.
الهمجية تبقى لأنها تعيد إنتاج نفسها جيلًا بعد جيل، عبر النظام التعليمي، الإعلام، والتوظيف السياسي للفقر. كسر هذه الدورة في لبنان يتطلب تمكين الشباب اقتصاديًا، فتح فرص عمل حقيقية خارج المحسوبيات، وتشجيع المبادرات المدنية المستقلة عن السلطة. عالميًا، جنوب إفريقيا بعد الأبارتهايد واجهت التحدي نفسه، واستطاعت إلى حد كبير أن تمنع عودة النظام العنصري عبر دستور تقدمي وبرامج دمج مجتمعي. إذا لم تُكسر هذه الدورة، فحتى لو سقطت الطبقة السياسية الحالية، ستأتي طبقة جديدة من الهمج بثياب جديدة.
- الخاتمة
المقولة التي بدأنا منها ليست مجرد تأمل فلسفي، بل هي وصف دقيق لدورة التاريخ الإنساني، حيث الحضارة هي الاستثناء والهمجية هي القاعدة. في لبنان، هذه الدورة أخذت شكل مسرح عبثي: دولة بمؤسسات حديثة على الورق، لكنها تُدار بعقلية ميليشياوية، وشعب يمزج بين دور الضحية ودور الشريك في استمرار اللعبة. التجربة اللبنانية تكشف أن بقاء الهمجية لا يتطلب العنف دائمًا؛ أحيانًا يكفي الفساد الممنهج، والتطييف السياسي، وشراء الولاءات الصغيرة.
لكن هذا لا يعني أن المصير حتمي. الحضارة يمكن أن تصمد إذا تحولت من واجهة زائفة إلى بنية حقيقية: مؤسسات فوق الأشخاص، تعليم يوحّد بدل أن يفرّق، وثقافة مواطنة ترفض الخضوع للغريزة الطائفية. التجارب العالمية تثبت أن كسر الحلقة ممكن، لكنه يحتاج إرادة جماعية وتضحية آنية من أجل أفق أبعد. وإلا، فإن لبنان سيظل مثالًا حيًا على أن الحضارات قد تذهب، لكن الهمجية تعرف كيف تعود دائمًا بأسماء وشعارات جديدة.