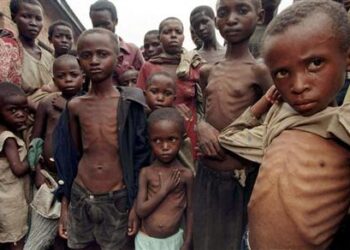يخرقان مقولة فيسك و ينظّفان شاطىء رملي في لبنان
د. الياس ميشال الشويري
تثير ملاحظة المراسل والكاتب البريطاني المخضرم روبرت فيسك تساؤلًا عميقًا حول التناقض الصارخ في السلوكيات الاجتماعية لدى العرب: كيف يمكن أن تكون البيوت نظيفة ومرتبة إلى حدّ المثالية، بينما الشوارع والأماكن العامة تعجّ بالقاذورات والفوضى؟ هذا التناقض ليس مسألة عابرة تتعلق بالعادات الفردية أو ضعف الثقافة العامة فقط، بل هو انعكاس لأزمة أعمق ترتبط بغياب الشعور بالانتماء إلى الوطن، وانعدام الثقة بالسلطات التي من المفترض أن تحافظ على المساحات العامة. فالعربي، بحسب هذا التحليل، يشعر أنّ بيته ملكه الحقيقي، بينما وطنه مخطوف أو مغتصب من قِبل أنظمة فاسدة أو قوى خارجية، فلا يبذل جهدًا في الحفاظ على فضاءات لا يراها جزءًا من ذاته.
إنّ هذه الإشكالية تتخذ في لبنان أبعادًا أكثر خطورة، إذ إنّ الشعب اللبناني يعتني بمنازله حدّ الهوس، فيما يترك شوارعه مسرحًا للنفايات والحفر والعشوائيات. هنا يبرز السؤال: هل اللبنانيون لا يحبون وطنهم فعلًا، أم أنّهم يشعرون أنّ هذا الوطن ليس لهم، بل هو غنيمة بيد قوى طائفية ومليشيوية ومصالح دولية؟ من هذا المنطلق، يكتسب البحث قيمة كبرى، لأنه يفتح باب النقاش حول العلاقة بين الفرد وفضائه الخاص، وبين المواطن ووطنه المنهوب.
- البيت كملاذ خاص والوطن كفضاء مسلوب
البيت بالنسبة للعربي ليس مجرد جدران وسقف، بل هو الحصن الأخير الذي يلوذ به من ظلم السلطة، وانتهاك الحقوق، وفوضى الشارع. لهذا نرى البيوت في العالم العربي مرتبة، نظيفة، وأنيقة، وكأنها تعويض عن غياب الوطن المنظّم. فالعائلة تكرّس وقتها وجهدها ومالها لتجميل البيت، لأنها تعتبره الامتداد الوحيد لكرامتها وملكيتها الفعلية. بالمقابل، يشعر المواطن أنّ الشارع ليس له، وأن أي محاولة للحفاظ عليه ستكون عبثية أمام سلطة غائبة أو فاسدة لا تكترث لنظافته. هذا الوعي المزدوج يخلق انفصامًا في السلوك الاجتماعي: تقديس البيت وتهميش الفضاء العام.
في لبنان، تتضاعف هذه الظاهرة بسبب الطابع الطائفي للنظام السياسي. فالمواطن لا يشعر أن الدولة وطنٌ جامع، بل مجرد محاصصة بين زعماء الطوائف. لذلك، هو يحافظ على بيته، وربما على حيه الطائفي، لكنه لا يكترث بالفضاء الوطني المشترك. لقد شهدنا كيف تحولت مسألة النفايات في بيروت إلى أزمة وطنية كبرى، ليس لأنّ الشعب عاجز عن رمي النفايات في أماكنها، بل لأنّ السلطة حولتها إلى وسيلة ابتزاز وفساد ونهب. هنا يتضح المعنى العميق لعبارة فيسك: “العرب يشعرون أنهم يمتلكون بيوتهم ولكن لا يمتلكون أوطانهم“.
هذا الانقسام بين الخاص والعام يولّد جروحًا اجتماعية ونفسية عميقة. فالمواطن العربي ينشأ على حب بيته والدفاع عنه، لكنه يتعلم في الوقت نفسه أن وطنه ليس ملكًا له، بل هو مسلوب من قوى داخلية وخارجية. لذلك لا يتردد في الهجرة، لأنه لا يشعر أن الوطن مكان يُبنى ويُصان، بل مجرد محطة مؤقتة للفوضى. في لبنان تحديدًا، يترسخ هذا الشعور بسبب فساد المنظومة الحاكمة وتبعيتها للخارج، حيث بات المواطن يردد في داخله: “البيت لي، لكن الوطن لهم“.

- ثقافة الملكية الفردية مقابل غياب الشعور بالملكية الوطنية
في علم الاجتماع، يُعتبر الشعور بالملكية عنصرًا أساسيًا لبناء السلوكيات المسؤولة. عندما يشعر الفرد أن الفضاء العام ملك له، يتعامل معه كما يتعامل مع بيته. لكن في المجتمعات العربية، تغيب هذه الفكرة بسبب القمع السياسي والفساد الإداري، مما يجعل المواطن يرى نفسه مجرد مستأجر في وطنه، وليس مالكًا له. هذا ما يفسّر الاستهتار بالشوارع، الحدائق، والدوائر العامة، مقابل الاهتمام الكبير بالفضاء الخاص. فالوعي الجمعي لم يتكوّن على أسس المواطنة، بل على أسس الانتماء القبلي والطائفي.
في لبنان، حيث النظام الطائفي يقسّم كل شيء من الوزارات إلى الوظائف العامة، يُترجم غياب الملكية الوطنية بشكل أوضح. فالمواطن يشعر أن الطرقات ليست له، بل لزعيم الطائفة الذي يقرر إنارتها أو تركها مظلمة. المستشفى الحكومي ليس له، بل لجهة حزبية تسيطر على خدماته. حتى الجامعة الوطنية ليست ملكًا عامًا، بل ساحة نفوذ لتيارات سياسية. لذلك يهرب المواطن إلى دائرته الضيقة: منزله أو كنيسته أو حسينيته، حيث يجد هوية وانتماءً، ويترك الفضاء الوطني المشترك غارقًا في الإهمال.
غياب الشعور بالملكية الوطنية ينعكس أيضًا في ضعف الحسّ المدني لدى اللبناني. فحين يُطلب من المواطن دفع ضرائب، يعتبرها نهبًا لا واجبًا، لأنه لا يرى مقابلًا لها. وحين يُطلب منه الحفاظ على النظافة في الأماكن العامة، يتجاهل الأمر لأنه يعتبر أنّ الدولة لا تقوم بواجباتها. وهكذا تتكرس حلقة مفرغة: المواطن يهمل لأن الدولة فاسدة، والدولة تزداد فسادًا لأنها لا تجد مواطنًا يحاسبها. النتيجة: وطن بلا مالك حقيقي، وشعب يلوذ إلى بيته كجزيرة صغيرة وسط محيط من الفوضى.

- من الفضاء الخاص إلى استعادة الفضاء العام
السؤال الجوهري هو: هل يمكن للعربي أن ينقل عنايته ببيته إلى الشارع والوطن؟ الجواب ممكن إذا شعر المواطن أن الوطن ملكه فعلًا. هنا يأتي دور التربية المدنية، والإصلاح السياسي، وإعادة الثقة بالمؤسسات. فالمواطن الذي يرى أن ضرائبه تُستثمر في بناء طرقات وجامعات نظيفة سيحرص تلقائيًا على صونها. المشكلة ليست في طبيعة الإنسان العربي أو اللبناني، بل في الإطار السياسي والاجتماعي الذي يصادر حسّه بالانتماء. تغيير هذا الإطار كفيل بتحويل النظافة من فعل فردي داخل البيت إلى فعل جماعي في الشارع.
في لبنان، استعادة الفضاء العام تبدأ من استعادة الدولة نفسها من قبضة المافيات الطائفية. حين يشعر اللبناني أن شوارع بيروت وطرابلس وصور وزحلة ليست ملكًا لزعيم، بل له ولأولاده، سيهتم بنظافتها كما يهتم بمدخل بيته. حين تُفتح الحدائق العامة مجانًا ويُمنع الاستيلاء عليها من قبل الأحزاب، سيشعر الناس أنها امتداد لبيوتهم. هذه المعركة ليست تقنية تتعلق فقط بإدارة النفايات، بل سياسية بامتياز، لأنها تعني الانتقال من وطن مسلوب إلى وطن مملوك من شعبه.
التجارب العالمية تؤكد أن الشعوب قادرة على الانتقال من ثقافة “البيت فقط” إلى ثقافة “الوطن كله“. في دول مثل اليابان أو ألمانيا، النظافة مسؤولية جماعية لأنها جزء من الهوية الوطنية. اللبنانيون والعرب ليسوا أقل قدرة من هذه الشعوب، لكنهم بحاجة إلى ثورة وعي وإصلاح سياسي يعيد لهم شعور الملكية. حينها فقط سيصبح الشارع امتدادًا للبيت، والوطن بيتًا للجميع، لا حكرًا على فئة أو حزب أو حاكم.

- الخاتمة
يُظهر تحليل فيسك أنّ الأزمة ليست في تربية فردية أو عادة اجتماعية عابرة، بل في علاقة مأزومة بين المواطن العربي ووطنه. فالعربي ينظّف بيته لأنه يملكه، ويهمل وطنه لأنه يشعر أنه مسلوب. في لبنان، هذا الانفصام تجلّى بأبشع صوره، حيث تحولت النفايات إلى سلاح سياسي، والفضاء العام إلى غنيمة. الحلّ لا يكمن في حملات موسمية للنظافة، بل في إعادة بناء مفهوم المواطنة والملكية الوطنية. فعندما يستعيد اللبناني وطنه من الطغمة الفاسدة، سيخرج من جدران بيته ليبني بيتًا أكبر اسمه لبنان.