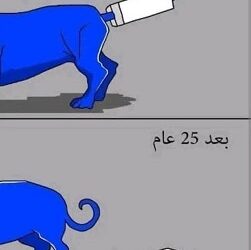ساركوزي ممسكا بيد زوجته الى السجن
د. الياس ميشال الشويري
في عالمٍ يسوده التناقض بين الشعارات والواقع، تظهر حادثة الحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق نيقولا ساركوزي بالسجن بتهمة تلقي أموال غير شرعية من النظام الليبي السابق لتمويل حملته الانتخابية (تجدر الإشارة هنا الى أن الرئيس ساركوزي يبدأ اليوم الثلاثاء قضاء عقوبة السجن 5 سنوات في سجن لاسانتي بباريس، ليصبح أول زعيم فرنسي يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية) كمرآةٍ عاكسةٍ للفارق الشاسع بين مفهوم العدالة في الدول التي تحترم نفسها، وتلك التي اختارت طوعًا أن تعيش في ظلام الفساد والاستزلام والمحسوبيات. ففرنسا، رغم تاريخها الاستعماري القاسي، تبرهن اليوم أنّ سيادة القانون لا تعترف بمقامات ولا بحصانات، فيما لبنان، بلد الأرز والمفارقات، ما زال غارقًا في مستنقع الزبائنية، حيث الزعيم فوق القانون، والمال السياسي فوق العدالة، والفساد صار نهجًا مؤسّسًا يبرر استمرارية الطبقة نفسها منذ أكثر من أربعين عامًا. هذه المقارنة ليست مجرد تمرينٍ فكري، بل هي صرخةٌ في وجه الانحطاط الوطني، ودعوة للتأمل في السؤال المؤلم: لماذا يُحاسَب الرئيس في فرنسا، ويُكرَّم الفاسد في لبنان؟
1. العدالة التي لا تعرف الوجوه – فرنسا كنموذجٍ للدولة الحديثة
حين قررت المحكمة الفرنسية إدانة نيقولا ساركوزي بالسجن، لم يكن ذلك مجرد إجراء قضائي، بل كان رسالة إلى العالم بأسره أن الجمهورية الفرنسية لا تخضع للأسماء اللامعة، ولا تتردد في فتح الملفات مهما علت الرؤوس. لم تنفعه صوره مع القادة، ولا تاريخه في قصر الإليزيه، ولا علاقاته داخل المنظومة السياسية. القانون هناك لا يعرف العواطف، بل يزن بالأدلة والوثائق. فالقاضي الفرنسي لا يهمه إن كان المتهم وزيرًا أو رئيسًا، بل إنّ سلطته القضائية تكتسب معناها الحقيقي حين تطال القمم، لا القواعد فقط. العدالة الفرنسية لا تتجمّل بشعارات، بل تُمارَس كفعلٍ يوميٍّ منضبطٍ يخضع للمؤسسات الرقابية والصحافة الحرة والرأي العام الواعي. ومن خلال هذه الواقعة، أثبتت فرنسا أنّ مفهوم المحاسبة ليس شعارًا انتخابيًا، بل منظومة أخلاقية وقانونية تحمي المجتمع من الانهيار الأخلاقي والسياسي.
تاريخ الجمهورية الفرنسية زاخر بالأمثلة على محاسبة الكبار: رؤساء، وزراء، قضاة، ورجال أعمال. هناك، لا أحد فوق القانون، بل القانون فوق الجميع. أما في لبنان، فالمفارقة الصارخة أن الفاسدين يتباهون بفسادهم، ويتوارثون السلطة وكأنها ملك عائلي. القضية لا تتعلق بشخص ساركوزي وحده، بل بمفهومٍ أوسع للعدالة التي تُبنى على فصل السلطات. فحين يحاكم القضاء رئيسًا سابقًا، لا تُهتزّ الدولة، بل تتعزز مكانتها في ضمير مواطنيها. في المقابل، لبنان الغارق في المحسوبيات لا يرى في القضاء إلا أداة بيد السياسيين، يتم تعطيله حين يقترب من خطوطهم الحمراء. هكذا تتحول العدالة إلى مسرحية، والقضاة إلى موظفين يكتبون تقارير على مقاس أصحاب النفوذ. وبين مشهدَي باريس وبيروت، تُقاس المسافة بين دولةٍ تصون كرامتها ودولةٍ تُهين نفسها كل يوم.
إنّ العدالة في فرنسا ليست وليدة لحظةٍ أو قضية، بل ثمرة قرونٍ من التطور المؤسسي والفكري الذي رسّخ ثقافة المساءلة. فالثورة الفرنسية عام 1789 لم تكن مجرد انتفاضة على الملك، بل على مبدأ الامتيازات الذي كان يضع بعض البشر فوق القانون. واليوم، حين يُسجن ساركوزي، يبدو وكأنّ فرنسا تجدد عهدها مع تلك القيم التأسيسية. أما في لبنان، فالثورات التي اندلعت منذ عقود، من انتفاضة الاستقلال إلى ثورة 17 تشرين، بقيت ناقصة لأنها اصطدمت بجدار الطائفية والولاءات العمياء. فالشعب الذي لا يطالب بمحاسبة زعمائه هو شريك ضمني في جريمة استمرارهم. وهنا يصبح السؤال الوجودي للبنان: هل نريد وطنًا أم زعامات؟ عدالة أم طوائف؟ مؤسسات أم مزارع سياسية تتقاسمها العصابات منذ الحرب الأهلية وحتى اليوم؟

2. لبنان بين الإفلات من العقاب وتقديس الزعيم
في لبنان، لا يُحاسَب أحد. ليس لأنّ الجرائم غير موجودة، بل لأنّ المجرمين هم من يكتبون القوانين. إنّ الطبقة السياسية التي تتنقّل بين الوزارات والمناصب منذ أكثر من أربعين عامًا هي ذاتها التي تسببت بالديون، والفساد، والانهيار المالي، والحروب، وتواطأت مع الخارج ضد الداخل. ومع ذلك، لا نرى محاكمات ولا مساءلات. فالمحاسبة هنا تُستبدل بالتحالفات، والجرائم تُغسل بصفقات، والفساد يُكرَّس بتسويات “لبنانية” تحمي الجميع. حتى حين ينهار البلد ويُفجَّر المرفأ وتُسرَق الودائع، يبقى الفاسد حرًّا يتجول بين الناس بوقاحةٍ، ويُستقبل كزعيمٍ منقذٍ في طائفته. العدالة في لبنان ليست عمياء، بل عمياء اختيارياً حين يتعلق الأمر بأسيادها، مبصرة حين تطال الضعفاء والمهمّشين.
اللبناني، المقهور منذ الحرب الأهلية، صار يرى في الظالم قدرًا لا يمكن تغييره. لقد جرى تطويعه عبر الإعلام والطائفية والوعود الكاذبة حتى صار يقدّس جلّاده. إنّ أخطر ما أصاب لبنان ليس الفساد كظاهرةٍ مالية فقط، بل كمرضٍ نفسي جماعي، حيث يستمر الشعب في انتخاب من سرقوه، ويدافع عن من دمّروا مستقبله، ويبرر جرائمهم بحجّة أنهم “أولاد طائفته” أو “أقوياء” في وجه الآخرين. هذا التواطؤ الشعبي جعل الفساد ثقافة لا تُدان بل تُحتفى بها. وهنا تكمن المأساة: أن يتحول المجرم إلى زعيم، والضحية إلى مشجعٍ له، فتغدو الدولة مسرحاً للعبث والنهب. لا غرابة إذًا أن يبقى لبنان البلد الوحيد الذي لم يُحاسَب فيه مسؤول واحد رغم الكوارث المتلاحقة، من الحرب الأهلية إلى مجزرة المرفأ.
بينما يدخل ساركوزي اليوم السجن، نرى في لبنان رموز الحرب والفساد يتقاسمون المناصب ويعقدون الصفقات تحت عناوين الوطنية والسيادة والمقاومة. حتى “الانتصارات الوهمية” التي يتغنى بها البعض ضد إسرائيل كانت في جوهرها غطاءً لإبقاء السلاح خارج الدولة، وتعزيز نفوذ الطائفة على حساب الوطن. فالمعركة الحقيقية في لبنان لم تكن يوماً مع الخارج بل مع الداخل، مع ذهنية لا تعرف الدولة إلا كغنيمة. وحين تحولت الدولة إلى بقرةٍ تُحلب باسم الطوائف، أصبح المستفيدون منها يقاتلون من أجل استمرارها على هذا الشكل. لذلك لا عجب أن ترى اللصوص يرفعون شعارات المقاومة، والفاشلين يتحدثون عن السيادة، والمتورطين في الجرائم يظهرون كأبطالٍ أمام جمهورٍ مسلوب الإرادة. إنها جمهورية “اللاحساب“، حيث القاتل والمخلّص يختلطان، وحيث العدالة لا تجد مكاناً لتقف عليه.

3. بين دولة القانون ودولة اللاعقاب – من المقارنة إلى العبرة
الفرق بين فرنسا ولبنان ليس في الذكاء أو الحضارة أو الثقافة، بل في الإرادة السياسية والأخلاق العامة. حين تقرر دولة ما أن تحاسب، فهي تُعلن التزامها بالمستقبل، لأن العدالة ليست ثأراً بل تصحيحاً للمسار. في المقابل، حين يختار لبنان أن يحمي فاسديه، فهو يعلن موته الأخلاقي قبل الاقتصادي. لقد تحولت المؤسسات اللبنانية إلى هياكل بلا روح، والقضاء إلى موظفٍ عند أصحاب النفوذ، والمواطن إلى متسولٍ ينتظر الفتات من الزعيم. هذا الانهيار لم يأتِ من فراغ، بل من غياب ثقافة المحاسبة التي تجعل الجريمة مكسباً لا خطيئة. فالدولة التي لا تُحاسب قادتها تتحول إلى غابةٍ تُحكم بمنطق القوة لا القانون، وهذا بالضبط ما وصل إليه لبنان.
حين يُسجن ساركوزي، تهتز أوروبا احتراماً للقضاء الفرنسي، أما حين يُطلق سراح المرتكبين في لبنان، تزداد الدول اشمئزازاً من نظامٍ فقد هيبته. في العالم المتحضر، العدالة هي الركيزة التي تبني الثقة بين المواطن والدولة. أما في لبنان، فكل حكم قضائي يُراجع سياسياً، وكل ملف يُغلق بالتسوية. لذلك يعيش اللبناني في دوامةٍ من الإحباط، إذ يرى كل يوم أن الفساد لا يُعاقب بل يُكافأ، وأن الولاء لا يكون للوطن بل للزعيم. في هذا السياق، يصبح الحديث عن الإصلاح مجرد لغوٍ في ظلّ منظومةٍ تحمي نفسها من الداخل. لكن التاريخ لا يرحم، والدول التي تجاهلت العدالة سقطت مهما طال الزمن، لأن الفساد حين يُترك بلا رادع، يلتهم نفسه في النهاية.
العبرة من قضية ساركوزي ليست في فرنسا وحدها، بل في الدرس الذي يجب أن يتعلمه لبنان إن أراد أن يبقى. فالقانون لا يُقيم العدالة إن لم تُدعمه إرادة وطنية حقيقية وشعبٌ يرفض الذل. لن ينهض لبنان ما دام الفاسدون طلقاء، وما دامت الطوائف تُقدّم زعماءها على حساب الوطن. العدالة ليست حلمًا مستحيلًا، بل خيارًا يحتاج إلى شجاعة. إنّ أول الطريق إلى الخلاص يبدأ عندما يقرر اللبنانيون أن يقولوا: “كفى“. كفى تبريرًا، كفى طاعةً عمياء، كفى خضوعًا للجلاد. ففرنسا سجنت رئيسًا دفاعًا عن القانون، ولبنان لا يزال يسجن الحقيقة دفاعًا عن الفساد. وما بين باريس وبيروت، تقف الإنسانية أمام مفترق طرق: إما أن تنتصر العدالة، أو ينتصر الخراب الذي صار قدر الشعوب التي استسلمت لفسادها.
4. الخاتمة
إنّ ما يحدث في فرنسا اليوم ليس مجرد خبرٍ قضائي عابر، بل مرآةٌ تضع أمام لبنان صورته البائسة. هناك يُحاسبون الرؤساء لأنهم يؤمنون بالدولة، وهنا يُصفّقون للفاسدين لأنهم يؤمنون بالطائفة. بين العدالة والمهزلة، بين دولة القانون ودولة اللاعقاب، يظهر لبنان كجرحٍ مفتوحٍ على خيانة دائمة. وربما آن الأوان لأن ندرك أنّ العدالة ليست مطلبًا سياسيًا، بل هي فعل بقاءٍ وكرامةٍ وطنية، لأن الأوطان لا تموت حين تُقصف، بل حين تُعطَّل العدالة، وحين يصبح المجرم حاكمًا، والحقّ سجينًا في وطنٍ بلا ضمير.