قطوف القباني واهداء بخط اليد ٢٠١٢
د. غالب خلايلي
صدر صيف 2012 عن دار العلم للملايين في بيروت كتاب (قطوفٌ من الحياة) للأستاذ الدكتور سامي القباني (1937-2017)، جرّاح القلب الشهير، وصاحب مجلة (طبيبك) العريقة (1958-2015)، نستعرضه في هذا المقال، إحياء لفكر الأستاذ رحمه الله، وتبيان قراءته النقدية الحكيمة في قضايا يظن بعض الناس أنها حديثة العهد.
يقول الأستاذ القباني في المقدمة: “وها أنذا بعد أربعين حولاً، وفي حوزتي عددٌ لا يستهان به من الأحاديث كتبتُها وأنا في أحوال شتّى من الابتهاج أو التكدّر، والرضا أو التذمر.. في أحوال اليقين والتفاؤل، والتأمّل والتساؤل. لكنّ الدافع وراءها كان دوماً الارتقاء بالإنسان العربي نحو الأفضل، سواء أعن طريق النقد الذاتي، أم التذكير بقدرات أمتنا الكامنة، أم الإشارة للقيم الإنسانية السامية، أم التبصير بما كشفتْ عنه العلوم والمعارف الحديثة”.
كل ذلك جاء بأسلوب أدبيّ راقٍ، وإن تواضع الأستاذ بالقول: (أنا لستُ أديباً)، لأن الكلمات لا تأتي إليه طواعية، إذ ألِف لغةَ العلم التي لا تستسيغ المبالَغَ فيه من الكلام، ولا كلّ ما هو غير مدقّق أو موثّق.
– في الجانب الاجتماعي:
يتحدث مقال (حتى يتكاملَ ضميرُنا الاجتماعي) عن عادات سيئة قديمة منتشرة في المجتمع مثل (صوت المذياع العالي، ورمي الأوساخ أمام الجيران، وتنخّع بعض الرجال أو بصقهم على مرأى الناس، وهجوم المنتظرين على باب الحافلة، وسير السيارات دون مراعاة لأبسط قواعد المرور)، وفي كل هذه المواضع يُلاحظ غيابُ ضميرِنا الاجتماعي أو ضعفه، وقد يكون الوصول إليه أصعب من محاربة الأمّية والفقر.
وفي مقال آخر يدعونا أن نكون نحن العرب (أكثر دقّةً في تعبيرنا) كيلا نؤاخذ في جوانبها السلبية، فمألوف أن يبالغ الناس في كلامهم: “طفلي مصاب بحمّى محرقة”، وكذا المبالغة بعدد المصابين في أي حادث، وغير ذلك في الحياة والسياسة. أما مقال (مزمار الحي) فيتحدث عن أولئك الذين يسافرون للعلاج في الخارج، رغم المشقة والكلفة العالية، بسبب قلة الثقة في طبنا، أو رواج الدعاية لبعض البلدان الأجنبية أو بسبب “عقدة تفوق الأجنبي“. إن للطبيعة الإنسانية باعاً كبيرة في تجسيم المحاسن والميزات خارج بيئتنا، وتعظيم المثالب والسيئات داخلها.
وفي (الناس والخرافات) نرى التشاؤم من القطة السوداء والرقم 13 وغيرها، وهي كما يقول المفكر أدموند يورك: “ديانة ذوي العقول الواهنة”. ومع ذلك لا يملك الجرّاح أن يمسك نفسه من التفاؤل عندما يقول له مريض: “حكيم. توكّل على الله، فأنا أشعر أني سأخرج من العملية مثل الشعرة من العجين”!، ولا من التشاؤم حين يخبره المريض إنه يشعر بقرب نهايته.
في مقال (اعتبر من نظرة الآخرين إليك) نرى أن القليل منَّا يعدّ نفسه أقل شأناً من تقدير الآخرين، والبعض المحظوظ تتفق نظرتهم لأنفسهم مع نظرة غيرهم، لكنَّ كثيرين يفوق تقييمهم لأنفسهم تقييم الناس لهم، وهؤلاء عرضة دوماً للتصادم مع مجتمعهم، وصعوبة التأقلم مع البيئة.
– في الجانب الوطني:
يشي بعض العناوين بمضامينها، (فليس الفتى من قال: كان أبي)، و(السياسة وغوغائية التعبير لا يجتمعان)، فيما نحتاج إلى أخذ (دروس من طيور الإوَزّ) وهي تهاجر، إذ تصطف اصطفافاً على شكل حرف V متآزرةً وموفرةً الطاقة.
إن الكاتب يحلم بالمستقبل الأفضل الذي لا هوّة فيه بين دولنا وبين الدول المتقدمة، ولا دول تمتص ثرواته. يحلم في (هل تعرف من أنت؟) بأن يعرف العربي أن كثيراً من المنجزات المهمة في العالم ذات أصل عربي، فابن خلدون مؤسس علم الاجتماع عربي، وابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل هارفي عربي دمشقي، وأبو العلاء المعري كتب رسالة الغفران قبل دانتي.. والأمثلة لا تحصى منذ عهد قدموس (ومنها عبقرية المهندس المعمار أبولودور الدمشقي (60-130 م) فيما سمّي زوراً وبهتاناً العمارة الرومانية).
وفي مقال (ابدأ بنفسك) يتحدث الكاتب عن أحوال العرب الراهنة، التي تذكّر بنبوءة الرسول (ص) حين قال: “يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأَكَلة على قصعتها”…. لكنكم غثاء (زبد) كغثاء السيل!”. والحل هو أن يبدأ كل منا بنفسه في الإصلاح.
وفي مقال (تلك الأحكام الجائرة) يعلّمنا الكاتب ألا نطلق أحكاماً مسبقة، وأن تتحكّم خصائصُ الفرد نفسه (دون لونه أو مذهبه أو بلده) في المعاملة، بعيداً عن الصورة المسبقة، مثل أنّ البريطاني متعجرفٌ بارد، والدمشقي يعيش فقيراً ويُتَوفى غنياً (عكس البيروتي)، والعربي في نظر الغربي هو الجاهل الغريزي القذِر غير الدمث!.

– في الجانب الإنساني:
في مقال (الخير لا يتجزّأ) يوضح الكاتب أننا كثيراً ما نعادل النجاح في الحياة، خطأً، بالوصول إلى نتائج ملموسة. إن النجاح يبدأ بأول خطوةٍ نحو هدفٍ سامٍ. أما (لو تبادل الناس أحذيتهم) أي لو وضع الإنسان نفسه مكان الآخر في أي اختلاف رأيٍ أو مشكلةٍ فستتغيّر كثير من مفاهيمه. وفي (إغاثة الملهوف لا تحتاج إلى ضجة) نرى أنه من السهل، عندما يتخبط إنسان في مشكلة ما، أن نترك الأمور تأخذ مجراها، ونشيح بوجهنا وكأن الأمر لا يعنينا، متناسين أننا معرَّضون للوقوع في الشدة والأزمات في أي وقت. وفي مقال (التطور التقني والتطور الخُلُقي) يبين الكاتب أنّ التطور التقني المدهش لم يرافقه تطور روحي أخلاقي مماثل. أما مقال (أنصاف البشر) فيبين أنّ السيجارة الأجنبية المتزايد منعُها في موطنها (حتى ضُمّت إلى لائحة أسباب الطلاق المقبولة) هبطت مبيعاتها، والسوق البديلة هي دولنا، حيث تباع سجائر دون المواصفات المقبولة، وكأن شعوبنا أنصاف بشر.
ويبين مقال (الشرق شرق والغرب غرب) اعتقاد الغربي بأن الحياة هي كل ما سيخبر ويملك، ولهذا يتكالب على كل ما يجلب اللذة للنفس؛ أما الشرقي فعنده قناعة بما قُسِم له من حظّ ورزق؛ وتوقّع الحساب بعد الموت؛ وتبجيل الأبوين حتى بعد العجز؛ وإيثار شظف العيش إذا كان في ذلك حفظٌ لماء الوجه؛ وقبول فقدان الأحبّة على أنه قضاء الله؛ والاستعداد للتضحية بالنفس في سبيل غاية أسمى.. وعلى هذا قال الأديب البريطاني رديارد كيبلنغ: الشرق شرق، والغرب غرب، ولن يلتقيا”.
– في الجانب التربوي:
في مقال (لا تهدر وقتك) يقول الكاتب: يؤلمني منظر الشبان يتسكّعون في الطرقات وأمكنة اللهو، وتضايقني رؤية الموظّفين يحتسون كؤوس الشاي، ويُمضون الجزء الأكبر من عملهم في مقابلات شخصية، ويحزُّ في نفسي منظر من يؤمُّون المقهى كل يوم لا يخرجون إلا ورئاتهم مشبعة بدخان السيجارة والغليون والشيشة!. تصوَّر أنك قطعت عهداً على نفسك أن تقرأ عشر صفحات من كتاب قبل النوم كل ليلة، وتصوّر أنك تهرول خمس دقائق كل صباح قبل ذهابك للعمل، ولنفرض أنك خصَّصت ساعتين في الأسبوع لتتعلَّم لغة جديدة، إنك تحقق الكثير.
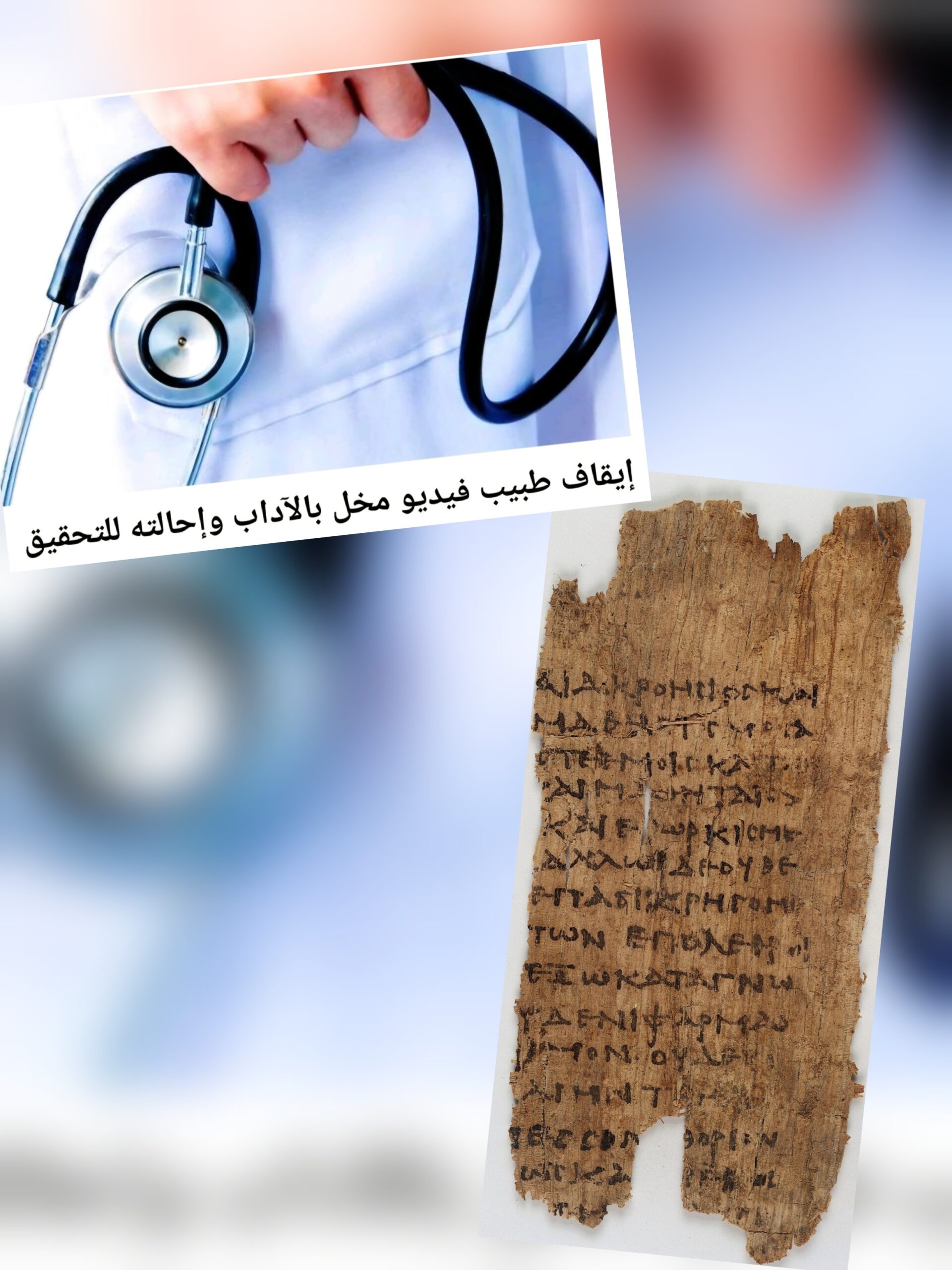
ثم يعلمنا الكاتب (أن نتعلّم من فشلنا) فجميع الناس معرض للفشل الطفيف أو المهمّ، كالتنحية عن منصب، أو إضاعة صفقة، أو نكبة تفرق أفراد العائلة، وهذا مصدر للكآبة والقنوط، لكن الفشل معلّمٌ كبير لوعرفنا كيف نستثمره.
في مقال (العمل والإتقان) نرى أننا كثيراً ما نفتقد الإتقان في عملنا. والأمثلة أكثر من أن تحصى، فهل حدث أن اقتنيت خزانةً للثياب تفتح دروجُها بيسرٍ وتغلق أبوابها بدقة، أو عمل لك أحدهم عملاً وأتقنه، ورسولنا الكريم يقول: “إن الله يحبُّ من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه”؟
وفي الحياة المليئة بالعمل والهموم يطلب (ألا ننسى محطات الوقوف). إن الترحال بدون محطات مرهق، وقد يقضي على الرحَّالة قبل أن يبلغ وجهته. ويؤكد الكاتب أنّ على المرء أن يتعلم (فن الإصغاء) وأن يكون (مرآة صادقة لنفسه)، وأنه (آن الأوان لإصلاح طريقتنا في التعليم)، وأن (نشجع أولادَنا على الابتكار)، وأن نعلّمهم (فنّ البساطة)، وكيف يختارون مهنهم. وأخيراً يبيّن أن (ذكرى ميلاد المرء) بدعةٌ غربيةٌ لكنها ليست بالضرورة تقليداً سيئاً، فهي مناسبةٌ يقف المرء عندها ليلتقط أنفاسه، يتطلّع خلفها لما أنجز ويخطّط لمستقبله.
– في الجانب الفلسفي:
يحدثنا الكاتب عن السعادة فيقول (إنها ذلك المطلب المراوغ). نعم، كلنا نسعى وراءها، فنحن ننشد المأكل الطيب والمرتبة الأعلى والمنظر الجميل. ولكن الطبيب الفيلسوف ألبرت شفايتزر يصف السعادة بأنها ليست أكثر من صحة جيدة، وذاكرة ضعيفة!. أما مارك توين فيعتقد أن السعادة تجنى عن طريق الصديق البار، والكتاب القيّم، والضمير المطمئن. إن السعادة ليست حكراً على طبقة من الناس، فلا المال ولا الشهرة ولا السلطة ضمان. ويبدو أنّ لكلّ شخص استعداداً فطرياً لقدر من السعادة لا تؤثر فيه ظروف الحياة إلا بحدود.
(وعجباً من أمر الدنيا).. كلَّما ربِحْتَ جولة أدركْتَ بعد فوات الأوان أنك خسرتَ غيرها. بعض الناس يكدّون ليصبحوا أثرياء، فيما يخسرون الكثير من راحة بالهم وسعادتهم البيتية. والطب يسعى لحل المشاكل لكنه ينتهي بوفرة المسنين والعجزة الذين يشكلون أعباء. يقول بول غيبونز: “إننا نعيش في مجتمع استطاع أن يؤمِّن لنا مكاسب مادية كثيرة، وهذا أمر يدعو إلى الغبطة، لكني صرت مؤمناً، أننا دفعنا ثمناً روحياً غالياً مقابل هذا الترف”.

– عودة إلى الطب وقسم أبقراط:
وأخيراً يختتم القباني كتابه بمقال يذكّر فيه الأطباء بـ (تراث أبقراط) وقسمه الشهير، ومنه: (أن أعدَّ من علّمني الطب بمنزلة والدي، وأن أنفقَ عليه إذا صار محتاجاً، وأن أعاملَ أفراد عائلته كإخوة لي، وأن أعلّمَهم الحرفة إن رغبوا بغير مقابل، وكذا أعلّمها لأولادي ولكل من تعهّد أن يكون طبيباً، وأن أستخدمَ علمي في شفاء المرضى، وألا أعطيَ علاجاً فتاكاً، وألا أستغلّ صنعتي في اقتراف المنكرات والأذى، وأن أتحاشى التعدّيَ على الحرمات، وألا أبوحَ لأحدٍ بأي شيء أراه أو أسمعه، وأعدَّ هذه الأمور أسراراً مقدّسة).
وكـأني بالأستاذ الخبير يشير إلى أن أغلب تراث أبقراط لم يعد موجوداً على هذه الأرض.
رحم الله الطب والناس، ورحم فقيدنا الكبير.

























































