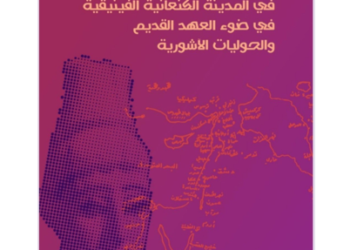الشعنينة من العادات المسيحية
د. الياس ميشال الشويري
عبر التاريخ، ظل التديّن أحد أكثر الظواهر البشرية تعقيدًا وتأثيرًا. فهو ليس مجرد طقوس وشعائر، بل نظام فكري وروحي يشكل هوية الأفراد والمجتمعات. ومع تغير العصور، وجد الإنسان نفسه في مواجهة تساؤلات جديدة حول مفهوم التديّن: هل هو ضرورة روحية أم أداة اجتماعية؟ هل التديّن ينبع من حاجة نفسية داخلية، أم أنه انعكاس للثقافة والبيئة؟
في عالم اليوم، حيث تُعاد صياغة القيم والمفاهيم، أصبح التديّن محل جدل واسع بين من يراه تجربة شخصية حرة، ومن يصر على التمسك بالنماذج التقليدية. مع ظهور النزعات الفردانية، وتأثير العولمة، وانتشار وسائل الاتصال الحديثة، أصبح الإنسان قادرًا على تكوين معتقده بعيدًا عن الأطر الدينية التقليدية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الدين نفسه.
يهدف هذا المقال إلى تحليل فلسفة التديّن من زوايا متعددة، محاولًا استكشاف العوامل التي تشكل العلاقة بين الإنسان والله في عصر التحولات الجذرية.

الصلاة في الكعبة
- التديّن بين الفطرة والتنشئة – هل يولد الإنسان متديّنا؟
-هل التديّن فطري أم مكتسب؟ منذ الأزل، لطالما تساءل الإنسان عن حقيقة وجوده وعن القوى التي تحكم هذا الكون، ومن هنا نشأت فكرة الدين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل التديّن جزء من الطبيعة البشرية، أم أنه نتاج تربية مجتمعية؟
-التديّن كفطرة إنسانية. تذهب العديد من الأديان والفلسفات إلى القول بأن التديّن متأصل في الطبيعة البشرية. ففي الإسلام، نجد الحديث النبوي: “كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.” هذا يعني أن الإنسان يولد وفي داخله استعداد طبيعي للإيمان، لكنه يتشكل وفق البيئة التي ينشأ فيها.
علم النفس الحديث يدعم هذه الفكرة إلى حد ما، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن للإنسان ميلاً فطري للإيمان بوجود قوة عليا. عالم النفس غاستن باريت في كتابه Born Believers يُجادل بأن عقول الأطفال مهيأة بشكل طبيعي لتقبل فكرة وجود إله، وأنهم يميلون بشكل غريزي إلى رؤية العالم على أنه مخلوق من قبل كائن واعٍ.
–التديّن كناتج للتنشئة الاجتماعية. على الجانب الآخر، يرى بعض الفلاسفة وعلماء الاجتماع أن التديّن ليس فطريًا، بل هو سلوك مكتسب يفرضه المجتمع على الأفراد. عالم الاجتماع إميل دوركهايم يرى أن الدين مؤسسة اجتماعية تهدف إلى تنظيم حياة الأفراد، وليس حقيقة فطرية.
الدليل على هذا الطرح هو أن التنوع الديني الهائل عبر الثقافات يعكس تأثير التنشئة أكثر من كونه ناتجًا عن فطرة ثابتة. لماذا نجد أن طفلًا ولد في السعودية مسلمًا بينما طفلًا ولد في الهند هندوسيًا؟ إذا كان التديّن فطريًا، فلماذا يختلف شكله من مجتمع لآخر؟
–النتيجة: بين الفطرة والتنشئة. يبدو أن التديّن خليط معقد من الفطرة والتنشئة. قد يكون لدى الإنسان ميل طبيعي للبحث عن معنى لوجوده، لكن الشكل الذي يأخذه هذا البحث يتحدد، إلى حد كبير، عبر العوامل الثقافية والاجتماعية.

2. العقل والإيمان – هل الإيمان تجربة عقلية أم روحية؟
–العلاقة بين العقل والدين عبر التاريخ. منذ العصور القديمة، دار جدل واسع بين الفلاسفة ورجال الدين حول طبيعة الإيمان: هل هو تجربة عقلية يمكن إثباتها بالمنطق، أم أنه حالة روحية لا تخضع للعقل؟
–الطرح العقلاني: الدين والإيمان كعملية عقلية. الفلاسفة العقلانيون مثل أرسطو، ابن رشد، وديكارت حاولوا التوفيق بين الدين والعقل. ابن رشد مثلًا قال إن “الحقيقة الدينية لا تتناقض مع الحقيقة العقلية“، ورأى أن العقل يمكنه الوصول إلى المعرفة الدينية من خلال الفهم المنطقي.
الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط اعتبر أن الإيمان يجب أن يكون قائمًا على الأخلاق وليس على الأدلة الحسية، وأن التديّن يجب أن يكون مدفوعًا بضرورات عقلية لا مجرد تقاليد موروثة.
-الطرح الوجودي: الإيمان كقفزة في المجهول. في مقابل هذا الطرح، جاء الفيلسوف الدنماركي سورين كيركغارد ليؤكّد أن الإيمان لا يمكن أن يكون عقلانيًا بالكامل، بل هو “قفزة في المجهول“.
الفيلسوف جان بول سارتر رأى أن الإنسان مسؤول عن مصيره، وأن الإيمان قد يكون طريقة للهروب من الحرية وتحمّل المسؤولية عن أفعاله.
–بين العقل والروح: هل يمكن الجمع بينهما؟ في النهاية، يبدو أن العقل وحده لا يمكنه تفسير الدين بشكل كامل، كما أن الإيمان بدون أي أساس منطقي قد يصبح مجرّد تقليد أعمى. ربما يكون الطريق إلى الله هو مزيج من العقل والروح، بحيث يكون الإيمان مستندًا إلى قناعة داخلية وليس مجرّد فرض اجتماعي.

- تديّن المجتمعات الحديثة – بين الدين التقليدي والدين الفردي
–التديّن في عصر العولمة. مع تزايد العولمة وانتشار وسائل الاتصال، تغيرت نظرة الإنسان إلى التديّن بشكل كبير. لم يعد الدين مرتبطًا فقط بالمؤسسات الدينية، بل أصبح تجربة فردية يختارها الإنسان وفق قناعاته الشخصية.
- أصبح بإمكان أي شخص أن يقرأ عن الأديان المختلفة ويختار ما يناسبه.
- تراجع دور رجال الدين التقليديين أمام المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تقدّم تفسيرات مختلفة للدين.
- هناك توجه متزايد نحو “التديّن الفردي“، حيث يختار الإنسان ممارساته الدينية بناءً على قناعته الشخصية بدلًا من الالتزام الأعمى بالتقاليد.
- التديّن والاستهلاك : هل أصبح الدين منتجًا في السوق العالمية؟
في العصر الحديث، تحوّل الدين إلى صناعة استهلاكية في كثير من الجوانب.
- انتشار المنتجات الدينية (كتب، موسيقى، أفلام دينية).
- ظهور “سياحة دينية“، حيث يتّم استغلال المقرّات الدينية والعمرة تجاريًا.
- تسويق الدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح بعض رجال الدين شخصيات مؤثرة تقدّم محتوى دينيًا بأسلوب تجاري.
هذا يطرح سؤالًا: هل الاستهلاك يؤثر على جوهر التديّن؟ وهل يمكن أن يتحول الدين إلى مجرّد منتج في السوق؟

- مستقبل التديّن: هل نحن أمام دين جديد أم عودة للأصل؟
مع تصاعد الفكر النقدي، يبدو أن التديّن التقليدي يمّر بأزمة، فهناك من يدعو إلى إصلاح ديني، وهناك من يرى أن الحل يكمن في العودة إلى الأصول.
- هل سيظل الدين بشكله التقليدي، أم أنه سيأخذ أشكالًا جديدة تناسب العصر؟
- هل يمكن أن يظهر “دين جديد” يلبّي احتياجات الإنسان الحديث؟
- هل يمكن أن يكون الحل في العودة إلى الروحانية بدلًا من التديّن المؤسسي؟
- الخاتمة
التديّن ليس ظاهرة ثابتة، بل هو تجربة متغيرة تتشكل وفق الزمن والبيئة. في عالم اليوم، حيث تتغير القيم والأفكار بسرعة، يصبح السؤال الأساسي: كيف يمكن للإنسان أن يجد طريقه إلى الله في عالم مليء بالضجيج والتيارات المتناقضة؟
هل الحل في العودة إلى الأديان التقليدية، أم في البحث عن تجربة إيمانية شخصية أكثر تحررًا؟ الطريق إلى الله يظّل رحلة خاصة يعيشها كل إنسان بطريقته، بين العقل والروح، بين الإيمان والشك، في عالم متحوّل لا يتوقف عن التغيير.