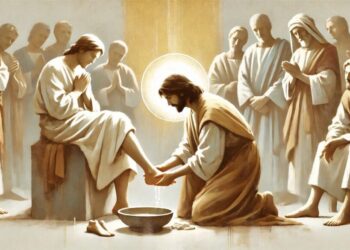طواحين الهواء عديدة في لبنان
د. الياس ميشال الشويري
رواية دون كيشوت للكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس تُعدّ نقطة تحول مفصلية في تاريخ الأدب العالمي، إذ يُجمع العديد من النقّاد على أنها أول رواية حديثة بحق. ومنذ صدورها عام 1615، ما زالت هذه الرواية تشكّل مرجعية أدبية وفكرية لما تحمله من تعقيدات فلسفية وإنسانية، تتعلّق بالحلم والوهم، والعدالة والمثالية، والحقيقة والواقع. تروي الرواية مغامرات رجل نبيل بسيط يدعى ألونسو كيخانو، يقرّر أن يصبح فارساً ويطلق على نفسه اسم “دون كيشوت“، متأثراً بروايات الفروسية القديمة. ينطلق في مغامراته لقتال الظلم، لكنه يصطدم بواقع لا يفهمه، فيحارب طواحين الهواء ظنًّا منه أنها وحوش شريرة.
هذه الرواية ليست مجرّد قصة ساخرة، بل وثيقة تحليلية للنفس البشرية حين تنفصل عن الواقع وتتقوقع في تصوراتها المثالية. في السياق اللبناني، تتكرّر ملامح هذا الانفصال بين المثال والواقع، حيث يعيش اللبنانيون صراعاً دائماً بين طموحاتهم وصورة وطنهم في مخيلتهم من جهة، وبين انهيار الأنظمة والمؤسسات من جهة أخرى. يسعى هذا المقال إلى قراءة رواية دون كيشوت كمرآة تعكس الحالة اللبنانية المعاصرة على المستويات السياسية، الاجتماعية، الثقافية والنفسية، وذلك من خلال تحليل المحاور المركزية للرواية وربطها بمكونات الواقع اللبناني، بشكل أكاديمي موسع.
- الصراع بين الحلم والواقع
الحبكة الرئيسية لرواية دون كيشوت تتلخّص في رغبة ألونسو كيخانو في أن يصبح فارساً نبيلاً على غرار أبطال القصص التي أحبها. في محاولة لإحياء قيم الفروسية التي فقدها الزمان، يلبس درعه البالي، ويركب جواداً هزيلاً، ويعلن الحرب على الشر. المشكلة الأساسية في دون كيشوت ليست في أخلاقه أو نيّاته، بل في انفصاله التام عن الواقع. إنه لا يرى الأشياء كما هي، بل كما يتخيلها، فيعيش في عالم من الرموز والصور التي لا تجد لها وجوداً مادياً.
الرواية بذلك تطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى قابلية الإنسان للحلم في عالم يرفض المثال. هل يمكن أن يعيش الإنسان مخلصاً لقيمه، حتى إن اصطدمت بكل ما هو واقعي؟ وهل المثالية، عندما تتحرّر من المعقول، تصبح خطراً على الفرد والمجتمع؟ دون كيشوت ليس مجنوناً بقدر ما هو ضحية لتصور مثالي لم يعد له مكان. انفصاله عن الواقع يحوّله إلى رمز للتمسك المطلق بالخيال.
الواقع اللبناني المعاصر يقدّم مثالاً حياً على هذا التوتّر الدائم بين الحلم والواقع. فالكثير من اللبنانيين ما زالوا يحملون في ذاكرتهم صورة لوطن متقدّم، منفتح، مبدع، ومتعدّد. هذه الصورة المتخيلة تصطدم يومياً بالانهيار الاقتصادي، الفساد السياسي، وتردّي الخدمات الأساسية. يعيش المواطن في لبنان مأساة مشابهة، إذ يجد نفسه ممزقاً بين ما يتمنّى أن يكون عليه وطنه، وبين ما يفرضه الواقع عليه.
المفارقة المأساوية أن الحلم نفسه قد يتحوّل إلى عبء حين لا يجد أرضاً حقيقية ليترسّخ فيها. فكما أصيب دون كيشوت بالإحباط حين تكررت خيباته، يشعر اللبناني بالإرهاق والمرارة عندما يواجه الحقيقة المؤلمة: أن ما يحارب من أجله قد لا يكون موجوداً أصلاً. إلا أن ما يميّز هذه التجربة هو أن الحلم لا يموت، بل يتحوّل إلى وسيلة مقاومة وإن كانت رمزية.
- ثنائية دون كيشوت وسانشو بانزا والمشهد الثقافي اللبناني
علاقة دون كيشوت بتابعه سانشو بانزا تمثّل تجسيداً فريداً للصراع بين الفكر والممارسة، بين الخيال والواقعية. الأول يحلّق في فضاءات المثاليات، يرى في كل شيء رمزاً وهدفاً، بينما الثاني يتعامل مع الواقع بحذر وبراغماتية وحتى بسخرية. هذه العلاقة الجدلية بين الشخصية المركزية ومرافقها تعكس انقساماً فكرياً واجتماعياً يتكرّر في مجتمعات كثيرة، ومنها لبنان.
دون كيشوت، في تمسكه بالأخلاق النبيلة، يتحوّل إلى شخصية مأساوية تنكر الواقع وتُصرّ على تغييره بالقوة الأخلاقية وحدها. في المقابل، سانشو بانزا يمثّل صوت المنطق الشعبي، الذي يدرك عبثية ما يحدث لكنه يستمر في الصحبة لأنه لا يملك بديلاً. في لبنان، يمكن إسقاط هذه الثنائية على النخبة الثقافية والفكرية: فبعض المثقفين يعيشون في برج عاجي من المثاليات، بينما آخرون يسخرون من كل محاولة للتغيير.
في الكثير من الأحيان، تتهم النخبة المثالية بعدم فهم الواقع اللبناني المركّب، وتُنتقد لعدم تقديمها حلولاً عملية. بالمقابل، يُنتقد الواقعيون لفقدانهم الحماسة والعزيمة، واستسلامهم للمنظومة القائمة. هذا التوتر بين الحالم والعاقل يتكرّر في الساحات الفكرية والإعلامية اللبنانية، ممّا يعكس عجزاً عن التلاقي حول تصوّر موحّد للتغيير.
ما يجعل هذه الثنائية أكثر عمقاً في لبنان هو أن كل طرف من الأطراف يجد في ذاته امتداداً لمظلومية ما: المثالي يشعر أنه يحمل لواء العدالة المسلوبة، بينما الواقعي يعتبر أن تجربته أثبتت أن الحلم مستحيل. ومن هنا، تتحوّل الساحة الثقافية إلى ميدان للجدل، لا للاتفاق، يشبه تماماً التباين بين دون كيشوت وسانشو في رؤيتهما للعالم.
الرواية، بذلك، لا تُقدّم حلاً بل تفتح المجال للتفكير في جدوى كل من الموقفين. هل الأفضل أن نعيش في خيال مثالي يُعزّز الكرامة ولو اصطدم بالواقع؟ أم أن البراغماتية، رغم قسوتها، هي الضمان الوحيد للبقاء؟ لبنان لا يزال يبحث عن جواب.
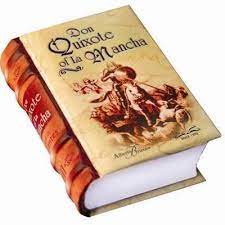
- الطائفية اللبنانية كطاحونة هواء دائمة
مشهد دون كيشوت وهو يهاجم طواحين الهواء أصبح رمزاً عالمياً للمعارك الوهمية. لقد اعتقد بطل الرواية أن تلك الطواحين وحوش شريرة تهدّد الأبرياء، فهبّ لقتالها بشجاعة، دون أن يدرك أنها ليست سوى آلات لطحن الحبوب. هذا الوهم ليس جهلاً تقنياً فحسب، بل تعبير عن إصرار الإنسان على قراءة الواقع بعينَيْه الخاصتَيْن، لا كما هو فعلاً.
في لبنان، الطائفية تمثّل طاحون الهواء الأكبر. هي آلة متجذرة في بنية الدولة والمجتمع، وتبدو للبعض كأنها قَدَرٌ لا يمكن تجاوزه. وعلى الرغم من وعي شرائح واسعة من الشعب بخطورة الطائفية، إلا أن الخطابات الطائفية لا تزال تستعمل كوسيلة للحشد، وكأداة لتحريك الغرائز الجماعية في أوقات الأزمات.
غالباً ما تنطلق الحراكات السياسية والمدنية في لبنان من نيات حسنة، وتحمل شعارات وطنية جامعة. غير أن هذه الحِراكات ما تلبث أن تُخترق وتُفتّت على أساس طائفي. كل محاولة لتجاوز الانقسام الطائفي تُقابل برد فعل يعيد إنتاجه بصورة جديدة. وهكذا، تتحوّل محاربة الطائفية إلى تكرار مأساوي لمشهد دون كيشوت مع طواحين الهواء.
أسوأ ما في الطائفية أنها تقدّم نفسها على أنها حماية، تماماً كما رأى دون كيشوت نفسه بطلاً لا مجنوناً. كل طائفة ترى في زعيمها درعاً وفي الآخرين تهديداً. بذلك، تُغلّف الطائفية نفسها بخطاب البطولة والحماية، ما يجعل من الصعب تفكيكها دون أن يُفهم أنها آلة طحن للجميع.
الصراع ضد الطائفية يشبه إلى حد بعيد محاربة وحوش لا يمكن لمسها. ولذا، فإن النجاح لا يتحقّق بالمواجهة المباشرة وحدها، بل بإعادة بناء الوعي، وتفكيك الأساطير المحيطة بها، كما كان من الممكن لدون كيشوت أن ينجو من الوهم لو أن أحدهم علّمه كيف ينظر.
- الاقتصاد اللبناني والسراب المالي كمغامرة خيالية
أحد عناصر العبث في رواية دون كيشوت هو اعتقاد البطل أنه يستطيع استعادة العدالة وتغيير العالم باستخدام أدوات متقادمة. هذا الإصرار على النجاح رغم غياب الإمكانات الواقعية، يقابله في لبنان إصرار طويل على التمسّك بنموذج اقتصادي انهار فعلياً منذ عقود، لكنه استمر بسبب الوهم الجماعي.
الاقتصاد اللبناني قام على الريعية والمضاربات المالية، وتم تقديمه كمعجزة شرق أوسطية. لكن الواقع أنه كان اقتصاداً هشاً، خالياً من الإنتاج الحقيقي، ومعتمداً على التحويلات الخارجية والدَّين. كما أن القطاع المصرفي ضخّم صورة وهمية للثروة، مستنداً إلى هندسات مالية لم تكن سوى قنابل موقوتة.
انهارت هذه المنظومة في 2019، وانكشف للجميع أن الازدهار لم يكن سوى سراب. انهارت العملة، وتبخرت المدخرات، وتحوّل الحلم إلى كابوس. اللبناني الذي وثق بالمصارف والنظام اكتشف أنه، مثل دون كيشوت، كان يحارب لحماية شيء غير موجود.
ما زاد من مرارة التجربة هو استمرار الخطاب الرسمي في الدفاع عن نموذج منهار. بدل الاعتراف بالفشل، لجأ السياسيون إلى تبرير ما حدث بمؤامرات خارجية أو ظروف قاهرة. تماماً كما كان دون كيشوت يجد تفسيرات جديدة لكل فشله، دون أن يتراجع عن قناعته الداخلية.
الدرس هنا أن الأوهام، حين تتحوّل إلى سياسة عامة، قد تكون أكثر خطراً من الأعداء الحقيقيين. والرواية، حين تُقرأ في هذا السياق، تبدو وكأنها نبوءة اقتصادية قبل أوانها.

- الأمل والشتات: الحلم اللبناني بين الاستمرار والانكسار
رغم كل الإخفاقات، لم يفقد دون كيشوت إيمانه بقضيته. كانت عزيمته أكبر من الواقع، وهو ما منحه بُعداً بطولياً وإنْ في إطار ساخر. هذا الإصرار على الحلم رغم المعرفة بالهزيمة يعطي الرواية طابعاً إنسانياً عميقاً، يجعل القارئ يتعاطف مع بطلها رغم سذاجته.
اللبناني أيضاً يرفض الاستسلام. ورغم الانهيارات السياسية والاقتصادية، لا يزال يتمسّك بالأمل، ولو من بعيد. تتجلّى هذه الروح في مظاهر الإبداع الفردي، والمبادرات الاجتماعية، ورفض الشباب للواقع عبر الهجرة أو المشاريع الخاصة أو المقاومة الثقافية.
غير أن هذا الأمل يحمل تناقضاً مأساوياً. فالكثير من الحالمين اضطروا إلى مغادرة البلاد، والشتات اللبناني صار أكبر من الوطن نفسه. كما أن الحلم الوطني لم يعد جماعياً كما كان، بل تحول إلى حلم فردي: الخلاص الشخصي، لا التغيير الجماعي.
وهكذا، يصبح اللبناني في المهجر مشابهاً لدون كيشوت في مغامراته الأخيرة: يؤمن بفكرة، لكنه يدرك أن العالم لم يعد يسمح بها. وبين الحنين والواقعية، يتشكّل وعي جديد أكثر نضجاً، لكنه أيضاً أكثر حزناً.
ربما يُلهمنا دون كيشوت لا لأننا نريد تقليده، بل لأننا نرى في سقوطه دعوة لتصحيح المسار. فالمثالية لا يجب أن تُلغى، لكنها تحتاج إلى عقل نقدي قادر على تمييز الطاحونة من الوحش.

- الخاتمة
رواية دون كيشوت ليست مجرّد عمل أدبي ساخر، بل مرآة معقدة لمصير الإنسان حين يصّر على الحلم في عالم لا يعترف بالأحلام. وفي لبنان، حيث تتداخل الطواحين الوهمية مع الوحوش الحقيقية، تصبح هذه الرواية درساً بليغاً في ضرورة الموازنة بين الإيمان والمراجعة. الحلم مشروع، بل ضروري، لكنه لا يُترجم إلا عبر فهم دقيق للواقع وآلياته. لا نريد إلغاء دون كيشوت فينا، بل نريد أن نعلّمه كيف يختار معاركه، وكيف يميّز بين الطاحونة والعدو.