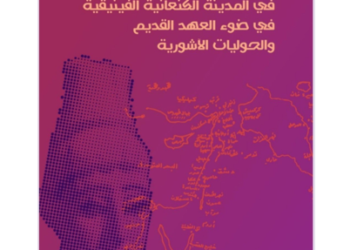مواجهة إضطرابات المهاجرين
د. الياس ميشال الشويري
في زمن الاضطرابات السياسية والانهيارات الاقتصادية، تهاجر جموع من الناس من بلدانها بحثًا عن الأمن، والكرامة، وفرص الحياة الكريمة، لتجد في دول أوروبا وغيرها من البلدان المتقدمة ملاذًا يحترم إنسانيتها ويمنحها ما حُرمت منه في أوطانها. غير أن المفارقة العجيبة تكمن في سلوك بعض هؤلاء المهاجرين، الذين سرعان ما ينقلبون على قوانين البلدان التي احتضنتهم، فيمارسون التمرد تحت غطاء الحرية، ويتصرفون وكأنهم في مواجهة أعداء لا مضيفين.
وفي الوقت الذي تُمنح فيه حرية التعبير والتدين والاحتجاج ضمن الأطر القانونية، يستخدمها البعض بشكل انتقائي، فيرفعون رايات التحدي التي لم يجرؤوا على رفعها في أوطانهم خوفًا من بطش السلطان أو السجن أو الموت. ويبلغ التناقض ذروته عندما نرى من يرتدي الحجاب أو النقاب في أوروبا كرمز للمقاومة أو الاستفزاز السياسي، بينما كان ليخلعه دون اعتراض لو أن دولة “إسلامية” فرضت عليه ذلك بالقمع.
في هذا المقال، سنناقش هذه الظاهرة المتشابكة بين الهروب من الاستبداد وممارسة الحرية بشكل فوضوي، وسنتناول كيف يمكن للمهاجر أن يكون عنصرًا بنّاءً لا عبئًا، عندما يدرك أن الاحترام المتبادل بينه وبين الدولة المضيفة ليس خيارًا، بل واجب أخلاقي وثقافي.
- واقع الهروب من الوطن والانتماء الشكلي
يغادر كثير من الأفراد بلدانهم الأصلية مدفوعين بعوامل القهر السياسي، والفساد الإداري، وانعدام الأمان الاقتصادي أو الأمني. وغالبًا ما يكون القرار بالخروج من الوطن قرارًا اضطراريًا لا يحمل في طياته خيارات حقيقية. يجد هؤلاء في أوروبا أو كندا أو أستراليا بيئة قانونية تضمن لهم حقوقًا لم يكونوا يحلمون بها. لكن المؤسف أن كثيرين منهم لا يتأملون جذور مأساتهم، ولا يسعون لفهم قيمة الانتقال من الظلم إلى العدل، بل يحتفظون بالذهنية القديمة نفسها التي كانت سببًا في سقوط أوطانهم.
ينتقل بعض المهاجرين بجسدهم إلى دول متقدمة، لكنّهم يتركون عقولهم معلقة في ماضٍ سقيمٍ، ويتنكرون لتاريخهم علنًا بينما يحملونه ضمنيًا في سلوكياتهم اليومية. من هنا تنشأ إشكالية الهوية والانتماء، حيث يعيش هؤلاء المهاجرون في المجتمع الأوروبي دون اندماج حقيقي، مكتفين بخطاب الضحية أو خطاب التمرد غير المدروس. هذا الانفصام يولّد مشاكل اجتماعية وثقافية قد تؤدي لاحقًا إلى التوتر مع المجتمع المضيف أو حتى مع أبناء الجالية أنفسهم.
تقدم الدول الغربية، ولا سيما الأوروبية منها، مظلة قانونية وإنسانية قلّ نظيرها في دول العالم الثالث. لكن بدل أن يكون هذا الامتياز حافزًا للانضباط والامتنان، يتحوّل أحيانًا إلى منبر لاستغلال الثغرات أو معارضة الأنظمة بذريعة “الحرية“. وهنا يظهر التناقض الواضح: فمن عاش عقودًا من القمع لا يحق له أن يعبث بحريات الآخرين في أوطانهم. على اللاجئ أن يعي أن اللجوء مسؤولية وليس بطاقة مفتوحة للفوضى.

- الاحتجاجات غير القانونية وازدواجية السلوك
تضمن الدول الغربية حرية التعبير والتظاهر، لكنها تشترط لذلك إجراءات قانونية محددة لا يُعفى منها حتى المواطن الأصلي. إلا أن بعض المهاجرين يتجاهلون هذا السياق، فينظمون مظاهرات عشوائية قد تعطّل السير أو تثير الشغب أو حتى تدعو للعنف أو لخطاب الكراهية. هذه الأفعال لا تعكس روح المطالب، بل تؤكد أن هناك فجوة أخلاقية وفكرية بين ما يطالب به هؤلاء وما يمارسونه فعليًا.
حين يُمارس الاحتجاج بأسلوب مخالف للقانون، يتحول من أداة حق إلى وسيلة ضغط فوضوي. كثير من المهاجرين لا يفهمون الفرق بين الدولة البوليسية التي هربوا منها والدولة القانونية التي آوتهم. فيستنسخون منطق الشارع العربي ويظنّون أن الضجيج هو من يفرض الحقوق. هذا الجهل العميق بطبيعة الأنظمة التي لجأوا إليها يُفقدهم المصداقية أمام المجتمعات المضيفة، ويجعلهم عرضة للعزل أو الطرد.
لو قامت اليوم دولة إسلامية ومنعت الحجاب عن النساء، فهل كانت النساء المهاجرات، ممن يتحدين القوانين الأوروبية باسم الحجاب أو النقاب، سيتجرأن على لبسه؟ الجواب غالبًا لا، لأن الخوف من السجن أو القتل كان سيكتم كل صوت. لكن في الدول الأوروبية، حيث الحريات مضمونة، يتم استخدام هذا الرمز أحيانًا كأداة سياسية لا دينية، وكأن التمرد على “الآخر الأوروبي” أولى من التمرد على “الظالم المحلي“. هذا التناقض يكشف أن ما يُمارَس أحيانًا ليس قناعة دينية، بل حالة من العناد الإيديولوجي، في بيئة تسمح به، بينما كان الخضوع هو سيد الموقف في أوطان القمع.
- المسؤولية الأخلاقية للمهاجر تجاه البلد المضيف
أن تمنحك دولة أجنبية فرصة الحياة الكريمة، والخدمات المجانية، والحق في التعبير والعمل، بعد أن طردك وطنك أو أهملك، هو أمر يجب أن يُقابل بالامتنان لا بالجحود. الامتنان لا يعني الصمت على الظلم، بل احترام القوانين أولًا، والعمل على تحسين المجتمع المضيف لا تقويضه. وهذه مسؤولية تبدأ من فهم قيم المواطنة وتنتهي بإثبات الجدارة بأن تكون فردًا صالحًا في منظومة عادلة.
حين يخالف مهاجر واحد القانون، فإنه لا يضر نفسه فقط، بل يساهم في ترسيخ صورة نمطية سلبية عن الجالية بأكملها. ويؤدي هذا لاحقًا إلى تضييق الخناق على البريئين، وإلى صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تتغذى على أخطاء كهذه. لذا فإن سلوك الفرد ينعكس على مصير الآلاف من أمثاله، ويشكل ضغطًا إضافيًا على الجاليات في كل المجالات: من التعليم إلى العمل إلى الإقامة.
الاندماج لا يعني الذوبان، بل يعني احترام قوانين البلد المضيف، والعمل وفق قيمه الدستورية، والسعي لبناء جسور التفاهم بين الثقافات. أما ما نراه أحيانًا من محاولات خلق “جزر ثقافية” مغلقة داخل المدن الأوروبية، أو فرض أعراف الوطن القديم على المجتمع الجديد، فذلك أشبه باستعمار معكوس لا يقل خطورة عن أي غزو ثقافي. فإما أن نكون ضيوفًا نبلاء، أو عبئًا يُنبذ عاجلًا أم آجلًا.

- الخاتمة
إن ما تقدمه الدول الأوروبية للمهاجرين هو من أعظم نماذج الكرم الإنساني المعاصر، لكن على المهاجر أن يقدّر هذا الكرم لا أن يسخره للعناد والعصيان. بين الهروب من الاستبداد والاحتماء بالقانون مساحة أخلاقية يجب أن تملأ بالوعي، لا بالغوغاء. المجتمعات لا تُبنى بالشعارات، بل بالاحترام، بالانضباط، وبالاعتراف أن الحقوق يقابلها واجبات. فإما أن نكون أصحاب رسالة، أو نعيد إنتاج بؤس أوطاننا في منفى نقيّ لا ذنب له بنا.