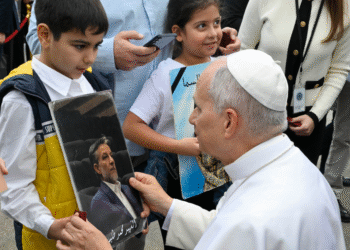قطع الطرقات بالاطارات المشتعلة..ماذا نسميه؟
د. الياس ميشال الشويري
في مقولته الشهيرة الذي تحمل العنوان الاستفهامي اللاذع “الله خلقك انسان ليش مصر عالحَيْونة” (من حيوان)، يفتح الفنّان الراحل زياد الرحباني بابًا واسعًا للتأمل في طبيعة الإنسان ومسار انحداره الأخلاقي والاجتماعي. السؤال في عمقه ليس مجرد صياغة ساخرة، بل هو إدانة لواقع يصرّ فيه الإنسان على أن يتخلّى عن أعظم ما مُنح: العقل، الضمير والحرية. يطرح الرحباني إشكالية تبدو كأنها أزلية: لماذا يتنازل الإنسان عن إنسانيته ليعيش وفق الغرائز العمياء؟ هذا السؤال، حين يُقرأ في سياق لبنان الغارق في تناقضات الطائفية والغوغائية والفساد، يتحوّل إلى مرآة تكشف العجز الجماعي عن النهوض إلى مستوى الإنسانية التي أرادها الله. في هذا البحث الموسّع سنسعى إلى تفكيك هذه الإشكالية عبر ثلاثة محاور رئيسية: البعد اللاهوتي والفلسفي، البعد النفسي والاجتماعي، ثم البعد السياسي والثقافي. في كل محور سنقدّم توسعًا أكبر يربط بين المفهوم النظري والتطبيق اللبناني، لنكشف كيف تتجسّد “الحيّونة” في تفاصيل الحياة اليومية، وكيف تصبح الغوغائية أداة سياسية واجتماعية تشرعن هذا الانحدار.
- البُعد اللاهوتي والفلسفي — إنسان مخلوق على صورة كمال ودعوة إلى الحرية
السؤال الذي صاغه الرحباني يتجاوز الطابع البلاغي ليحمل حمولة لاهوتية عميقة. النصوص الدينية التوحيدية تجمع على أن الإنسان خُلق على صورة الله ومثاله، أي عاقلاً حرًا قادرًا على التمييز بين الخير والشر. هذه المكانة تمنحه تكريمًا خاصًا بين الكائنات. لكن إصراره على الانحدار نحو الحيوانية يشكّل خيانة لهذه العطية. هنا يظهر البعد اللاهوتي للسؤال: لماذا يصرّ الإنسان على نقض الغاية من خلقه؟ أليست غايته أن يكون خليفةً في الأرض، معمّرًا لها بالعدل والرحمة، لا أن يتحوّل إلى أداة شهوة أو عدوان؟ في السياق اللبناني، يمكننا أن نرى هذا الانحدار في استسلام الأفراد للزعامات الطائفية، ورضوخهم للأوامر العمياء كأنهم قطعان لا بشر. بهذا المعنى يصبح السؤال عن “الحيّونة” سؤالاً عن فقدان المعنى الروحي، وتحوّل الدين من دعوة إلى الحرية إلى قناعٍ لتبرير الانحطاط.
الفلسفة الأخلاقية عبر العصور ناقشت مسألة سقوط الإنسان. في الفكر الإغريقي، كان العقل يُعتبر أداة ضبط الغرائز، بينما في الفكر المسيحي والإسلامي اعتُبر الضمير هبة إلهية لضبط النفس. الفلاسفة المحدثون مثل “كانط” رأوا أن الكرامة الإنسانية تنبع من قدرة الإنسان على أن يكون غاية في ذاته لا وسيلة. ومع ذلك، نجد الإنسان المعاصر يختار أن يكون وسيلة، سواء لمصلحته الضيقة أو لمصلحة الزعيم. هذا ما يسميه الرحباني “الحيّونة”: أن يتنازل المرء طوعًا عن إنسانيته ليتصرّف كالبهيمة، مطاردًا شهوة، خاضعًا لعصبية. في لبنان، يبرز هذا السلوك في مشاهد الانتخابات حيث يبيع الناخب صوته مقابل فتات، متخليًا عن دوره كمواطن عاقل حر. هنا يصبح السقوط فعلًا واعيًا لا قدريًا، وتغدو الفلسفة الأخلاقية أداة إدانة لا مجرد تنظير.
إذا كان الإنسان مخلوقًا حرًا، فإن الحرية لا تعني الانغماس في الغرائز، بل مسؤولية ثقيلة. الحرية الحقيقية مشروطة بالعقل والضمير. من دون هذه الموازين تتحول الحرية إلى فوضى، والفوضى إلى حيوانية. الرحباني يضع إصبعه على هذا الجرح: نحن في مجتمعاتنا لا نفهم الحرية كمسؤولية، بل نمارسها كغوغائية. اللبناني الذي ينزل إلى الشارع ليقطع طريق الناس باسم الاحتجاج، أو ليهتف لزعيمه بلا تفكير، يمارس حرية شكلية لكنها في جوهرها سقوط في الحيّونة. فالحرية إن لم تُضبط بالضمير تتحول إلى غوغائية تضرّ بالجميع. هنا يتجلّى البعد الفلسفي: الإنسان مدعو ليكون أكثر من كائن بيولوجي، لكنه يصرّ على العكس.

- البعد النفسي والاجتماعي — من الأنا الفردية إلى الجماعات المتوحشة
التحليل النفسي يكشف كيف تتكوّن أنماط السلوك الحيواني في الفرد. حين ينشأ الطفل في بيئة يسودها الحرمان، التسلّط، أو غياب التربية القيمية، ينمو مع شعور عميق بالنقص. هذا النقص يترجم لاحقًا في سلوكيات عدوانية، أنانية، وانتهازية. الإنسان الذي لم يتعلّم احترام الآخر يراوده شعور دائم بأن البقاء للأقوى، فيمارس عدوانيته كما لو كانت طبيعة لا اختيارًا. في لبنان، حيث المدرسة ضعيفة، والدولة غائبة، والعائلة مثقلة بالضغوط، يكبر الفرد متصالحًا مع فكرة أن الغش وسيلة ذكية، وأن الخداع مهارة ناجحة. بهذا يصبح السلوك الحيواني ليس انحرافًا فرديًا فحسب، بل نتيجة لتنشئة اجتماعية مريضة تُعيد إنتاج الحيّونة جيلًا بعد جيل.
عندما يجتمع الأفراد الذين تشرّبوا هذه السلوكيات في جماعة، يتحول الانحراف الفردي إلى غوغائية جماعية. هنا يُفقد العقل تمامًا، إذ يذوب الفرد في الحشد. الغوغاء في لبنان أمثلة حيّة: جمهور الأحزاب الذي ينقضّ على معارضيه بالشتم والتهديد، حشود الطوائف التي تحتفل بجرائم زعمائها، جماهير الملاعب التي تتحوّل مبارياتهم إلى ساحات قتال. هذا السلوك الغوغائي يعكس كيف تتحوّل الحيّونة الفردية إلى مرض اجتماعي. والأنكى أن الغوغائية تُبرّر دائمًا بشعارات: الدفاع عن الطائفة، عن الوطن، عن الزعيم. لكن حقيقتها أنها انحدار جماعي يسلب الإنسان عقله وحريته، فيصبح ذرة في قطيع لا يرى ولا يسمع إلا ما يريد له الراعي.

الإنسان الحيواني لا يكتفي بممارسة انحطاطه، بل يبحث عن تبرير عقلي له. هنا يأتي دور الإيديولوجيا: تُقدَّم “الحيّونة” على أنها بطولة أو وفاء أو شجاعة. في لبنان مثلًا، يُقدَّم الولاء الأعمى للزعيم على أنه قمة الرجولة والشرف. تُقدَّم الشتيمة على أنها صراحة، والعنف على أنه رجولة. هذه الآليات تجعل من الحيوانية قيمة اجتماعية معترفًا بها، بل ومطلوبة للاندماج في الجماعة. الرحباني بذكائه الساخر يفضح هذا المنطق، كاشفًا أن ما يُسمّى بطولة هو في الحقيقة غوغائية عمياء، وما يُسمّى وفاءً هو عبودية. هذه التبريرات تضمن استمرار الحيّونة، لأنها تحوّلها من عار فردي إلى نظام جماعي معترف به ومكافأ عليه.
- البُعد السياسي والثقافي — الحيّونة كأداة تحكّم وربح
في السياق السياسي، تصبح الحيّونة أداة مقصودة. الأنظمة والسلطات الفاسدة لا تريد مواطنين أحرارًا، بل جماهير غوغائية يمكن تحريكها. في لبنان، الزعامات الطائفية استثمرت لعقود في تغذية الانقسام والعصبية، لتبقى قادرة على حشد الجماهير متى شاءت. هنا تُكافأ الحيّونة: المواطن الذي يصفّق للزعيم يُمنح وظيفة، والذي يهتف في المهرجانات يُمنح منحة، والذي يقطع الطرقات لأجل حزبه يُمنح الحماية. هذه الشبكة من المكافآت تجعل الانحطاط الأخلاقي وسيلة بقاء، وتحوّل الحيّونة إلى اقتصاد سياسي كامل. الرحباني بكلماته يفضح هذه الصفقة: الإنسان يتنازل عن إنسانيته مقابل فتات، والسلطة تشتري الغوغاء بأرخص الأثمان.
الإعلام والثقافة الشعبية يلعبان دورًا مركزيًا في ترسيخ هذا الواقع. الإعلام المأجور يضخ خطابات الكراهية والعداء، ويحوّل الزعيم إلى أيقونة مقدّسة، ويشرعن سلوك الغوغاء باعتباره بطولة. البرامج التلفزيونية تستضيف أشخاصًا يصرخون ويشتمون أكثر مما يتحاورون، فتغدو الغوغائية مادة ترفيهية. في الثقافة الشعبية، تُغنّى الأغاني التي تمجّد السلاح والطائفية والزعامة، ويُحتفى بمن يجرؤ على الشتيمة أكثر من الذي يقدّم فكرًا. هذا الجو الثقافي يجعل من “الحيّونة” سلوكًا طبيعيًا. الرحباني كان من القلائل الذين حاولوا مقاومة هذا التيار عبر المسرح والموسيقى، فحوّل الفن إلى ساحة فضح وتعرية، كاشفًا أن ما يبدو تسلية هو في الحقيقة تكريس للانحدار.
إذا كانت السلطة والإعلام والثقافة تكرّس “الحيّونة”، فإن المقاومة تقتضي بناء بدائل. هنا يأتي دور التربية النقدية التي تعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يطيع، ودور المؤسسات المدنية التي تحمي الفرد من ضغط القطيع، ودور الفن المستقل الذي يعيد للغة بُعدها الإنساني. في لبنان، هذا يعني إعادة الاعتبار للتعليم الرسمي، تقوية القضاء المستقل، بناء إعلام حرّ، وتشجيع الفنون التي تفضح الانحطاط بدل أن تطبّعه. الرحباني نفسه جسّد مثال الفنان المقاوم، الذي لا يساوم ولا يزيّن الواقع، بل يقدّم مرآة صادمة. هذه المقاومة الثقافية والسياسية ضرورية لأن من دونها ستستمر الحيّونة كقاعدة، والغوغائية كأداة سيطرة، وسيبقى اللبناني غارقًا في تناقض أن يكون إنسانًا مُكرّمًا من الله لكنه يعيش كالبهيمة.

- الخاتمة
سؤال زياد الرحباني “الله خلقك انسان ليش مصر عالحيونة” هو سؤال وجودي وأخلاقي وسياسي في آن. إنه يضعنا أمام تناقض بين نعمة الخلق وواقع الانحدار، بين العقل والضمير من جهة، والغوغائية الحيوانية من جهة أخرى. في لبنان، يتخذ هذا التناقض شكلًا صارخًا: مجتمع يدّعي الإيمان والديمقراطية، لكنه يمارس العبودية للزعماء والانغماس في الغرائز. مواجهة هذا الواقع تتطلب مشروعًا حضاريًا شاملًا: تربية نقدية، مؤسسات عادلة، إعلام حر، وفن ملتزم. الرحباني لم يطرح السؤال ليُجيب عنه، بل ليُحرّك فينا قلق الضمير. إذا لم نتحرك لنُعيد للإنسان معناه، سنبقى مصرّين على الحيّونة، خائنين لغاية الخلق، وعاجزين عن بناء مجتمع يستحق أن يُسمّى إنسانيًا.