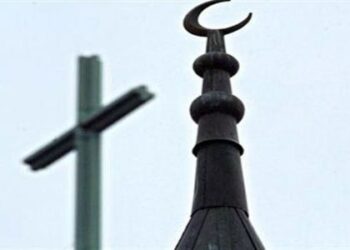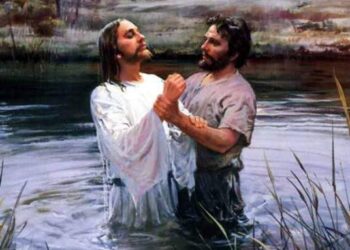المحكمة عندما تنطق باسم العدالة
د. الياس ميشال الشويري
تُرفع هذه الكلمات تحيّة وفاء وإجلال إلى قامة قضائيّة اتّخذت من الحقّ ميزانًا ومن سيادة القانون طريقًا، فقاربت العدالة على أنّها خدمة عامّة لا مجرّد وظيفة، ورسالة شجاعة لا مجرّد إجراءات، وإنسانيّة راعية لا مجرّد نصوص جامدة. إنّ سيرة القاضي برنار ميشال الشويري، بما حملته من صرامةٍ في المبدأ ورحابةٍ في الفهم ودقّةٍ في الحُكم، تُعيد إلى الأذهان صورة القاضي الذي يَسكنه الوطن قبل أن تسكنه القاعات، ويقوده الضمير قبل أن تُقيّده العادة. وما بين غرفة المذاكرة ومنصّة النطق بالأحكام، ظلّ ينسج للعدالة وجهًا يليق بالناس: وجهًا يساوي بينهم، يُنصِف الضعيف، ويضع للحُكم لُطفه وللقانون هيبته. هنا، لا نتتبّع سيرةً زمنيةً بقدر ما نقرأ أثرًا أخلاقيًا ووطنيًا تركه القاضي الشويري في نفوس المتقاضين وزملائه وأجيال القانون، أثرًا يذكّر بأن الجنوب الذي حمل ثقل الحرب والحرمان يستحق قضاءً يَسنده، وأنّ النبطية التي عرفت طريق الجراح عرفت أيضًا طريق الحقوق حين جلس على منصّتها قضاةٌ من طينته. هي تحيّةٌ للنهج قبل اللقب، وللمعنى قبل العنوان، وللقيمة التي لا تُقاس بعدد الملفات المغلقة بل بعدد الضمائر المطمئنة إلى أنّ في لبنان قضاءً يُشبه العدل.
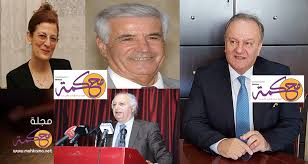
- معنى القضاء بين النصّ والضمير في تجربة القاضي الشويري
حين نبحث في الوهج الذي يُضفيه قاضٍ على منصّته، لا نعثر على سرّه في البلاغة اللفظية ولا في هندسة العبارة فحسب، بل في ذلك التوازن الدقيق بين ما يقوله النصّ وما يمليه الضمير، بين ما يقتضيه حرف القانون وما تتطلّبه كرامة الإنسان، بين صرامة القاعدة ومرونة الفهم التي لا تهدر المبدأ ولا تُقصي العدالة عن مقاصدها العليا. هكذا أتى حضور القاضي الشويري في وجدان من عرفه، حضورًا يُعيد إلى القضاء طبيعته الأصلية كسلطةٍ مُستقلّة تتقوّت بالمعرفة وتتقوّى بالاستقلال، فلا تَخضع لسطوة الضجيج ولا تَطلب ودّ الجمهور، بل تقف حيث ينبغي أن يقف العدل وإن خلا المكان من التصفيق. لم يكن يقيس نجاحه بعدد الجلسات المنجزة ولا بسرعة المحاضر الموقّعة، بل بقدرة الحكم على أن يُعيد الثقة إلى المتقاضي، وأن يشرح للناس أنّ القانون ليس عصًا بل ميزان، وليس قيدًا بل ضمانة، وليس تعقيدًا بل نظامًا يحميهم من المزاج والهوى. ومن هذا المعنى وُلدت مدرسةٌ صغيرة داخل القاعة، تُعلّم أن القاضي لا يُختصر بثوبه الأسود، وأن توقيعه على الحُكم إنّما هو توقيعٌ على عهده الأوّل أمام الله والضمير والوطن بأنّ العدالة أمانةٌ تُحمل لا لِتُحمّل.
لم يكن الحياد عند القاضي الشويري انسحابًا من الحياة ولا ادّعاءً باللاموقف، بل كان شجاعة اتخاذ الموقف الذي يفرضه القانون ولو خالف مصلحة الأقوياء، وكان قدرة على الإصغاء الكامل لادعاءات الخصوم ولو غلب عليهم الوجع أو طغت على أقوالهم الانفعالات، وكان مهارة تحويل القاعة من ساحة خصام إلى مجالٍ مُنظّمٍ لعرض الحجج وامتحان البيّنات وتفكيك الوقائع من دون إجحافٍ أو تسرّع. ومثلما يُنقّي الباحث فرضيّته من شوائب التحيّز، كان يُنقّي قراره من شوائب الظنّ ويعيد تركيب الملفّ بإتقانٍ يَصون الحقوق، فلا يُغيّبه عن عينه إلا يقينٌ يستند إلى دليل، ولا يُثقِل كاهل أحدٍ بحكمٍ ما لم يَطمئن إلى أنّ الموازين استقامت وأنّ باب الشكّ قد أُغلق على نحوٍ مُقنع. بهذا الفهم، أراد للقضاء أن يكون علمًا في المنهجيّة، وفنًّا في الصياغة، وفروسيةً في الاستقلال، وأن يكون الحُكم نصًّا مُحكَمًا شديد الوضوح بحيث يقرأه المتقاضي، فيرى عدالته قبل أن يُسلّم بنتيجته، ويقرأه أهل القانون، فيجدوا فيه اجتهادًا يُغني المدونة ويُثري الممارسة، وتقرأه الأجيال، فتتعلّم أنّ النزاهة ليست شعارًا يُرفع، بل تدريبٌ يوميّ على مقاومة الضغوط وحراسة الحقيقة مهما تنكّرت.
في تلك المسافة الفاصلة بين القاعدة القانونية وواقع الناس، كان القاضي الشويري يبني جسرًا لا يَتخلخل، جسرًا من لغةٍ نظيفةٍ تُزيل غموض النصوص، ومن عقلٍ مُنظَّمٍ يُحسن ترتيب الأدلّة، ومن قلبٍ واعٍ لا يسمح للشفقة بأن تقلب الموازين ولا للقسوة بأن تُطفئ روح العدالة، فيلتقي الحقّ مع الرحمة من غير تمييع، وتلتقي المساواة مع الفروق الفردية من غير محاباة، وتلتقي المصلحة العامّة مع حقوق الأفراد من غير افتئات. وفي هذا كلّه، ظلّ يؤمن أنّ هيبة القضاء لا تُستدرّ بالاستعراض ولا تُكتسب بالعُلوّ على الناس، بل تُبنى من صرامةٍ رصينةٍ وأدبٍ رفيعٍ ونظافة يدٍ لا تُساءل، وأنّ الحكم الذي يخرج من غرفة المداولة إنّما يخرج ومعه توقيعٌ غير مرئيّ من ضمير القاضي على سلامة المسار ونقاء الفكرة وعدالة النتيجة. لذلك بقيت سيرته في العيون ذكرى درسٍ طويلٍ لا تُدرّسه القوانين وحدها، بل تُدرّسه الحياة حين تُسلّم مقاليدها إلى رجالٍ يعرفون أنّ الكلمات قد تصير أقدارًا، وأنّ توقيعًا مُحكمًا قد يَرفع مظلومًا أو يَكفّ يد ظالم، وأنّ العدالة إن لم تسكن الأسلوب سكنها الخلل في المضمون.
- محكمة الاستئناف في النبطية بين حمولة الجنوب وكرامة العدالة
ليس الجنوب اللبناني جغرافيا عابرة في سجلّ القضاء، بل مشهد تاريخٍ مُثقلٍ بالحروب والتهجير والحرمان، ومختبر صبرٍ طويلٍ لا يعرفه إلا من سكن الحدود وخَبِر صدى الإنذارات في ليل القُرى. في هذا الفضاء، تأتي محكمة الاستئناف في النبطية لتكون أكثر من سلطةٍ قضائيّة، إنّها مؤسسة ثقةٍ عامةٍ تُرمّم عطب السنين وتعيد للنّاس شعورهم بأنّ الدولة ليست بعيدة وأنّ القانون ليس ترفًا حضريًا. وحين جلس القاضي الشويري على منصّتها، حمل معه وعيًا بأنّ ملفّات الناس هناك ليست أوراقًا باردة، بل حكايات عائلاتٍ وأرزاقٍ وأرواحٍ افتقدت طويلًا من يحرسها. ومن هذا الوعي وُلدت طريقةٌ في الإدارة تُحسن تنظيم الجلسات بلا تعسّف، وتسرّع الإجراءات بلا خفّة، وتحسن مخاطبة المحامين والمتقاضين بلغةٍ تُبقي على وقار القاعة وتفتح الباب لإيضاح ما التبس، فلا يخرج أحدٌ وهو يشعر أنّ صوته لم يُسمع، ولا يَمثُل أحدٌ وهو يظنّ أنّ الطريق إلى العدالة مُغلقٌ لمن لا يعرف دهاليزها. هكذا تحوّل المبنى إلى معنى، والهيئة إلى أمان، والقرار إلى رسالة تطمئن الجنوب بأنّ حقوقه لا تُساوم.
الاستئناف ليس تكرارًا للدرجة الأولى ولا ترفًا إجرائيًا يُرهق المتقاضي، إنّه رقابة علميّةٌ على سلامة الحكم ومنهجيّته، وإنّ تحويل هذه الحقيقة إلى ممارسةٍ يوميّةٍ يحتاج إلى قاضٍ يرى في الطعن فرصةً لتجويد العدالة لا مناسبةً لتأكيد الذات، ويقرأ في دفوع المحامين محاولةً لحماية الحقّ لا منافسةً شخصيّةً تُستثار. بهذا المنطق، عمل القاضي الشويري على ترسيخ ثقافةٍ مهنيّةٍ تُعيد الاعتبار لِحُجّة الحقّ، فيُكرّم المرافعات الرصينة ويُقوّم ما اعوجّ من الصناعة القانونيّة بغير تجريح، ويرفع معايير الإثبات والعلّة ويُمهِر الأحكام بأسبابٍ مُحكمة تُقنع العقل قبل أن تُرضي الطرف الغالب. ولم يكن ذلك شأناً تقنيًا فحسب، بل كان جزءًا من بناء ثقة المجتمع الجنوبيّ بقضائه، إذ تُصبح صفحات القرار مرآةً لِما ينتظره الناس من دولةٍ عادلة: وضوحًا في الحجّة، ونزاهةً في الترجيح، وجرأةً في مواجهة الخلل حيث وُجد، وتواضعًا معرفيًا لا يخجل من تصويب المسار إذا ظهرت بيّنةٌ تقلب المعادلة وتُعيد الأمور إلى نصابها من غير عنادٍ ولا استكبار.
في بيئةٍ مثقلةٍ بالضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تُصبح حماية استقلال القضاء عملًا يوميًا لا لفتةً احتفالية، وتغدو المسافة بين القاضي ومصادر التأثير امتحانًا صامتًا يُخفق فيه من يهوّن من شأن التفاصيل، ويَنجح فيه من يُدرك أن كلّ اتصالٍ غير لائقٍ قد يُكسِر ميزانًا وكلّ تنازلٍ صغيرٍ قد يُحدث في ثقة الناس شرخًا كبيرًا. بهذه الحساسية، حافظ القاضي الشويري على قاعةٍ لا يدخلها سوى القانون والوقائع، وجعل من الإجراءات جدارًا يحول دون التلاعب، ومن الشفافية لغةً تُدار بها المداولات وتُكتب بها الأسباب، فلا يُترك ثقبٌ لنظريّات المؤامرة ولا نافذةٌ لِشُبهةٍ تَعبث بالعقول. ومن خلال هذا الانضباط الأخلاقيّ، باتت محكمة الاستئناف في النبطية، زمن رئاسته، عنوانًا لهيبةٍ هادئةٍ لا تُقرع طبولها، لهيبةٍ تُرى في انتظام المواعيد، وفي رصانة القرارات، وفي وجه متقاضٍ يخرج مُقتنعًا أنّ الطريق إلى العدالة ليس مُقفلاً ولا مُلتويًا، وأنّ الجنوب الذي حَمَل الأثقال قادرٌ على أن يحمل نموذجًا في صون الحقّ.

- من القاعة إلى الوطن – أثرٌ يتجاوز اللحظة ويؤسّس للغد
لا تُقاس سيرة القاضي بسنوات الخدمة ولا بعدد الدعاوى التي مرّت بين يديه، بل بما يبقى بعده من طبائع حسنةٍ في المؤسسة، ومن أعرافٍ مهنيّةٍ تتناقلها الأجيال، ومن مفاهيم تُصوّب البوصلة كلّما اختلّت أو حاولت مصالحٌ عابرة أن تُبدّل اتجاهها. بهذا المِعيار، يخرج اسم القاضي الشويري من ضيق السِجِلّ الإداريّ إلى اتّساع الأثر العامّ، إذ ترك في الذاكرة القضائيّة درسًا في كيفيّة الجمع بين حزم الدولة ووداعة العدالة، وبين سيادة النصّ ومقاصد الحقّ، وبين استقلال الهيئة وتضامنها مع آلام الناس حين يَستبدّ بهم الانتظار، ذلك أنّ العدالة التي تتأخر تُظلم، والعدالة التي تُستعجل تُرتاب، والعدالة التي تُكتب بلغةٍ مُغلقةٍ تُغترب، فجاء نهجه وسطًا جميلًا يرفع عن القضاء تُهمة البطء ويخلّصه من شبهة التسرّع، ويُعيد إلى رأي العامّ ثقته بأنّ الدولة ما زالت قادرةً على أن تُنتج مؤسساتٍ تُشبه فكرة الدولة لا صورتها فقط.
ولأنّ المعنى لا يكتمل إلا حين يُنقَل، كانت بصمته التربويّة على مساعدي العدالة والمحامين الشبان والكتّاب والمتدرّبين جزءًا أصيلًا من رسالته، إذ كان يرى في كلّ جلسةٍ فصلًا دراسيًا غير مُعلن، وفي كلّ نقاشٍ فرصةً لتصحيح منهجيّة، وفي كلّ ملاحظةٍ تقنيةٍ بذرةَ ثقافةٍ مهنيّةٍ لا تنبت إلا حيث تجتمع المعرفة على الاحترام. لم يَدّخر جهدًا في تشجيع القراءة القانونية الرصينة، ولا في التنبّه إلى خطورة الاستسهال الذي يُفقد النصوص روحها، ولا في الإشارة إلى أنّ صيانة اللفظ ليست ترفًا بل شرطٌ لصيانة الحقّ، وأنّ صياغة الأسباب ليست زينةً لغويّةً بل قوام المشروعيّة التي يقوم عليها الحكم. هذا النقل الهادئ للمعرفة، حين يمتزج بخلقٍ كريمٍ وتواضعٍ جميل، يُضاعف أثره في النفوس، فيخرج من القاعة جيلٌ يُحبّ القانون لأنّه رأى فيه وجهًا عادلًا، ويُحبّ القضاء لأنّه تعلّم على يد قاضٍ أنّ العدالة لا تُفارق الإنسان إذا صانها الإنسان.
تبقى هذه الكلمات تحيّة وفاء وإجلال لاسمٍ يَجمع الناس على احترامه لا لأنّ سيرته بلا أخطاءٍ أو لأنّ أحكامه عاندت النقد، بل لأنّه عاش القيم الكبرى من دون صخب، وجعل من حضوره اليوميّ في القاعة تعهّدًا مستمرًّا بأنّ لبنان يستحق قضاءً يُداوي كسوره، وأنّ النبطية تستحق منصةً تُنصف أبناءها، وأنّ المتقاضي، أيًّا كان، يستحق لغةً تُخاطبه وميزانًا يُقنعه. قد يغيب الشخص وتبقى المدرسة، وقد تنطفئ الأضواء وتبقى السُبل التي رَسَمها نموذجًا لما ينبغي أن يكون عليه العدل حين يَسكنه الإنسان. في زمنٍ تُثقله الأزمات ويُتعبه الشكّ بالدولة، تُعيد هذه السيرة إلى اللبنانيين بعضًا من السلام الداخليّ الذي لا يمنحه سوى قضاءٍ يُشبه وعد الدولة لنفسها: أن تكون للجميع، وبالجميع، وعلى الجميع، وأن تكون في الجنوب كما في سائر الوطن حارسةً لحياة القانون وحياة الناس معًا.

- الخاتمة
هذه تحيّة وفاء وإجلال نرفعها إلى القاضي برنار ميشال الشويري، بما مثّله من رصانةٍ في الفكر، ونُبلٍ في السيرة، وثباتٍ في الاستقلال، ورهافةٍ في فهم الإنسان وهو يَطلب حقّه بين دفّتي قانون. لسنا نكتب سطور مديحٍ عابرٍ، بل نُثبت في الذاكرة العامّة نموذجًا يحتاجه اللبنانيّون وهم يُعيدون بناء ثقتهم بمؤسساتهم: نموذج القاضي الذي يحتكم للنصّ ولا يُغلق قلبه، يُصغي للخصوم ولا يُساوي بين الحقّ والباطل، يُحكم الأسباب كتابةً ليُحكم المقاصد عدلًا، ويجعل من القاعة مساحةً للإنصاف لا حلبةً للغلبة. إنّ أثره، وقد اتّسع من النبطية إلى رحاب لبنان، يَشهد بأنّ القضاء الذي نحلم به ليس أمنيةً بعيدة، وأنّ سيادة القانون ليست لافتةً تُرفع، وأنّ قيام الدولة يبدأ من منصةٍ يتربّع عليها قاضٍ من هذا الطراز، من نوعية القضاة القلائل الذين لا ينتظرون القوانين لتمنحهم الاستقلالية ليكونوا مستقلّين، ولا يُراهنون على إصلاحٍ آتٍ ليصبحوا صالحين، ولا يطلبون ألقاب “قضاة شرف”، لأنّهم في جوهرهم شرفاء قد شرفوا المهنة نفسها بضميرهم قبل أي شيء آخر. هؤلاء القضاة يكتبون سيرتهم في ضمائر الناس الذين يخرجون من قاعات المحاكم وهم يشعرون أنّ العدالة ما زالت ممكنة. وفي بلد موبوء مثل لبنان، حيث تختلط السياسة بالطائفية بالفساد، يظلّ القاضي المستقيم نادرًا كالذهب الخالص: كلّما مرّ في زمنٍ ملوّث، ازداد بريقه. ومن بين هؤلاء القضاة يسطع اسم القاضي الشويري، الذي جسّد صورة “القاضي الشريف في زمن موبوء“، حيث عاش العدالة كقيمة إنسانية، وصانها كأمانة وطنية، وأثبت أنّ القاضي الصادق قادر على مواجهة الزمن الموبوء بالقانون والضمير قبل أي شيء آخر. فلتبقَ هذه السيرة منارةً تُضيء دروب العدالة للأجيال، ولتبقَ حروفها عهدًا بأنّ الوطن الذي يحيا على الحقّ لا يموت.
في خاتمة المطاف، لم يكن القاضي الشريف بحاجةٍ إلى نصوصٍ دستورية ولا إلى تشريعاتٍ مرتجاة كي يُمارس استقلاليته، فالاستقلالية الحقيقية لا تُستمد من قانونٍ جامد بل من ضميرٍ يقظٍ حيّ. هكذا كان القاضي الشويري، يحمل العدالة في قلبه كما يحملها في قاعة المحكمة، ويُمارس النزاهة كخبزٍ يوميّ لا كشعارٍ يتردّد على الألسن. لم ينتظر دولةً تُرمّم جهازها القضائي المتهالك، ولم يُفتتن بألقابٍ براقة تُمنح لمن استسلموا لسطوة السياسة، فأضحوا خدماً لأهوائها لا خُداماً للحق.
وفي زمنٍ تكاثر فيه وهم “قضاة الشرف“، لم يكن القاضي الشويري محتاجًا إلى نصٍّ يخلع عليه الاستقلالية، ولا إلى لقبٍ يتزيّن به، لأن الشرف كان يتجسّد فيه؛ قاضياً بطينته شريفًا، شرف المهنة بحضوره، وجعل من محكمة الاستئناف في النبطية، على الرغم من الضغوط التي مارسَتها القوى النافذة، ظلّ ثابتًا كالطود، لا تزعزعه رياح المصالح ولا تُغريه إغراءات السلطة، فارتقى بكرامة القضاء فوق حسابات الساسة وأهواء المتنفّذين. ومن هنا استثنائيته: قاضٍ يُقاس بما حفظ من كرامة القضاء، وما غرس من ثقةٍ عميقة في قلوب الناس.