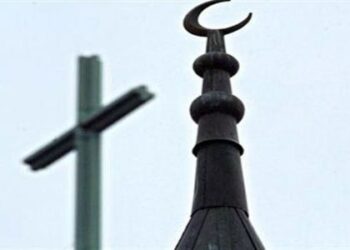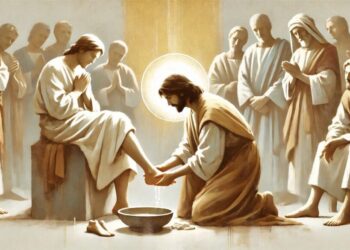هكذا طارت ودائع اللبنانيين!
د. الياس ميشال الشويري
من بين المصطلحات التي باتت تتردد على ألسنة الخبراء والناس في لبنان على حدّ سواء، يبرز مفهوم “الفجوة المالية” كأحد أكثر التعابير كثافة ودلالة على عمق الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يعيشه البلد منذ عام 2019. فهذه الفجوة ليست مجرد رقم في دفاتر المحاسبين أو في تقارير مصرف لبنان، بل هي مرآة لعقودٍ من السياسات الخاطئة، والفساد الممنهج، والإدارة غير المسؤولة للمال العام والخاص معاً. إنها الفجوة التي تفصل بين ما تَعِد به الدولة وما تملك فعلاً، بين ما أودعه المواطنون في المصارف وما تبقى من ودائعهم في النظام المالي، بين الخطاب السياسي المضلّل والحقيقة المرّة التي لم يعد بالإمكان طمسها.
ولعلّ أخطر ما في هذه الفجوة أنها ليست مالية فقط، بل أخلاقية وسياسية واجتماعية في آن واحد. إنها الفجوة بين الحاكم والمحكوم، بين المواطن الذي اجتهد وبنى وادخر، والسلطة التي التهمت تعب الناس بلا حسيب ولا رقيب. ومع انكشاف حجمها الحقيقي، اكتشف اللبنانيون أن الانهيار لم يكن حادثاً طارئاً بل مساراً مبرمجاً، نسجه تحالف المال والسلطة على مدى عقود. لذلك، فإن دراسة الفجوة المالية ليست بحثاً في الأرقام بقدر ما هي بحث في الضمائر والسياسات، وفي كيفية تحول الدولة من كيانٍ راعٍ إلى كيانٍ ناهب.
في هذا المقال، سنغوص في عمق الأزمة عبر محاور متعددة تُضيء على جذور الفجوة المالية، آليات تكوينها، تداعياتها المدمّرة، والمسؤوليات المتشابكة التي أوصلت لبنان إلى حافة الإفلاس. كما سنحاول أن نربط هذه الأزمة بالواقع اللبناني العام، حيث تتقاطع الأزمة المالية مع أزمة الحكم، ومع الفشل التاريخي في بناء دولة مؤسسات حقيقية. ومن خلال هذه المقاربة، سنكتشف أن “الفجوة المالية” ليست سوى وجهٍ من وجوه فجوةٍ أكبر وأخطر: الفجوة بين لبنان الذي حلم به أبناؤه ولبنان الذي صاغته المنظومة الفاسدة على مقاس مصالحها.
- تعريف الفجوة المالية وأُطر فهمها
الفجوة المالية يمكن تعريفها بصورة مبسطة على أنها الفرق بين الموارد المتاحة والموارد المطلوبة لتحقيق هدف محدد أو لتلبية التزامات قائمة. في سياق دولة كاملة مثل لبنان، يأخذ هذا التعريف بعداً واسعاً يتضمن الموارد الضريبية والإيرادات النفطية أو غيرها (إن وُجدت)، الاحتياطات الدولارية، قدرة البنوك على تلبية سحوبات المودعين، والقدرة على تأمين واردات أساسية. الفجوة ليست حالة محصورة في أرقام موازنة فحسب، بل هي أيضاً فجوة ثقة: ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية والمصرفية، وثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي والسياسي، وثقة المانحين والمؤسسات الدولية في قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات بنيوية. لذلك يصبح قياس الفجوة أمراً متعدد الأبعاد، يتطلب النظر إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الكمية والكيفية معاً. على المستوى الكمي، قد يقاس العجز في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي، ونسبة الدين العام إلى الناتج، ومتوسط الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق الموازية، واحتياطات النقد الأجنبي الصافية بعد استبعاد التزامات المصرف المركزي. أما من الناحية الكيفية، فتشمل الفجوة مؤشرات جودة الحوكمة، مستوى الشفافية في المصارف والقطاع العام، ومدى استجابة النظام المصرفي والأمني والاقتصادي للأزمات الخارجية والداخلية. في لبنان، تعقّد القياس بسبب تعدد أسعار الصرف وغياب بيانات موحّدة وشفافة عن التحركات المصرفية والاحتياطيات الحقيقية، ما يجعل أي محاولة لقياس الفجوة عملية استدلالية تعتمد على مجموعة من الافتراضات والتقاطع بين مصادر بيانات رسمية وغير رسمية.
- الجذور التاريخية والهيكلية للفجوة المالية
للفجوة المالية جذور تاريخية وطبيعية إلى حد كبير، وهي ليست وليدة حدث واحد بل تراكمت عبر عقود من السياسات والاختيارات. خلال فترات سابقة اعتمد لبنان على نموذج نمو خاص يقوم إلى حد كبير على القطاع المالي والخدمات المصرفية وتحويلات المغتربين والسياحة، دون أن يفتح نافذة إنتاجية قوية ومتنوعة واقتصاداً صناعياً متيناً قادرًا على خلق قاعدة ضريبية أوسع ومستقرة. هذا النمط أعطى وهماً دائماً بوجود وفرة في السيولة طالما أن التدفقات الخارجية مستمرة، لكنه خلق هشاشة مفرطة أمام الصدمات الخارجية مثل تذبذب أسعار النفط، الأزمات الإقليمية، أو انخفاض تحويلات المغتربين. إلى جانب ذلك، أدت السياسات المالية التوسعية في فترات محددة إلى تراكم الدين العام، بينما لم تواكبها إصلاحات هيكلية لعملية تحصيل الضرائب أو لإدارة الإنفاق بكفاءة، فبقي الدعم غير مستهدف وكلفته مرتفعة ودعم معظم الخدمات العامة مستهلكًا جزءًا كبيرًا من الموارد المتاحة. كما أن بناء شبكة علاقات اقتصادية وسياسية على أساس الزبائنية والمحسوبية سرّع من إضعاف قواعد الحوكمة، وفتح أبواب الفساد والهدر، ما أضعف قدرة الدولة على تعبئة الموارد داخليًا، وأضعف ثقة المستثمرين والمودعين على حد سواء. وفي الجانب المصرفي، تراكمت ممارسات اعتمدت على مقايضة الدين السيادي بسيولة مصرفية مغرية للبنوك ما خلق ترابطاً قوياً بين صحة الميزانية العامة وصحة ميزانيات المصارف، وهو ما انكشف بشكل دراماتيكي بعد 2019 عندما ظهرت عدم قدرة الدولة على تلبية التزاماتها أمام المودعين والدائنين.

- كيف تحوّلت الجذور إلى فجوة مالية ملموسة؟
التحوّل من جذور هيكلية إلى فجوة مالية قابلة للقياس مرّ عبر سلسلة من الصدمات والتفاعلات. أوّلاً، هناك تراجع في تدفقات الدولار نتيجة لتقلّص تحويلات المغتربين وضغوط على رأس المال، وهو ما زاد الطلب على الدولارات بينما تقلصت المعروضات. ثانياً، عند انهيار الثقة بالمؤسسات المصرفية والحكومية، سعى المودعون إلى سحب مدخراتهم أو تحويلها إلى سوق سوداء أو إلى خارج النظام، ما أجبر البنوك على فرض قيود غير رسمية على السحوبات والتحويلات، وهو بدوره عزّز الفجوة بين القيمة المسجلة للودائع وقيمتها الفعلية القابلة للاستخدام. ثالثاً، مع تضخم الفجوة الدولية في السيولة، ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية إلى مستويات بعيدة عن السعر الرسمي، مما خلق فجوة سعرية أثّرت على القدرة الشرائية والاقتصاد الحقيقي. رابعاً، تراكم الدين الجاري لخدمة العجز الحكومي أدى إلى تحويل جزء كبير من الموارد إلى خدمة ديون متنامية، ما أنتج دائرة مفرغة: كلما ازداد الدين ارتفعت خدمة الدين واستُنزفت موارد للاستثمار أو للإنفاق الاجتماعي، مما دفع إلى مزيد من الاقتراض أو إلى تخفيض القيمة الحقيقية للالتزامات عبر التضخم وارتفاع مستويات الفقر. هذه الديناميكية حولت مشكلة إدارية واجتماعية واقتصادية إلى أزمة مالية شاملة تطال المؤسسات والأفراد والخدمات الأساسية.
- تجليات الفجوة على النظام المصرفي والمالي
تجلّت الفجوة المالية بشكل واضح في القطاع المصرفي اللبناني، وذلك من خلال تشوّه ميزانيات البنوك، وضعف قدرتها على تغطية التزاماتها بالعملة الصعبة، وفرض قيود فعلية على السحوبات بالعملات الأجنبية. البنى القديمة في القطاع المصرفي اعتمدت على ممارسات ثقة متبادلة بين البنوك والدولة، حيث كانت المصارف تملك حصيلة كبيرة من السندات الحكومية والثقة في قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها. مع تدهور موقف الدولة المالي، تراجع رأس المال الفعلي لبعض البنوك، وبرزت الحاجة إلى تقييم دقيق للأصول والسندات الحكومية المتعثرة. هذا الوضع خلق أزمة سيولة حادة، إذ أن الأصول قد تكون مسجلة بقيم اسمية لا تعكس خسائر القيمة الحقيقية أو المخاطر الائتمانية، بينما المودعون يواجهون قيوداً فنية وواقعية تحول دون وصولهم إلى مدخراتهم بالعملة الأجنبية. التأثيرات لم تبق محصورة عند هذه المسألة فحسب، بل امتدت إلى تقليص قدرة البنوك على منح قروض استثمارية أو تشغيلية، ما أضعف النشاط الاقتصادي وقلّص قدرة المشاريع الخاصة على النمو. في هذه الحالة، يصبح النظام المالي عاجزًا عن أداء وظيفته الأساسية كوسيط للادخار والتمويل، وتتحول البنوك من جهات تمويل إلى مؤسسات إدارة أزمات، ما يتطلب تدخلات تنظيمية وجذرية لإعادة الهيكلة وإعادة الثقة.
- تأثيرات الفجوة على الاقتصاد الحقيقي وسلاسل الإمداد
الفجوة المالية لها انعكاسات مباشرة على القطاع الحقيقي للاقتصاد، إذ أن شح العملة الصعبة يجعل من استيراد المواد الخام والوقود والأدوية واللوازم اللازمة للإنتاج أمراً معقّداً ومكلّفاً. الشركات التي اعتمدت على واردات لقطع غيار أو خامات تجد نفسها إما أمام تكاليف أعلى تؤدي إلى رفع الأسعار أو أمام توقف جزئي للإنتاج، ما ينعكس سلباً على مستويات التشغيل والرواتب. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر ارتفاع تكاليف الاستيراد على تنافسية المنتج اللبناني في أسواق التصدير، ويؤدي إلى انخفاض الإيرادات الخارجية التي تعتبر مصدراً مهماً لموازنة المدفوعات. على مستوى السوق المحلي، يتحول الطلب من سلع نوعية إلى سلع بديلة أرخص أو إلى تأجيل الاستهلاك الاستثماري، مما يضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. كما أن انقطاع التمويل الاستثماري وإعادة تخصيص الموارد نحو السداد الخدمي أو المصاريف الجارية يزيدان من خطر تضخم البطالة والفقر ويقلصان من فرص الانتعاش الاقتصادي على المدى المتوسط.
- البُعد الاجتماعي والإنساني للفجوة المالية
ما تحمله الفجوة المالية من تبعات ليس مجرد أرقام على صفحات موازنة أو كشوفات مصرفية؛ بل يساوي حياة الناس ويحدد مصائر أسر كاملة. مع تآكل القدرة الشرائية نتيجة لانهيار سعر الصرف وارتفاع التضخم، يجد المواطنون أنفسهم مضطرين للتضحية بنوعية الغذاء والرعاية الصحية والتعليم في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار. الطبقات الوسطى، التي كانت خلال سنوات قادرة على الاحتفاظ بمستوى معيشي مقبول، فقدت غالبًا مدخراتها أو أصبحت عرضة للانزلاق إلى الفقر، بينما الفئات الأشد فقراً ازدادت هشاشة. علاوة على ذلك، أدت القضايا المالية إلى توترات اجتماعية وسياسية: احتجاجات متكررة، ارتفاع في معدلات الانشقاق واستقالة العديد من العقول والكفاءات التي هاجرت إلى الخارج، ما سمّى هجرة الأدمغة. هذه الهجرة بدورها تقلص القدرة على التعافي لأنها تُفرغ السوق المحلية من موارد بشرية متخصصة قد تكون أساسية لإعادة بناء القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية. كما أن الاحتقان الاجتماعي يولّد توجهاً سياسياً غير مستقر يمكن أن يعوق أي خطة إصلاحية تحتاج إلى وقت وجهد مجتمعين لتنفيذها.
- فجوة السيولة الدولارية وتداعياتها على الأمن الاقتصادي
فجوة السيولة بالدولار تعدّ من أكثر مظاهر الأزمة حدة لأن الدولار هو الوسيلة الأساسية لتبادل التجارة الدولية ولتسديد الالتزامات الخارجية. في لبنان، أدى تراجع التحويلات الخارجية بعد 2019 وحصر العملات الصعبة في يد فئات معينة أو في قنوات غير رسمية، إلى تضييق كبير في إتاحة الدولار للمستورِدين وللمواطنين. نتيجة لذلك، تصاعدت ضغوط على سوق الصرف، وارتفعت معدلات عدم اليقين بشأن الأسعار المستقبلية للسلع المستوردة. أصبح للمصارف دور مزدوج، فهي تواجه التزاماً بتأمين سيولة الدولارات للمودعين الذين يطلبون تحويلات، وفي الوقت نفسه تعاني من تآكل أصولها غير السيولة. هذا السياق دفع إلى نمو سوق سوداء للدولار وأسعار صرف متباينة، ما زاد من تكاليف الاستيراد وأضعف قدرة الشركات على التخطيط المالي. على المستوى الاجتماعي، أدى هذا إلى نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع أسعارها، وتعطل خدمات أساسية تعتمد على محركات تعمل بالوقود المستورد، وهو ما انعكس سلباً على جودة الحياة والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.
- فجوة التمويل للاستثمار والبنية التحتية
عند الحديث عن إعادة بناء الاقتصاد أو خلق نمو مستدام، يصبح تمويل الاستثمار محركاً أساسياً. في لبنان، أدت الفجوة المالية إلى تقلص قدرة الدولة على تمويل مشاريع البنى التحتية اللازمة للطاقة والمواصلات والمياه والصحة والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، الشركات الخاصة تجد صعوبة في الحصول على تمويل جريء أو متوسط المدى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، عدم اليقين القانوني، ومخاطر تحويل الأرباح بالدولار. هذا القصور في التمويل يعني أن المشاريع التي من شأنها أن تخلق وظائف طويلة الأمد وتحسن من بيئة الأعمال لا ترى النور، أو تؤجل لسنوات، ما يؤدي إلى استمرار الحلقة السلبية بين نقص الاستثمار وضعف النمو. كما أن فرص الشراكات مع مستثمرين دوليين تقلّ عندما لا توجد سياسات واضحة لإدارة المخاطر وحماية الاستثمارات، أو عندما تكون هناك مخاوف من استمرارية الأطر القانونية والتنفيذية.
- سياسات مقترحة لمعالجة الفجوة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل
معالجة الفجوة المالية تتطلب مجموعة متكاملة من السياسات المتزامنة والمتراوحة زمنياً. على الصعيد القصير يجب تأمين واردات السلع الأساسية والدعم النقدي العاجل للفئات الضعيفة حتى لا تنهار حياة الملايين، كما يجب تأمين خطوط ائتمان طارئة لسوق الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية. على الصعيد المتوسط يجب العمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي بإجراءات شفافة تشمل تقييم الأصول، فصل الأصول الصحية عن السامة، ووضع آليات لحماية المودعين المشروعة، كل ذلك بالتوازي مع بدء عملية توحيد تدريجي لسعر الصرف مع أدوات حماية اجتماعية لتقليل الصدمات. كما يجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بحيث يعطي الحيز الأكبر للاستثمارات التي ترفع القدرة الإنتاجية وتوسّع القاعدة الضريبية. على الصعيد الطويل، يتعين بناء استراتيجية شاملة لتنويع الاقتصاد، تعزيز الصادرات، تطوير قطاعات مثل الزراعة والسياحة والسجل البحري والخدمات التكنولوجية، بالإضافة إلى إصلاحات مؤسسية لإعادة بناء الثقة في الحكم وحماية حقوق الملكية وسيادة القانون. كل هذه السياسات تتطلب توافر إرادة سياسية ومصداقية في التنفيذ وإشراكاً مجتمعياً واسعاً لتقليل المقاومة الاجتماعية والسياسية لخطوات الإصلاح الضرورية.
- دور التعاون الدولي والمانحين في سد الفجوة
التعاون الدولي يمكن أن يلعب دوراً مسهماً في تخفيف ضغط الفجوة المالية بشرط أن يُبنى على شروط واضحة وشفافة. يحتاج لبنان إلى شراكات تمويلية موقتة لتأمين احتياجاته الأساسية، وكذلك برامج دعم تقني للمساعدة في إصلاح الجهاز الضريبي والمصرفي وتحديث البنية الإدارية. ومع ذلك، يجب أن يكون أي دعم دولي مصحوباً بخارطة إصلاح واضحة تٌعرض على الجهات المانحة وتُنفّذ بشفافية مع مؤشرات أداء واضحة ومراقبة مستقلة. التجارب الدولية تظهر أن الدعم غير المشروط أو الدعم الذي لا يرافقه إصلاح حقيقي غالباً ما يضعف من أثره. لذلك ينبغي أن تتضمن الآليات الدولية شقاً تمويلياً عاجلاً واستثمارياً طويل الأجل، بالإضافة إلى برامج حماية اجتماعية لضمان أن يتحمّل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود أقل الأعباء في مسار الإصلاح.
- آليات قياس التقدم وإدارة المخاطر
من الضروري مواصلة قياس الفجوة المالية بدقة من خلال مؤشرات واضحة ومتفق عليها تستطيع الحكومة والجهات المنظمة والمجتمع المدني متابعتها. ومن بين هذه المؤشرات التي ينبغي مراقبتها بصورة مستمرة: مستوى احتياطيات النقد الأجنبي الصافية، نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، مستوى العجز في الموازنة، مؤشرات البطالة والفقر، فروق أسعار الصرف، ومستوى الودائع المصرفية المتاحة. كما يجب تحديد مؤشرات نوعية مثل مستوى الشفافية في إعلانات الميزانية والصفقات العامة، ومؤشرات المساءلة والحوكمة في الجهاز المصرفي. إلى جانب ذلك، يجب تبنّي إطار لإدارة المخاطر يتضمن سيناريوهات متعددة للحالات الطارئة، وخطط استجابة سريعة للصدمة الاقتصادية الخارجية أو الداخلية، وآليات حماية للأكثر هشاشة في المجتمع. إن الفشل في إنشاء نظام مراقبة فعال وتخطيط مخاطر يمكن أن يؤدي إلى تكرار نفس الأخطاء وتأجيل التعافي لسنوات.

- الخاتمة
في نهاية هذا المقال، يتضح أن الفجوة المالية في لبنان ليست حدثاً معزولاً ولا أزمةً تقنية قابلة للمعالجة بمجرد خطط إنقاذ أو إصلاحات محاسبية سطحية، بل هي خلاصة تاريخٍ طويل من الانحراف البنيوي في إدارة الدولة، ومن تواطؤ بين السياسي والمصرفي والمصرف المركزي. إنها جريمة مكتملة الأركان بحق شعبٍ وثق بدولته ومصارفه، فاستفاق على حقيقة مرّة: أن أمواله تحوّلت إلى أرقام وهمية، وأن مستقبله رُهن بقرارات فاسدة.
لكن الأخطر من ذلك أن هذه الفجوة تحوّلت إلى فجوة أخلاقية بين طبقةٍ سياسية لا تعرف المحاسبة وشعبٍ يواجه الفقر والعوز والبطالة دون أملٍ حقيقي بالإنقاذ. فالأزمة لم تعد اقتصادية فحسب، بل أصبحت أزمة قيم وعدالة وثقة. إن لبنان اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما أن يواصل الانحدار في هاوية الإنكار والتسويف، أو أن يواجه الحقيقة بشجاعة ويبدأ عملية إعادة بناء شاملة تُعيد الاعتبار إلى الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
إن ردم الفجوة المالية يبدأ أولاً بردم الفجوة بين الدولة والمواطن، بين الكلمة والفعل، وبين الخطاب والمسؤولية. فالأرقام يمكن معالجتها بخطط اقتصادية، أما الثقة فلا تُستعاد إلا حين يُحاسَب السارق ويُكرَّم الأمين. تلك هي المعادلة التي وحدها قادرة على إنقاذ لبنان من إفلاسه المالي والمعنوي معاً، وإعادته إلى سكة الدولة الحقيقية التي تُبنى على العدالة لا على المحاصصة، وعلى الصدق لا على الاحتيال.
هكذا فقط يمكن القول إن لبنان تعلّم من جراحه، وأنه بدأ يسدّ فجواته لا بالأكاذيب بل بالحقائق، ولا بالوعود بل بالإصلاح الحقيقي الذي يعيد للوطن توازنه وللمواطن كرامته.