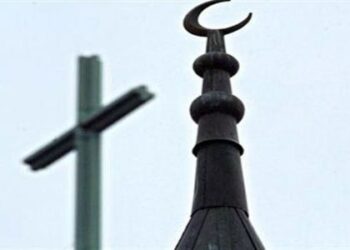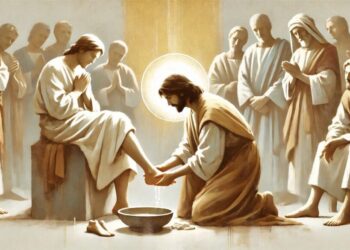من اتفاقية الهدنة عام1949
د. الياس ميشال الشويري
يعيش لبنان اليوم واحدة من أكثر مراحله التاريخية حساسية وتعقيدًا، حيث تتشابك فيه خطوط النار والسياسة والاقتصاد والهوية. فبعد أن أعلن رسميًا الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرية، بدا المشهد اللبناني وكأنه يسير على حبلٍ مشدود بين التنازل والضرورة، بين الواقعية السياسية والشعارات الثورية. هذا التفاوض، وإن جاء تحت مظلة الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، أعاد إلى الواجهة أسئلة الوجود والسيادة: هل يستطيع لبنان أن يتفاوض من موقع الدولة لا من موقع الضعف؟ وهل يمكن الفصل بين السياسة الداخلية المختنقة بالأزمات وبين الاستحقاقات الإقليمية التي تفرضها لعبة الأمم؟
لقد تحول هذا التفاوض إلى مرآة تعكس عجز النظام السياسي اللبناني عن إنتاج قرار وطني موحّد. فالقوى السياسية منقسمة بين من يرى في المفاوضات خطوة براغماتية للحفاظ على الحقوق الاقتصادية والسيادية، ومن يعتبرها خيانة لمبدأ الصراع مع إسرائيل. وبين هذين الخطين، يقف المواطن اللبناني عاجزًا عن فهم الاتجاه الذي يسلكه وطنه: أهو ذاهب نحو السلام أم يُساق نحو جبهة جديدة؟ ومع اشتعال حرب الإسناد في الجنوب، تداخلت مفاهيم التفاوض والمقاومة والسيادة حتى بات من الصعب التمييز بينها. من هنا، تأتي ضرورة تفكيك هذا المشهد المركب، عبر قراءة علمية تحليلية لأبعاد التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، ولما رافقه من حروبٍ جانبية ودمارٍ جنوبي متجدد.
1. معنى التفاوض غير المباشر – بين الواقعية السياسية والتنازل السيادي
التفاوض غير المباشر مع إسرائيل ليس مجرد مصطلح تقني أو دبلوماسي، بل هو ترجمة عملية لحالة التردد اللبناني التاريخي بين الانفتاح والانغلاق، بين الحرب الدائمة والهدنة المؤقتة. فمنذ عقود، لم يعرف لبنان شكلًا واضحًا لعلاقته بالعدو الإسرائيلي: هو لا يعترف بإسرائيل رسميًا، لكنه يفاوضها عبر وسطاء دوليين في ملفات الطاقة والحدود. هذا النمط من التفاوض يعكس بوضوح الانقسام الداخلي حول مفهوم الدولة وموقعها في النظام الإقليمي. فالدولة اللبنانية، التي تُفترض أن تكون صاحبة القرار، تجد نفسها أسيرة توازنات داخلية وخارجية، تجعل من كل خطوة تفاوضية مسرحًا لصراع سياسي طائفي أكثر منه وطني.
الهدف المعلن من المفاوضات هو ترسيم الحدود البحرية والبرية لحماية الثروات النفطية والغازية، وضمان حقوق لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة. غير أن الهدف الخفي – أو غير المعلن – هو تثبيت معادلة استقرار مؤقت على الحدود الجنوبية، تسمح باستمرار الوضع القائم دون حرب شاملة. لكن هذا التوازن هشّ، لأن التفاوض غير المباشر لا يلغي العداء بل يؤجله، ولا يمنح السيادة بل يشاركها مع الخارج. وهنا تكمن الخطورة الكبرى: أن يتحول التفاوض من أداة دفاع عن الحقوق إلى أداة تُدار بها مصالح الآخرين على حساب لبنان.
ومع غياب الثقة بين المكونات اللبنانية، ومع تفكك الدولة وعجزها المالي والإداري، يصبح أي تفاوض عرضة للابتزاز الدولي والداخلي معًا. فبدل أن يخرج لبنان من موقع الضعف عبر التفاوض، يجد نفسه غارقًا في شبكة من الضغوط المتشابكة التي تُعيد إنتاج أزماته بأشكال جديدة. وهكذا، يصبح السؤال الأساسي: هل التفاوض غير المباشر هو إنقاذ أم انتحار بطيء باسم الواقعية السياسية؟

2. المعضلة الوطنية – الدولة الغائبة والوصايات الحاضرة
يُظهر المشهد اللبناني أن الدولة الرسمية تكاد تكون المتفرج الأضعف في لعبة التفاوض مع إسرائيل. فالقرارات الكبرى لا تُتخذ داخل المؤسسات الدستورية بل تُصاغ في أروقة القوى التي تملك السلاح أو النفوذ الخارجي. هذه الحقيقة تجعل التفاوض غير المباشر مجرّد واجهة شكلية، في حين أن القرار الفعلي يبقى خارج يد الدولة. وهكذا، نجد لبنان يخوض مفاوضات مع دولة عدوّة بينما لا يملك الحد الأدنى من الوحدة الداخلية التي تُمكّنه من التحدث بصوت واحد.
الانقسام الوطني حول المفاوضات يُعيدنا إلى لبّ المشكلة اللبنانية: غياب مفهوم السيادة الموحّدة. فكل فريق يفسّر التفاوض وفق مصالحه أو رؤيته العقائدية، لا وفق المصلحة الوطنية العليا. البعض يراه خطوة لتثبيت الحقوق البحرية، والبعض الآخر يراه بابًا للتطبيع المقنّع، في حين يُحاول آخرون استثماره سياسيًا لتسجيل نقاط في صراعات داخلية. وبهذا المعنى، يغدو التفاوض مجرّد انعكاس لأزمة النظام السياسي الطائفي الذي يُفكّك الدولة بدل أن يوحّدها.
أما على الصعيد الخارجي، فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل نفسها تدرك تمامًا حجم هذا الضعف البنيوي، فتتعامل مع لبنان بوصفه كيانًا فاقد القرار السيادي الكامل، ما يجعل كل تسوية قابلة للانقلاب في أول أزمة. فلبنان الذي دخل المفاوضات طامحًا لتأمين موارده البحرية، خرج منها محاصرًا بأسئلة أكثر خطورة: من يُفاوض باسم لبنان؟ ومن يضمن تنفيذ الاتفاقات؟ وهل ما زال هناك في الدولة اللبنانية من يمتلك صلاحية إعلان السلم أو الحرب؟ هذه المعضلة البنيوية تفسر سبب انتقال لبنان سريعًا من طاولة التفاوض إلى جبهات القتال الجنوبية دون أن يُعلن حربًا رسميًا، في مشهد يجسد فوضى السيادة بأبهى صورها.
3. التفاوض كوجه آخر للصراع – بين السلام الممنوع والحرب المستمرة
في الظاهر، يبدو التفاوض غير المباشر محاولة لتهدئة الحدود وضمان الحقوق، لكنه في العمق استمرار للصراع بأدوات جديدة. فلبنان الذي لم يوقّع معاهدة سلام مع إسرائيل، يعيش حالة “لا حرب ولا سلام” منذ اتفاق الهدنة عام 1949. هذه الحالة الرمادية جعلت التفاوض وسيلة مؤقتة لتبريد الجبهات لا لإنهاء النزاع. فكل اتفاق جزئي – من ترسيم بحري أو تفاهم أمني – يتحول إلى هدنة ميدانية قابلة للانفجار في أي لحظة.
في هذا السياق، لا يمكن فصل التفاوض غير المباشر عن الواقع الإقليمي الذي تتحكم فيه صراعات النفوذ بين إيران والولايات المتحدة، ولا عن دور حزب الله الذي يعتبر نفسه “الضامن الميداني” لأي توازن مع إسرائيل. وهنا المفارقة: الدولة تفاوض بالوساطة، والحزب يفاوض بالنار. وبين لغة الدبلوماسية ولغة الصواريخ، تتشكل معادلة لبنانية هجينة تُفرغ فكرة الدولة من معناها. هذه المعادلة تجعل من كل اتفاقٍ هشًّا، لأن السلاح غير الرسمي هو من يحدد حدود الحرب والسلم.
وكلما اشتعلت جبهة الجنوب، يتبيّن أن التفاوض لم يكن سوى فاصل زمني بين حربين. فإسرائيل التي لا تعترف بسيادة لبنان عمليًا تستمر في اختراق أجوائه واحتلال مزارع شبعا، في حين أن لبنان العاجز عن الردّ بقرار وطني، يترك مصيره مرهونًا لتفاهمات غير مكتوبة. إن غياب الدولة عن تحديد موقف نهائي من إسرائيل، وغياب استراتيجية دفاعية موحدة، يُبقي لبنان في حالة “الانتظار الدائم“، حيث يُستخدم التفاوض وسيلة لإدارة الأزمة لا حلّها. ومن هنا، يمكن القول إن لبنان لا يفاوض ليُحقق السلام، بل ليُؤجل الحرب القادمة.
- حرب الإسناد والدمار في الجنوب – لبنان بين نار الدعم ونار الدمار
بدأت حرب الإسناد في الجنوب اللبناني كتحرك ميداني تضامني مع غزة في تشرين الأول 2023، لكنها سرعان ما تحولت إلى مواجهة مفتوحة استدرجت لبنان إلى قلب الصراع الإقليمي. القصف الإسرائيلي طال أكثر من مئة بلدة جنوبية، وأدى إلى تهجير عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير واسع للبنى التحتية والمنازل، فيما اكتفت الدولة بتصريحات هزيلة وغياب كامل على الأرض. هذا المشهد ليس جديدًا، بل تكرار مأساوي لحروب 1978 و 1982 و 2006، لكن الفرق أن لبنان اليوم منهك اقتصاديًا ومنقسم سياسيًا، ما جعل الجنوب يدفع أثمانًا مضاعفة.
لقد بررت القوى المقاتلة تدخلها في في تشرين الأول 2023 بأنه “إسناد للمقاومة الفلسطينية“، إلا أن الواقع أظهر أن الإسناد تحول إلى استنزاف وطني شامل. فالجنوب الذي كان عنوان العزة أصبح ميدان الدمار، والمواطن الجنوبي الذي صمد لعقود بات اليوم بلا مأوى ولا ضمان. بين الصواريخ والتهجير، ضاعت الرسالة، وغابت البوصلة، وصار لبنان يُستدرج إلى حروب لا يملك قرارها ولا أدوات إنهائها. إن ما جرى في الجنوب ليس دفاعًا عن سيادة بل إلغاء متكرر لها، حين تُدار الحرب باسم لبنان فيما الدولة نفسها مغيّبة عن القرار.

ومن منظور استراتيجي، أدت حرب الإسناد إلى تقويض ما تبقى من هيبة لبنان الإقليمية، إذ بدا كأنه يُدار من الخارج، في وقتٍ يتهاوى فيه اقتصاده وتتعطل فيه مؤسساته. فالإسناد الذي رُوّج له كعمل بطولي، انتهى بتحويل لبنان إلى ساحة مواجهة نيابة عن الآخرين. وبين خطاب المقاومة وخطاب الحياد، يقف اللبناني حائرًا أمام مشهد وطن يُدمّر باسم الكرامة، وتُهدد سيادته باسم التضامن. وفي نهاية المطاف، أثبتت حرب الإسناد أن لبنان يحتاج إلى إسناد من نوع آخر: إسناد الدولة لشعبها، لا سحبها إلى حروب الآخرين.
5. لبنان بين مطرقة التفاوض وسندان الحرب – وطن يبحث عن ذاته
يجد لبنان نفسه اليوم في مأزق تاريخي تتقاطع فيه خطوط النار والسياسة والكرامة والسيادة. فالتفاوض غير المباشر مع إسرائيل لم يُحقق الاستقرار، وحرب الإسناد لم تُحقق النصر. وبينهما، يدفع اللبنانيون ثمن الخيارات المزدوجة التي تُتخذ باسمهم دون استشارتهم. لقد تحولت السيادة إلى شعار، والحياد إلى وهم، والدولة إلى متفرّج على مسرح تُكتب فيه أقدارها بأقلام الآخرين.

وحدها إرادة الدولة الجامعة قادرة على إخراج لبنان من هذا النفق المظلم. المطلوب ليس سلامًا بأي ثمن ولا مقاومة بلا دولة، بل بناء عقد وطني جديد يُعيد تعريف معنى السيادة والكرامة، ويضع قرار الحرب والسلم في يد المؤسسات لا الأفراد. حينها فقط، يمكن للبنان أن يتفاوض من موقع القوة، لا من موقع الاضطرار، وأن يدعم فلسطين بالثبات والبناء، لا بالدمار والدماء.
إن مستقبل لبنان لن يُصاغ في الخنادق ولا في خيم التفاوض، بل في قدرة شعبه على أن يقول: كفى؛ كفى حروبًا بالوكالة، وكفى انقسامات باسم المبادئ. فالوطن الذي يُدار من الخارج لا يُبنى في الداخل. والكرامة الحقيقية ليست في إطلاق الصواريخ، بل في بناء دولة تُحافظ على حياة مواطنيها وكرامتهم. ذلك هو التحدي الأكبر أمام لبنان: أن يكون وطنًا حرًا، لا ورقة في يد أحد.