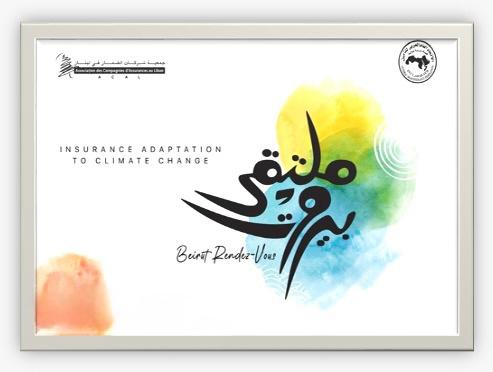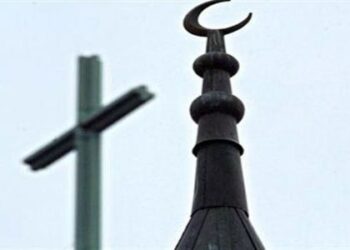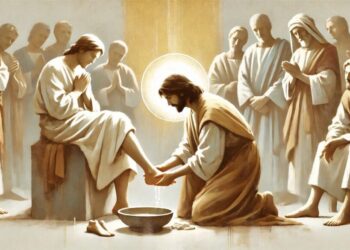الجيش يحتفل بعيد الوطن
د. الياس ميشال الشويري
يُعدّ سؤال “ماذا لو بقي الانتداب الفرنسي للبنان؟“ واحدًا من أكثر الأسئلة إرباكًا في الوعي الوطني اللبناني، لأنه يضرب في صميم المسلّمات التي تربّى عليها اللبنانيون حول معنى الاستقلال والحرية والسيادة. فالتجربة التاريخية منذ عام 1943، ولا سيّما منذ التسعينيات، تكشف بلا مواربة أن ما سُمّي “استقلالًا” لم يكن سوى شعار جميل يُغطّي حقيقة مرّة: فرصة تاريخية أضاعتها الطبقة السياسية الفاسدة، فتحوّلت الجمهورية الناشئة إلى ساحة مفتوحة للنهب وتقاسم النفوذ، بدل أن تكون مشروعًا لبناء دولة حديثة.
ومع مرور العقود، انحدر لبنان من حلم الدولة إلى واقع الانهيار، بينما كان يدفع ثمن صراعات عبثية حصدت مئات الآلاف من الشهداء بلا جدوى. وإذا كان الاستقلال يُفترض أن يكون بوابة نحو دولة عادلة وقوية، فقد سار لبنان في الاتجاه المعاكس تمامًا: إذ حملت المنظومة الحاكمة منذ التسعينات معها عقلية الميليشيا إلى مؤسسات الدولة، واستكملت مسارها بشراهة غير مسبوقة، فيما ظلّ الشعب، منذ الحرب الأهلية وحتى اليوم، يتحمّل أوزار الحروب والحصارات والانهيارات المالية والاجتماعية التي مزّقت حياته وأفقدته ثقته بوطنه وبالمصارف التي نهبت جنى عمره.
هذا المقال لا يُجري مقارنة سطحية بين “انتداب” و”استقلال“، بل يسعى إلى تحليل المسار التاريخي والسياسي والاجتماعي الذي قاد لبنان من حلم الدولة الحديثة إلى كارثة الانهيار الشامل. وسنركّز على ما حدث منذ التسعينيات، وهي المرحلة التي شهدت التفريغ المنظّم للدولة، وهيمنة أمراء الحرب، والمحاصصة الطائفية، وتضخّم الفساد، وإضعاف رئاسة الجمهورية، وانحلال القضاء، واستباحة السيادة، وصولًا إلى انهيار 2019 وما بعده.
1. الاستقلال النظري والاستقلال المفقود
لم يكن الاستقلال اللبناني في 1943 نهايةً لمرحلة وبداية لأخرى، بل تحوّل مع الوقت إلى مجرد شعار تُستخدم رمزيته لتغطية العجز والفساد. فمنذ البداية، وُلد النظام مسكونًا بالتوازنات الطائفية التي أُلبست لباس “الميثاق الوطني“، لكنها سرعان ما ظهرت كقنبلة موقوتة داخل بنية الدولة. ومع غياب رؤية وطنية جامعة، ظلّ الاستقلال هشًا، قائمًا على توزيع النفوذ بدل بناء المؤسسات. ومع ذلك، برزت مرحلتان استثنائيتان في تاريخ الجمهورية: فترة الرئيس الملك كميل نمر شمعون وفترة الرئيس الزاهد فؤاد شهاب، حيث بدا بوضوح أن الدولة يمكن أن تكون فاعلة حين تتوفر قيادة جدية ورؤية وطنية. في عهد الرئيس شمعون، وُضعت أسس سياسة خارجية واضحة وبداية مشروع دولة مركزية قوية، وفي عهد الرئيس شهاب، شهد لبنان مرحلة إصلاح إداري ومؤسساتي نادرة، تجلّت في تعزيز أجهزة الرقابة، وقيام نهضة اجتماعية وخدماتية شاملة، وتطوير البنى التحتية ومنهجية الدولة الراعية. هاتان المرحلتان كانتا البرهان الوحيد على أن الدولة ليست مستحيلة في لبنان، بل مُمكنة إذا تحررت من القبضة الطائفية.

لكن باستثناء هذين العهدين، بقيت الدولة هشّة، والإدارة رخوة، والمجتمع مكشوفًا أمام الرياح الداخلية والخارجية. ومع تراجع حضور الدولة الراعية، عاش اللبنانيون في ظل اقتصاد غير مستقّر، وتعليم غير موحّد، وبنية تحتية ضعيفة، ما جعل البلاد عرضة لتراكم التوترات التي انفجرت لاحقًا في الحرب الأهلية. غير أنّ لحظة صعود الرئيس الحي بشير الجميّل شكّلت استثناءً لافتًا في هذه المسيرة المتعثّرة؛ فقد بدا، ولو لوهلة قصيرة، أنّ مشروع الدولة القوية القادرة على فرض سيادتها وبناء مؤسساتها قد وُلد من جديد. كان بشير يحمل وعدًا باستعادة هيبة الدولة، وتوحيد القرار، وكسر منطق الميليشيات ودويلات الأمر الواقع، ما أعاد الأمل للبنانيين بإمكانية قيام دولة حقيقية تشبه طموحاتهم. إلا أنّ اغتياله أعاد عجلة التاريخ إلى الوراء، فعاد لبنان إلى مساره التقليدي: استقلالٌ بلا أدوات قوة، وسيادةٌ بلا حماية، وكيانٌ بلا مشروع نهضوي قادر على الصمود أمام الأزمات.
يطرح البعض سؤالًا مؤلمًا: هل كانت بعض مراحل الانتداب، رغم قسوتها، أكثر استقرارًا من مراحل “الاستقلال”؟ ليس الهدف تمجيد الانتداب، بل إبراز حجم الفشل الذي ارتكبته الطبقة السياسية في تحويل الاستقلال إلى مشروع دولة. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأنّ لبنان بعد الاستقلال لم يكن صفحة سوداء بالكامل؛ فقد برزت محطات مشرقة أكدت أن بناء الدولة كان ممكنًا لو استمرّ النهج المؤسساتي. ففي عهد الرئيس كميل شمعون، شهد لبنان بداية تثبيت بنية الدولة الحديثة، وانفتاحًا اقتصاديًا ورؤية مركزية لدور لبنان الإقليمي. ثم جاء عهد الرئيس فؤاد شهاب ليشكّل اللحظة الأكثر جدّية في تأسيس دولة المؤسسات، حيث تأسست الإدارات الحديثة، وتم ضبط الأمن، ووُضعت قواعد الإدارة الرشيدة، وأُعيد الاعتبار لمفهوم الدولة الراعية والمنظمة. ولاحقًا، في مطلع الثمانينات، حمل الرئيس بشير الجميّل وعدًا جديدًا للبنان، إذ أعاد الأمل بإقامة دولة قوية موحّدة تمتلك قرارها وتفرض سيادتها. ظهر بشير كامتداد طبيعي للمشروع الشهابي القائم على الدولة مقابل الزعامة، والوطن مقابل الطائفة، لكنه اغتيل قبل أن يكتمل مشروعه، واغتيلت معه الدولة.
غير أنّ ما عدا هذه المحطات المضيئة، ظلّت غالبية العهود تعيد إنتاج دولة محاصصة مشوّهة. فبينما كان الانتداب — رغم ظلمِه — يبني الطرق، وينظّم الدوائر، ويرسم الحدود، قامت الطبقة السياسية بعد التسعينات بتفريغ الدولة من معناها، وتحويل مؤسساتها إلى مزارع خاصة. وإذا كان الانتداب قد قيّد سيادة لبنان، فإن الطبقة السياسية الفاسدة منذ التسعينات قيّدت وجود الدولة نفسها، حتى بات السؤال مشروعًا: ماذا لو استمرت تلك العهود الإصلاحية؟ ماذا لو لم تُغتل فرص قيام الدولة؟ وهل كان لبنان سيوفّر على نفسه الانهيارات المتلاحقة التي لا تزال تفتك بشعبه حتى اليوم؟

2. الحرب الأهلية — المأساة التي كشفت هشاشة الاستقلال
اندلعت الحرب الأهلية عام 1975 بسبب تراكم طويل من الأزمات السياسية والاجتماعية والطائفية، لكنها كشفت أكثر من أي لحظة أخرى أن لبنان لم يكن يمتلك دولة حقيقية قادرة على منع الانفجار. ومنذ اللحظة الأولى، ظهر أنّ القوة الحقيقية ليست بيد المؤسسات الشرعية، بل بيد الميليشيات التي نافست الدولة في الشرعية، والسياسيين الذين تخلّوا عن منطق الوطن لصالح منطق القوة. وفي ظل انهيار الدولة، أصبحت بيروت ساحة مفتوحة لكل القوى الإقليمية والدولية، وتحوّل الشعب اللبناني إلى وقود لصراعات لا علاقة له بها. وهكذا دفعت البلاد ثمن “الاستقلال” الذي لم يبن مؤسسات قادرة على حماية نفسها من الانهيار.
لم تكن الحرب مجرد حرب، بل كانت عملية إعادة تشكيل عميقة للطبقة السياسية. فقد صعد أمراء الحرب إلى الواجهة، وأصبحوا لاحقًا زعماء الدولة نفسها، ما جعل لبنان ينتقل من حرب ميليشيات إلى سلطة ميليشياوية بلباس شرعي. وبعد انتهاء الحرب، لم تجرِ أي عملية محاسبة أو مصالحة حقيقية، بل جرت عملية “إعادة تدوير” للقيادات الفاسدة نفسها داخل مؤسسات الدولة. وهكذا تحوّل الاستقلال إلى مسرح للميليشيات بدل أن يكون مشروعًا لبناء دولة قوية.
لو كان لبنان يمتلك مؤسسات دولة صلبة قبل الحرب — قضاءً مستقلًا، جيشًا موحدًا، إدارة غير طائفية — لكان قادرًا على امتصاص الأزمات ومنع الانفجار. لكن ما حدث هو العكس تمامًا: ضعف الدولة جعل الحرب ممكنة، والحرب جعلت الدولة أضعف، إلى أن تحوّل لبنان إلى مجرد كيان يعيش على أنفاس الآخرين. وبسبب غياب المحاسبة، تراكمت الأخطاء، وتمددت الزعامات، وبدأت مرحلة جديدة من “الاستقلال المزيف” الذي استمر إلى يومنا هذا.
3. مرحلة التسعينيات — ربيع الفساد وشتاء الدولة
بعد انتهاء الحرب، جاء اتفاق الطائف ليعيد توزيع السلطات، لكن بدل أن يمهّد الطريق لبناء دولة حديثة، فتح الباب أمام انهيار جديد. فالصلاحيات التي كانت موزعة سابقًا باتت أكثر تشظيًا، وبدل أن تُعزّز المؤسسات، تم تكريس المحاصصة الطائفية بشكل أوسع. ومع دخول النفوذ السوري إلى قلب الحياة السياسية، تحولت الدولة اللبنانية إلى مسرح خاضع لمنطق الوصاية، حيث تُعيّن الحكومات، وتُنتخب المجالس، وتُدار الإدارات وفقًا لمصالح الأجهزة لا مصالح الشعب.
منذ التسعينيات، اختار لبنان نموذجًا اقتصاديًا قائمًا على الاستدانة، والريعية، والمصارف، والبناء، بدل الإنتاج والصناعة والتكنولوجيا. ومع سياسة الفوائد المرتفعة، تحوّل لبنان إلى دولة تستدين لتعيش، وتستدين لتسدد ديونها، وتستدين لتُغطي فسادها. ولم تكن هذه السياسة وليدة الصدفة، بل كانت نتيجة مباشرة لتحالف السلطة السياسية والمال والنفوذ الخارجي. ومع تنامي هذا التحالف، أصبح الفساد ليس مجرد ظاهرة، بل أسلوب حكم، وعمودًا فقريًا للنظام.
في التسعينيات، بدأت الدولة تفقد تدريجيًا قدرتها على ضبط الحدود، والتهريب، والأمن، والاقتصاد، والتعليم، والصحة. ومع تراجع القضاء، غابت المحاسبة، وتضخم الهدر. ومع توسع المحاصصة، أصبح لكل حزب وزارة، ولكل زعيم مؤسسة، ولكل جهة جهاز. وبهذا، بدأ الانهيار الفعلي للدولة. لم يكن الانهيار وليد 2019، بل كان نتيجة مسار طويل بدأ منذ التسعينيات حين رُسخت دولة المزرعة.
4. ما جناه اللبنانيون من “الاستقلال” بعد التسعينات
اعتقد اللبنانيون أنهم دخلوا مرحلة “استقلال جديد“، لكن الواقع أن البلاد دخلت مرحلة أسوأ: احتلال غير مباشر تحكمه منظومة السلاح والفساد، وتبادل الأدوار بين الأحزاب التي واصلت نهب الدولة وكأنّ شيئًا لم يتغير. ومع غياب سيادة القرار الوطني، أصبح لبنان يعيش على إيقاع الصراعات الإقليمية، والسجالات الداخلية، والفراغات الطويلة. ولم يتمكن أي رئيس جمهورية أو حكومة من ممارسة الحد الأدنى من السيادة، لأنّ القرار كان مرتهنًا إلى مراكز نفوذ أقوى من الدولة نفسها.
من القضاء إلى الجامعة اللبنانية، ومن الجيش إلى الوزارات، ومن المؤسسات الرقابية إلى الشركات العامة، جرى تدمير كل ما يشبه الدولة. لم يعد هناك مشروع وطني، بل مشاريع حزبية متصارعة. ومع كل تعطيل، كان الشعب يخسر مزيدًا من الأمل، وكانت الدولة تدخل مرحلة جديدة من التفكك. وهكذا تحوّل الاستقلال من حلم إلى لعنة، ومن مشروع إلى سراب.
تحوّل لبنان إلى ساحة نفوذ للمحاور، بلا دولة قادرة على حماية نفسها. ومع دخول الأزمة السورية، واشتداد التوترات الإقليمية، أصبح لبنان رهينة التحالفات، وبدأت المؤسسات تتآكل أكثر. ومع الوقت، أصبحت الدولة تعمل فقط لإدارة الفراغ، لا لصناعة المستقبل. وهكذا فقد اللبنانيون كل ما تبقى من مقومات السيادة.
5. الانهيار الشامل — حصيلة الاستقلال المنهوب
بدأ الانهيار المالي رسميًا في 2019، لكنه كان حصيلة 30 عامًا من النهب الممنهج، والهدر، والسياسات الخاطئة. ومع إفلاس المصارف، واحتجاز الودائع، وغياب أي خطة إنقاذ، دفع الشعب اللبناني ثمن “استقلاله” على شكل أفدح خسارة مالية في تاريخ المنطقة. وتحولت الطبقة السياسية الفاسدة بامتياز إلى حامي رئيسي للمصارف، بدل أن تكون حاميًا للشعب. وهكذا تكشّف الجانب الأكثر قسوة من الاستقلال المنهوب.
مع تراجع الخدمات الصحية، وانهيار المؤسسات التعليمية، وارتفاع نسبة البطالة، ودخول الليرة في دوامة الانهيار، أصبح اللبنانيون يعيشون أسوأ أزمة في تاريخهم. هاجر أكثر من 400 ألف شاب، وانهارت الطبقة الوسطى، وتضاعفت معدلات الفقر. ولم يكن في الدولة من يتحرك لإنقاذ الشعب، لأنّ مؤسسات الدولة كانت نفسها جزءًا من منظومة الفساد التي صنعت الانهيار.
لم يكن انهيار لبنان ماليًا فقط، بل كان أيضًا انهيارًا أخلاقيًا. انتشرت العقلية الميليشيوية في المجتمع، وتفككت القيم العامة، وانهارت صورة الدولة كمؤسسة جامعة. وبدأ اللبنانيون يبحثون عن خلاص فردي بدل الخلاص الوطني. وبهذا، دخل لبنان مرحلة أخطر من كل المراحل السابقة: مرحلة زوال الدولة من الوعي قبل أن تزول من الواقع.

6. تقليص صلاحيات رئاسة الجمهورية ومسار تفريغ الدولة
أدى اتفاق الطائف إلى تقليص صلاحيات رئاسة الجمهورية بشكل كبير، ما جعل الرئيس يفقد دوره كضامن للاستقرار السياسي والمؤسساتي. ومع نقل السلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء، أصبح الرئيس مجرد موقع بروتوكولي عاجز عن فرض أي رؤية وطنية، ولم يعد يملك القدرة على تعيين الحكومات أو حلّها أو ضبط الصراعات، ما فتح الباب أمام انقلاب المحاصصة على الدولة.
منذ التسعينيات، جرى تفريغ موقع الرئاسة عبر الوصاية السورية، ثم عبر سلطة الأحزاب بعد 2005. لم يعد الرئيس قادرًا على فرض هيبة الدولة، ولا حماية المؤسسات، ولا الوقوف بوجه الفساد. ومع الفراغات الرئاسية المتكررة، أصبحت الرئاسة رهينة الصفقات، وبات غيابها وسيلة لتعطيل الدولة. وهكذا تحولت الرئاسة من صمام أمان إلى نقطة ضعف مكشوفة.
مع غياب رئيس قادر على توحيد الدولة، تمددت القوى الخارجة عن المؤسسات، وضعفت سلطة القضاء، وانهار النظام المالـي، وتفككت الإدارات، وازدادت القطيعة بين الشعب والسلطة. إنّ تقليص صلاحيات الرئاسة كان أحد المفاصل الأساسية لانهيار لبنان، لأنه حرم الدولة من رأس يُمارس دور الحكم والضابط والضامن.
7. الخاتمة
لم يكن استقلال لبنان مجرّد حدث تاريخي، بل كان لحظة مفصلية كان يفترض أن تُطلق مشروع بناء دولة مدنية حديثة. لكنّ الطبقة السياسية اللبنانية حوّلت الاستقلال إلى فرصة للنهب، والمحاصصة، والسيطرة على مؤسسات الدولة. ومنذ التسعينيات تحديدًا، دخل لبنان مرحلة “تفكيك الدولة” عبر الفساد، وتضخّم النفوذ الخارجي، وتراجع صلاحيات الرئاسة، وانهيار القضاء، وتفريغ المؤسسات من دورها. وهكذا عاش لبنان أسوأ فترة في تاريخه الحديث، دفع خلاله فاتورة الدم والتهجير والانهيار المالي والاجتماعي. اليوم، وبعد كل هذا الخراب، يصبح السؤال مشروعًا:
– هل كان الاستقلال نعمة أم نقمة؟
– هل كان اللبنانيون سيعيشون حياة أكرم لو بقي الانتداب؟
– وهل يكون الخلاص اليوم باستعادة الدولة المخطوفة، أم بإعادة تعريف معنى الاستقلال نفسه؟
السؤال مفتوح… لكن الحقيقة المؤكدة هي أن لبنان، كما حكمه الفاسدون منذ التسعينيات، لم يجْنِ من استقلاله سوى البؤس واليأس والدمار.